|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
تفسير سورة الإنسان نزلت هذه السورة على القول الراجح عند العلماء في العهد المكي قبل الهجرة، فإنها فيها وعد ووعيد ككل السور المكية، وفيها تثبيت وتصبير للنبي -صلى الله عليه وسلمَ- إذا هو مستضعف يلاقي الأذى يحتاج إلى من يصبره. فالسورة آياتها وألفاظها وأسلوبها كالقرآن الذي نزل في مكة قبل الهجرة، ولكن يرى البعض أنها مدنية كلها إلا قول الله – تعالى"فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا"الإنسان: 24؛ لأن الآثم والكفور كان في مكة ولم يكن في المدينة، وكان الكفار يعرضون على الرسول -صلى الله عليه وسلمَ- بعض العروض لكي يترك هذا الدين، وهذا الكلام الذي يقوله، وليأخذ من الدنيا ما أراد: سُلْطَة، مالا، جاها.. وهكذا.. فالله -تعالى- قال"وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا" وقيل مدنية خاصة لورود كلمة "أسيرًا" فلم يكن عند المسلمين أسيرًا يطعمونه إلا في المدينة بعد الهجرة حين كان الجهاد، لكن لم يكن عندهم أسرى في مكة، فلم يواجهوا عدوًا، ولم يخوضوا حربًا، ولم يأسِرُوا أحدًا، لذا قال البعض: إنها مدنية، لكن الراجح عند العلماء: إنها مكية، ولا مانع من ذكر إطعام الأسير فكان بين القبائل في حروبهم أسرى، وهناك مغتصبون. فضائل السورة وخصائصها: أنَّه يُستحَبُّ القِراءةُ بها في صلاةِ الصُّبحِ يومَ الجُمُعةِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ: " أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الفَجْرِ يَومَ الجُمُعَةِ "الم تَنْزِيلُ"السَّجْدَةِ، وَ"هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ" ، وَأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ."الراوي : عبدالله بن عباس -صحيح مسلم. الشرح:كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم يَحرِصونَ حِرْصًا شَديدًا على اتِّباعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وكانوا يَقِفونَ على دَقائِقِ سُنَّتِهِ الشَّريفةِ؛ ماذا كان يَقرَأُ في كُلِّ صَلاةٍ؟ وهلْ كان يُطيلُ أو يُقْصِرُ؟ وهكذا. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يُواظِبُ على قِراءةِ سُورةِ السَّجدةِ في الرَّكعةِ الأُولى مِن صَلاةِ الفَجرِ كُلَّ يومِ جُمُعَةٍ، وأمَّا في الرَّكعةِ الثَّانيةِ فكان يَقرأُ سُورةَ الإنسانِ"هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ"؛ ولعلَّ ذلِك لِمَا اشتمَلَتْ عليه هاتانِ السُّورتانِ مِن ذِكرِ ما كان وما يَكونُ مِن المَبدأِ والمَعادِ؛ كخَلْقِ آدَمَ عليه السَّلامُ، وحَشْرِ الخَلائقِ وبَعْثِهم مِن القُبورِ إلى الجَنَّةِ والنَّارِ، وأحوالِ يَومِ القيامةِ، وأنَّها تقَعُ يَومَ الجُمُعةِ.الدرر السنية. مِن أهَمِّ مقاصِدِ السُّورةِ: تعريف جنس الإنسان بنفسهِ ببدايته ونهايته ، وانقِسامِهم لمؤمنٍ وكافرٍ، ومآلِهم يومَ القيامةِ. وهي من سور المفصل التي فضل الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء: " أُعطِيتُ مكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ ، وأُعطِيتُ مكانَ الزَّبورِ المئين ، وأُعطِيتُ مكانَ الإنجيلِ المثانيَ ، وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ ."الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة - المحدث : الألباني - المصدر بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم - الصفحة أو الرقم : 59 خلاصة حكم المحدث : صحيح- التخريج : أخرجه أحمد (16982)، والطبراني. الشرح:القُرآنُ الكريمُ هو كَلامُ اللهِ عزَّ وجلَّ، وهو أفضَلُ الكَلامِ وأعظَمُه، وفي قِراءتِهِ وتِلاوتِهِ أجْرٌ كبيرٌ، وقد خُصَّت بالفَضلِ بعضُ السُّوَرِ والآياتِ الَّتي يَكونُ لِقارئِها فَضْلٌ عظيمٌ في الأجْرِ والثَّوابِ، كما في هذا الحَديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أُعْطيتُ مَكانَ التَّوْراةِ" بمَعْنى أعْطاني اللهُ بَدَلًا من التَّوْراةِ وما فيها "السَّبْعَ الطِّوالَ" والتَّوْراةُ هي كِتابُ اللهِ الذي أنزَلَهُ على مُوسى عليه السَّلامُ، والسَّبعُ الطِّوالُ المُرادُ هُنا سَبعُ سُوَرٍ طِوالٍ كبارٍ مِن البَقَرةِ إلى التَّوبةِ، وقيلَ: المُرادُ: البَقَرةُ، وآلُ عِمرانَ، والنِّساءُ، والمائدةُ، والأنْعامُ، والأعْرافُ، ويُونُسُ، وقيلَ: المُرادُ: البقرةُ، وآلُ عِمرانَ، والنِّساءُ، والمائدةُ، والأنْعامُ، والأعْرافُ، والأنْفالُ مع بَراءةَ سورةٌ واحدةٌ، وقد بُيِّنَ فيهِنَّ الأمْثالُ، والخَبَرُ، والعِبَرُ، والفَرائِضُ، والحُدودُ، والقَصَصُ، والأحْكامُ، "وأُعْطيتُ مَكانَ الزَّبورِ المِئينَ"، والزَّبورُ هو كِتابُ اللهِ الَّذي أنزَلَهُ على نَبيِّهِ داودَ عليه السَّلامُ - بَدَلًا من الزَّبورِ وما فيها، ويُقصَدُ بالمِئينَ السُّوَرُ الَّتي عَدَدُ آياتِها أكثَرَ من المِئةِ، وقيلَ: أوَّلُها ما يَلي الكَهْفَ لِزَيادةِ كُلٍّ منها على مِئةِ آيةٍ أو التي فيها القَصَصُ أو غَيرُ ذلِكَ، "وأُعْطيتُ مَكانَ الإنْجيلِ المَثانيَ"، والإنْجيلُ هو كِتابُ اللهِ الَّذي أنزَلَهُ على نَبيِّهِ عيسى عليه السَّلامُ - بَدَلًا من الإنْجيلِ وما فيها، وقيلَ: المَثاني هي السُّوَرُ الَّتي آياتُها مِئةٌ أو أقَلُّ، أو ما عدا السَّبْعَ الطِّوالَ إلى المُفصَّلِ، وسُمِّيَتْ مَثانيَ؛ لأنَّها أثْنَتِ السَّبْعَ، أو لِكَونِها قَصُرَتْ عنِ المِئينَ وزادتْ على المُفصَّلِ، أو لأنَّ المِئينَ جُعِلت مَبادِئَ، والَّتي تَليها مَثاني ثُمَّ المُفصَّلُ، وقيلَ غَيرُ ذلِكَ، وقيلَ: المثاني هي سُورةُ الفاتِحةِ، وسُمِّيَت بذلِكَ؛ لأنَّها سَبعُ آياتٍ، وتُثنَّى في الصَّلاةِ، وتُكرَّرُ قِراءتُها في كُلِّ ركعةٍ، وقيلَ: لأنَّها استُثنِيَت لهذه الأُمَّةِ فلم تَنزِلْ على أحَدٍ قَبلَها ذُخرًا لها، "وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ" بمَعْنى زادني اللهُ من فَضلِهِ بأنْ أعْطاني وأنزَلَ عليَّ سُوَرَ المُفصَّلِ، وهي السُّوَرُ القَصيرةُ من القُرآنِ، وقيلَ: إنَّ مَبدَأَها من الحُجُراتِ إلى آخِرِ القُرآنِ، وقيلَ غَيرُ ذلِكَ . الدرر السنية. وفي الحديث أن القرآن نسخ الكتب السابقة ، واشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب السابقة. المُفَصَّلَ هو المُحْكَمُ: عن سعيد بن جبير قال: إنَّ الذي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ هو المُحْكَمُ، قَالَ: وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: تُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا ابنُ عَشْرِ سِنِينَ، وقدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ."الراوي : عبدالله بن عباس-صحيح البخاري. الشرح:كان عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عند وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صغيرًا في السِّنِّ، إلَّا أنَّه كان من كِبارِ الصَّحابةِ في العِلمِ والفَهمِ، لا سِيَّما في إتقانِ القُرآنِ الكريمِ وفَهمِ مَعانيه. وفي هذا الحديثِ يخاطِبُ التابعيُّ سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ بعضَ تلامِذَتِه قائلًا لهم"إنَّ الَّذي تَدعونَهُ المُفَصَّلَ" من سُوَرِ القُرآنِ الكريمِ "هو المُحكَمُ". ومعنى المُحكَمِ، أي: الَّذي لم يُنسَخْ وكان واضِحًا في لَفْظِه ومعناه. والمُفصَّلُ هو السُّوَرُ التي كَثُر الفَصلُ بينها، وهو مِن سُورةِ "ق" إلى آخِرِ القُرآنِ، وقيل: مِن سُورةِ الحُجُراتِ إلى آخِرِ القُرآنِ، وقيل: من سُورةِ محمَّدٍ. ثمَّ أخبَرَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توُفِّيَ، وهو ابنُ عَشْرِ سِنينَ، وَقَد قَرَأَ المُحْكَمَ. يعني: المفصَّلَ. والقراءةُ هنا بمعنى الحِفظِ، ويحتَمِلُ أن يكونَ قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما"وأنا ابنُ عَشرِ سِنين"راجِعًا إلى وَقتِ حِفظِ المفَصَّلِ مِنَ القُرآنِ، لا إلى عُمُرِه وقتَ وَفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقد كان عُمُرُه عند وفاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ عَشْرةَ سَنةً، وقيل: خمسَ عَشرةَ سَنةً. وعليه يكونُ تقديرُ كَلامِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: توفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد جمعتُ المُحكَمَ وأنا ابنُ عَشرِ سِنينَ. ويُؤخَذُ منه أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما لَم يَكُنْ يَحفَظُ جَميعَ القُرآنِ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وَإنَّما حَفِظَهُ بعْدَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي الحَديثِ: تَعليمُ الصِّبيانِ القُرآنَ.الدرر السنية. سورة الإنسان أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بأسلوب الاستفهام ،فهذه السورة بدأت بسؤال: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ...... " عدد السور التي افتتحت بالاستفهام ستة : الإنسان ، النبأ، الغاشية، الشرح ، الفيل، الماعون. ومن مقاصدها البارزة: تذكير الإنسان بنعم الله-تبارك وتعالى- عليه، حيث خلقه- سبحانه - من نطفة أمشاج، وجعله سميعًا بصيرًا، وهداه السبيل. وحيث أعد له ما أعد من النعيم الدائم العظيم.. متى أطاعه واتقاه. كما أن من مقاصدها: إنذار الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم. وإثبات أن هذا القرآن من عند الله-تبارك وتعالى- وأَمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالصبر والإكثار من ذكر الله-تبارك وتعالى- بكرة وأصيلا. وبيان أن حكمته -تبارك وتعالى- قد اقتضت أنه: يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ بعلمه المطلق ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذابًا أَلِيمًا، جزاءًا وفاقًا. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
" هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا "1. هَلْ :الاستفهام هنا للتحقيق ، اتفق المفسرون على أن " هل " هنا بمعنى قد ، أي : أن الاستفهام تقريري يستوجب الإجابة عليه بنعم . الْإِنسَانِ : قيل : هو الإنسان الأول آدم - عليه السلام - ، أتى عليه حين من الدهر ، لم يكن شيئًا يذكر. وقيل : هو عموم الإنسان من بني آدم. فالمراد بالإنسان: جنسه، فيشمل جميع بني آدم- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي..التفسير الوسيط. حِينٌ: الحينُ المقدار المجمل من الزمان، لا حد لأكثره ولا لأقله. الدَّهْرِ: الدَّهْرُ اسمٌ للزَّمانِ الطَّويلِ غير المحدد بوقت معين. افتُتِحَتْ هذه السُّورةَ الكريمةَ بِالاستفْهَامِ الذِي يفيدُ التحقيقَ والإخبارَ بأنَّه قد مَرَّ على الإنسانِ قبْلَ أن يُخلَقَ زَمَنٌ طَويلٌ لم يكُنْ فيه شَيئًا مَذكورًا.أي لم يكن موجودًا حتى يُعرف ويُذكر. فكل إنسان منا مَرَّ عليه وقتٌ طويلٌ من الدهر كان عدمًا، لم يكن له – وجود ولا - ذِكرٌ في تلك المدة الطويلة، فخلقه الله من العدم ليعبده.د. محمد بن علي بن جميل المطري. "إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا "2. الْإِنسَانَ : ولفظ الإنسان الثاني في قوله تعالى : إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ، اتفقوا على أنه عام في بني آدم ؛ لأنه هو الذي خُلِقَ من نطفةٍ أمشاج أخلاط ، وقد رجح الفخر الرازي أن لفظ الإنسان في الموضعين بمعنى واحد ، وهو المعنى العام ؛ ليستقيم الأسلوب بدون مغايرة بين اللفظين إذ لا قرينة مميزة .أضواء البيان. فَصَّلَ- سبحانه - أطوار خلق الإنسان فقال "إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ: النطفة هي الماء القليل، والمراد بها هنا: مني الرجل، فإن هذه النطفة تشتمل على حيوانات منوية كثيرة جدًا، أي خلقه سبحانه من نطفة خرجت من أبيه ليس لها قيمة "أَمْشَاجٍ: أي: أَخلاطٍ فلما اختلطت النطفة بماء الأم صارت بداية تكوين إنسان جديد. قال الجمل"أَمْشَاجٍ" نعت لنطفة.والمعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان.تفسير الوسيط. " أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا: ومن ثم جعله سميعًا بصيرًا . أي زوده بوسائل الإدراك ، ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار . ويجتاز الابتلاء وفق ما يختار . وفي ذلك بيانُ عظيمُ قدرةِ اللهِ جل وعلا. نَّبْتَلِيهِ : أي: نَختَبِرُه ونَمتَحِنُه، والبلاءُ يكونُ في الخَيرِ والشَّرِّ فهذا الإنسانَ لم يُخلق عبثًا ولا جزافًا، بل خَلقَهُ ليبتليَه ويمتحنَه بالتكاليفِ الشرعيةِ التي يأمرُه بها، حتى يعلمَ الصَّادقَ في إيمانِهِ من الكاذِبِ. فأنشأه الله، وخلق له القوى الباطنة والظاهرة، كالسمع والبصر، وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. " إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا "3. ثم أرشده الطرق بأن أرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وهداه الطريق الموصلة إلى الله ، ورغبه فيها، وأخبره بما له عند الوصول إلى الله. ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك، ورهبه منها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه، قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور لنعمة الله عليه، أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية، فردها، وكفر بربه، وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.تفسير السعدي. وعُبر عنِ الهدى بالشكرِ ، لأن الشكرَ أقربُ خاطرٍ يَرِدُ على قلبِ المهتدِي بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئًا مذكورًا ، فأراد ربُّه له أن يكونَ شيئًا مذكورًا . ولَمَّا كان الشُّكرُ قَلَّ مَن يتَّصِفُ به، قال: شَاكِرًا، فعبَّرَ عنه باسمِ الفاعلِ؛ للدَّلالةِ على قِلَّتِه، ولَمَّا كان الكفْرُ كثيرًا مَن يَتَّصِفُ به، ويَكثُرُ وُقوعُه مِن الإنسانِ، قال: كَفُورًا؛ فعبَّرَ عنه بصِيغةِ المُبالَغةِ . أو: أنَّه عَبَّرَ باسمِ الفاعِلِ الخالي مِن المُبالَغةِ في "شَاكِرًا " ؛ لأنَّه لا يَقدِرُ أحدٌ أن يَشكُرَ جميعَ النِّعَمِ، فلا يُسَمَّى شَكورًا إلَّا بتفَضُّلٍ مِن رَبِّه عليه، ولَمَّا كان الإنسانُ لِما له مِن النُّقْصانِ لا يَنفَكُّ غالِبًا عن كُفْرٍ ما، أتى بصيغةِ المُبالَغةِ؛ تنبيهًا له على ذلك ، وإشعارًا بأنَّ الإنسانَ لا يَخْلو عن كُفرانٍ غالبًا، وإنَّما المُؤاخَذُ به التَّوغُّلُ فيه، أو لم يقُلْ"كافرًا" ليُطابِقَ قَسيمَه؛ مُحافَظةً على الفواصلِ.موسوعة التفسير الدرر السنية. "أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أكْثَرُ أهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ قيلَ: أيَكْفُرْنَ باللَّهِ؟ قالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ، لو أحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شيئًا، قالَتْ: ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ."الراوي : عبدالله بن عباس – صحيح البخاري. والحديثُ يدُلُّ على أنَّ الكفرَ كُفرانِ - كُفرٌ لا يُخرِجُ عنِ الملَّةِ وكفرٌ مخرجٌ مِنَ المِلةِ - ، وأنَّ لَفظِ الكُفرِ قد يُطلَقُ على غيرِ الكُفرِ باللهِ تعالَى، كأنْ يُرادَ كُفرُ النِّعمةِ، أي: إنكارُها.الدرر السنية. الكفر الأصغر:يعني أنَّه على دَرَجةٍ مِن دَرَجاتِ الكُفرِ، ولكنْ ليس هو الكُفرَ الأكبرَ المُخرِجَ مِنَ المِلَّةِ الذي يكونُ صاحِبُه في حُكمِ المُرتَدِّ..ومخلد في النار. الكُفْرُ الأصْغَرُ غيرُ مُخْرِج من المِلَّةِ، ولا يُناقِضُ أصلَ الإيمانِ، بل يَنقُصُه ويُضعِفُه، ولا يَسلُبُ صاحِبَه صِفةَ الإسلامِ وحَصانتَه. وهو المشهورُ عند العُلَماءِ بقَولِهم: كُفرٌ دونَ كُفرٍ. وقد أطلقه الشَّارعُ على بَعْضِ المعاصي والذُّنوبِ على سبيلِ الزَّجرِ والتَّهديدِ؛ لأنَّها من خِصالِ الكُفْرِ، وهي لا تَصِلُ إلى حَدِّ الكُفْرِ الأكبَرِ، وإنَّما هي مِن كبائِرِ الذُّنوبِ، وهو مُقتَضٍ لاستحقاقِ الوَعيدِ والعذابِ دون الخُلودِ في النَّارِ. وصاحِبُ هذا الكُفْرِ مِمَّن تنالُهم شفاعةُ الشَّافعينَ بإذنِ اللهِ تعالى.الموسوعة العقدية -الدرر السنية. ثم يأخذ في عَرْضِ ما ينتظر الإنسانَ بعدَ الابتلاءِ ، واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران : "إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا"4.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
"إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا"4. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ :أي إنا هيأنا لمن كفروا بنعمتنا وخالفوا أمرنا. سَلَاسِلَوَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا: إنَّا هَيَّأْنا للكافِرينَ سَلَاسِلَ يُقادُونَ بهاإلى الجحيم، كما قال تعالى" ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ"الحاقة: 32. ،وَأَغْلَالًا: بها تشد أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها ؛نحو قوله تعالى " إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ"غافر:71. ، وَسَعِيرًا : أي: نارًا تستعر أي تشتعل بشدة بأجساد المسلسلين المغلولين الذين أُلقوا فيها فتحرق أبدانهم، " كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ " النساء:56.وهذا العذاب دائم لهم أبدًا، مخلدون فيه سرمدًا. "ما بيْنَ مَنْكِبَيِ الكافِرِ في النَّارِ، مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، لِلرَّاكِبِ المُسْرِعِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الوَكِيعِيُّ: في النَّارِ. "الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. "ضِرْسُ الكافِرِ -أوْ نابُ الكافِرِ- مِثْلُ أُحُدٍ، وغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاثٍ "الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. وفي هذا الحَديثِ يخبِرُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَسافةَ ما بيْن مَنكِبَيِ الكافرِ -والمَنكِبُ: مُجتمَعُ العَضُدِ والكتِفِ- تكونُ يومَ القيامةِ مسيرةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ للرَّاكبِ المُسرِع، فعَظُم خَلقُه؛ ليَعظُمَ عَذابُه، ويُضاعَفَ أَلَمُه، وعند مُسلمٍ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"ضِرْسُ الكافِرِ -أو نابُ الكافِرِ- مِثلُ أُحُدٍ، وغِلَظُ جِلْدِه مَسيرة ثلاثٍ"، وكلُّ هذا يَدُلُّ على عِظَمِ خَلْقِ أهلِ النَّارِ يومَ القيامةِ؛ وذلك حتَّى يتَحمَّلوا شِدَّةَ عَذابِ النَّارِ، فهَيئتُهم الَّتي كانوا عليها في الدُّنيا لا تَقْوى على تَحمُّلِ العَذابِ، فبَدَّل اللهُ خَلْقَهم حتَّى يُذيقَهم العَذابَ الأليمَ.الدرر السنية. "إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا" 5. "عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا" 6. هذه الآية وما يأتي بعدها شُروعٌ في بيانِ حُسنِ حالِ الشَّاكرينَ، إثرَ بَيانِ سُوءِ حالِ الكافرينَ ، فلَمَّا أوجز اللهُ تعالى في جزاءِ الكافِرِ؛ أتْبَعَه جزاءَ الشَّاكِرِ وأطنَبَ فيه؛ للتأكيد وللتَّرغيبِ. إِنَّ الْأَبْرَارَ: وهم الذين برت قلوبهم – فاضت بالامتثال والإحسان- بما فيها من محبة الله ومعرفته، والأخلاق الجميلة، فبرت جوارحهم ، واستعملوها بأعمال البر. والْبَرُّ هو الإنسانُ المطيعُ لله-تبارك وتعالى- طاعة تامة، والمسارع في فعل الخير، والشاكر لله-تبارك وتعالى- على نعمه. قال في الصحاح: جمع البر الأبرار، وجمع البارّ البررة، والأبرار هم أهل الطاعة والإخلاص والصدق وقال قتادة: هم الذين يؤدون حق الله. والبرفي لغة العرب معناه: السعة والتوسع، ومنه البَر الذي هو خلاف البَحر، ومنه اشتق البِرُّ وهو التوسع في فعل الخير، ومن معنى الكلمة في اللغة واشتقاقها نفهم معناها في سياق الآيات المذكورة. البِرُّ اصطِلاحًا: قال الرَّازيُّ: البِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطَّاعاتِ وأعمالِ الخيرِ المُقَرِّبةِ إلى اللهِ تعالى.الدرر السنية/موسوعة الأخلاق والسلوك .والبِرُّ يُطلَقُ باعتبارينِ: أحَدُهما: باعتبارِ مُعاملةِ الخَلقِ بالإحسانِ إليهم، وربَّما خُصَّ بالإحسانِ إلى الوالِدَينِ، فيُقالُ: بِرُّ الوالِدَينِ، ويُطلَقُ كثيرًا على الإحسانِ إلى الخَلقِ عُمومًا. والمعنى الثَّاني من معنى البِرِّ: أن يُرادَ به فِعلُ جميعِ الطَّاعاتِ الظَّاهِرةِ والباطنةِ، كقَولِه تعالى" وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "البقرة: 177 . فالبِرُّ بهذا المعنى يدخُلُ فيه جميعُ الطَّاعاتِ الباطنةِ، كالإيمانِ باللهِ وملائكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه؛ والطَّاعاتِ الظَّاهِرةِ، كإنفاقِ الأموالِ فيما يحِبُّه اللهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والوفاءِ بالعَهدِ، والصَّبرِ على الأقدارِ، كالمَرَضِ والفَقرِ، وعلى الطَّاعاتِ، كالصَّبرِ عندَ لِقاءِ العَدُوِّ فائدة: معنى بر الوالدين أي طاعة الله فيما أمر بحقهما والإحسان إليهما. كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قدْ ظُلِّلَ عليه، فَقالَ: ما هذا؟ فَقالوا: صَائِمٌ، فَقالَ: ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ. "الراوي : جابر بن عبدالله - صحيح البخاري. يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان في سَفَرٍ، فرَأى قومًا مُجتمِعينَ حَولَ رجُلٍ قدْ جُعِلَ عليه شَيءٌ يُظلِّلُه مِن الشَّمسِ؛ لِما حَصَل له مِن شِدَّةِ العطَشِ والتَّعَبِ، فسَأَلَهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا أصاب صاحبَكم؟ فبَيَّنوا أنَّ سَببَ ضَعْفِه كان لصَومِه ولم يَأخُذْ برُخصةِ الإفطارِ في السَّفرِ، فأخْبَرَهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه"ليسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ" أي:ليس مِن حُسنِ الطَّاعةِ والعِبادةِ الصَّومُ في السَّفرِ إذا بلَغَ بالصَّائمِ هذا المَبلَغَ مِن المَشقَّةِ، واللهُ قد رخَّص للصَّائمِ بالفِطْرِ، سواءٌ كان الصِّيامُ فَرْضًا أو تَطوُّعًا، وقد جاءتِ الرُّخصةُ بفِطرِ المسافرِ في قَولِ اللهِ تعالَى"وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"البقرة: 185 ، ويَتأكَّدُ الفطرُ إذا كان المسافرُ في حَجٍّ أو جِهادٍ؛ لِيَقْوى عليه. وقد وَرَدَ مَشروعيَّةُ الصِّيامِ للمُسافرِ إذا قَوِيَ عليه،كما في الصَّحيحَينِ عن أبي الدَّرداءِ رَضيَ اللهُ عنه قال"خرَجْنا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعضِ أسفارِه في يومٍ حارٍّ، حتى يَضَعَ الرَّجلُ يَدَه على رَأسِه مِن شِدَّةِ الحَرِّ، وما فِينا صائمٌ إلَّا ما كان مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وابنِ رَواحةَ" الصحيحين. يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا: أي: إنَّ الطَّائِعينَ الصَّادِقينَ الَّذين يَسعَونَ في أعمالِ البِرِّ والخَيرِ يَشرَبونَ مِن كأسٍ مُمتَزِجٍ شَرابُها بالكافورِ. والكأس في اللغة الإناء فيه الشراب. وذكر- سبحانه - هذه الأشياء في هذه السورة- من الكافور- والزنجبيل، وغيرهما، لتحريض العقلاء على الظفر في الآخرة بهذه المتع التي كانوا يشتهونها في الدنيا، على سبيل تقريب الأمور لهم، وإلا فنعيم الآخرة لا يقاس في لذته ودوامه بالنسبة لنعيم الدنيا الفاني. قال ابن عباس:كل ما ذكر في القرآن مما في الجنة وسماه، ليس له من الدنيا شبيه إلا في الاسم. فالكافور، والزنجبيل، والأشجار والقصور، والمأكول والمشروب، والملبوس والثمار، لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم. "عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ: أي: أن الأبرار يشربون من كأس، ماؤها ينبع من عين في الجنة، هذا الماء له بياض الكافور ورائحته وبرودته. عِبَادُ اللَّهِ :مراد بهم : الأبرار . وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف . يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا: صفة أخرى للعين، أي: يتصرَّفُ عِبادُ اللهِ في عَينِ الشَّرابِ بإنباعِها وإجرائِها حيث شاؤُوا، أي: يسيرونها ويجرونها إلى حيث يريدون، وينتفعون بها كما يشاءون، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يتجهون إليه. فالتعبير بقوله: يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا إشارة إلى كثرتها وسعتها وسهولة حصولهم عليها. ثم ذكر ما لأجله استحقوا هذه الكرامة فقال:
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
ثم ذكر ما لأجله استحقوا هذه الكرامة فقال: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "7 "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا "8. بيَّنَ- سبحانه – في هذه الآية وفي آيات متعددة، الأسباب التي من أجلها وصلوا إلى النعيم الدائم. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ: والنذر: هو إيجاب المكلف على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا عليه، سواء كان منجّزًا أو معلقًا. *النذر المنجز أو المطلق:كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلاً دون اشتراط. "أنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، قالَ: فأوْفِ بنَذْرِكَ."الراوي : عبدالله بن عمر - صحيح البخاري. " أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ."الراوي : عبدالله بن عباس - صحيح البخاري. ومثل نذر امرأة عمران " "إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" آل عمران: 35. وفي الكلام دلالة على أنها كانت تعتقد أن ما في بطنها ذكر لا إناث حيث إنها تناجى ربها عن جزم وقطع من غير اشتراط وتعليق حيث تقول نذرت لك ما في بطني محررًا من غير أن تقول مثلا إن كان ذكرًا ونحو ذلك. *النذر المعلق: كأن يقول: علي لله صيام ثلاثة أيام إن شفاني من مرضي، أو لله علي أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا.وهذا النوع مكروه. "نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وقَالَ: إنَّه لا يَرُدُّ شيئًا، ولَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ به مِنَالبَخِيلِ. "الراوي : عبد الله بن عمر - صحيح البخاري. "لا يَأْتي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بشيءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ له، ولَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إلى القَدَرِ قدْ قُدِّرَ له، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ به مِنَ البَخِيلِ، فيُؤْتي عليه ما لَمْ يَكُنْ يُؤْتي عليه مِن قَبْلُ. "الراوي : أبو هريرة - صحيح البخاري. شرح الحديث: النَّذْرُ هو إيجابُ المرْءِ فِعلَ أمْرٍ على نَفْسِه لم يُلزِمْه به الشَّارعُ، كأنْ يقولَ الإنسانُ: علَيَّ ذَبيحةٌ، أو أتَصدَّقُ بكذا إنْ شَفَى اللهُ مَريضي؛ فهو في صُورةِ الشَّرطِ على اللهِ عزَّ وجلَّ. هذا الحديثُ من الأَحَادِيثِ القُدسيَّةِ كما ورد في روايةٍ أُخرى للبُخاريِّ، وَلكنَّه لَمْ يُصرَّحْ بنِسْبَتِه إِلَى اللهِ تعالَى هنا، وفيه يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ النَّذْرَ لا يَأتي لابنِ آدَمَ بشَيْءٍ لم يَكُنْ قد قَدَّره اللهُ له، "ولكنْ يُلقِيه النَّذرُ إلى القَدَرِ قدْ قُدِّرَ له"، معناه: أنَّ النَّذرَ لا يَصنَعُ شَيئًا، وإنما يُلقيه إلى القَدَرِ؛ فإن كان قد قُدِّر وقع، وإلَّا فلا؛ فالنَّذرُ لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يُؤخِّرُه، بلِ الخَيرُ والشَّرُّ يَجْري وَفْقَ مَقاديرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فالمَقدورُ لا يَتغيَّرُ مِن شَرٍّ إلى خَيرٍ بسَبَبِ النَّذرِ. وأخبر أنَّ اللهَ سُبحانَه يَستخرِجُ بالنَّذرِ الخَيرَ مِن البَخيلِ والشَّحِيحِ؛ فهو أشبَهُ بإلْزامِ البَخيلِ بإخراجِ شَيءٍ لم يكُنْ يُريدُ أنْ يُخرِجَه من تِلْقاءِ نَفْسِه؛ فالمعنى: أطِيعوا اللهَ ابتِداءً وطَواعِيةً، ولا تَطْلُبوا للطَّاعةِ مُقابِلًا، فعادةُ النَّاسِ تَعليقُ النُّذورِ على حُصولِ المَنافِعِ ودَفْعِ المَضارِّ؛ فإنَّ ذلك فِعلُ البَخيلِ؛ إذِ لا يأتي بهذه القُربةِ تَطوُّعًا ابتداءً، بل في مُقابَلةٍ؛ بنَحوِ شِفاءِ مَريضٍ ممَّا علَّقَ النَّذرَ عليه، وأمَّا السَّخيُّ الكريمُ فإذا أرادَ أنْ يَتقرَّبَ إلى اللهِ تعالَى، استَعجَلَ فيه وأتَى به في الحالِ، فشَأنُ الكَريمِ أنْ يُبادِرَ بالعَطاءِ، وأنْ يُسابِقَ إلى فِعلِ الخَيرِ؛ طلبًا لِمَرضاةِ اللهِ، والبَخيلُ لا تُطاوِعُه نَفْسُه بإخْراجِ شَيءٍ مِن يَدِه إلَّا في مُقابَلةِ عِوَضٍ يُستوْفى أوَّلًا! فإذا نذر وتحقَّق ما أراد، يعطي هذا البَخيلُ للهِ على ذلك الأمرِ الذي بِسَبَبِه نَذَرَ -كالشِّفاء- ما لم يكُنْ يُعطيه ويخرِجُه لله مِن قَبْلِ النَّذْرِ. وفي الحَديثِ: إشارَةٌ إلى ذَمِّ النَّذرِ المُعلَّقِ.الدرر السنية. وكلا النوعين يجب الوفاء به إذا كان المنذور فعل طاعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ " صحيح البخاري. " كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ . "الراوي : عقبة بن عامر - صحيح مسلم. قال ابن عباس" من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُه كفارةُيمينٍ"الراوي : عبد الله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : إرواء الغليل- موقوف على ابن عباس. وقدْ ذُكِرتْ كفَّارةُ اليَمينِ على التَّرتيبِ في قولِه تَعالى"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"المائدة: 89. يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، ومن أوفى بما أوجبه على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله عليه أولى. وجيء بصيغة المضارع في قوله: يُوفُونَ للدلالة على تجدد وفائهم في كل وقت وحين. والتعريف في النذر " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ " للجنس، لأنه يعم كل نذر. ويستعاض عن النذر المكروه عند رجاء ذهاب هم وبلاء أو استجلاب خير يستعاض عنه بالتوسل بالأعمال الصالحة. " سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ حتَّى أوَوُا المَبِيتَ إلى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّتْ عليهمُ الغَارَ، فَقالوا:إنَّه لا يُنْجِيكُمْ مِن هذِه الصَّخْرَةِ إلَّا أنْ تَدْعُوا اللَّهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ،فَقالَ رَجُلٌ منهمْ: اللَّهُمَّكانَ لي أبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُما أهْلًا ولَا مَالًا، فَنَأَى بي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عليهما حتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لهما غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ وكَرِهْتُ أنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُما أهْلًا أوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ والقَدَحُ علَى يَدَيَّ، أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فيه مِن هذِه الصَّخْرَةِ. فَانْفَرَجَتْ شيئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ. قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لي بنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أحَبَّ النَّاسِ إلَيَّ، فأرَدْتُهَا عن نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حتَّى ألَمَّتْ بهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فأعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ ومِئَةَ دِينَارٍ علَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وبيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قالَتْ: لا أُحِلُّ لكَ أنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلَّا بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ، وتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذي أعْطَيْتُهَا،اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غيرَ أنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ منها. قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وقالَ الثَّالِثُ:اللَّهُمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فأعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيرَ رَجُلٍ واحِدٍ تَرَكَ الَّذي له وذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حتَّى كَثُرَتْ منه الأمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ، أدِّ إلَيَّ أجْرِي، فَقُلتُ له: كُلُّ ما تَرَى مِن أجْرِكَ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ والرَّقِيقِ، فَقالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ، لا تَسْتَهْزِئُ بي! فَقُلتُ: إنِّي لا أسْتَهْزِئُ بكَ، فأخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ منه شيئًا،اللَّهُمَّ فإنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ." الراوي : عبدالله بن عمر - صحيح البخاري. الدُّعاءُ والتَّقرُّبُ إلى اللهِ تعالَى بصالِحِ الأعمالِ والإخلاصِ سَبَبٌ لتَفْريجِ كُلِّ كَرْبٍ. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا: أي: ويَخافُونَ يومَ القيامةِ الَّذي شرُّه في غايةِ الانتِشارِ والامتِدادِ، فخافوا أن ينالهم شره، فتركوا كل سبب موجب لذلك. وجاء لفظ اليوم " يَوْمًا" منكرًا، ووصف بأن له شرًا مستطيرًا.. لتهويل أمره، وتعظيم شأنه، حتى يستعد الناس لاستقباله بالإيمان والعمل الصالح. وذكر فعل كَانَ للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه وإلا فإن شر ذلك اليوم ليس واقعًا في الماضي وإنما يقع بعد مستقبل بعيد ، ويجوز أن يجعل ذلك من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهًا على تحقق وقوعه. شَرُّهُ : والشر : العذاب والجزاء السوء. مُسْتَطِيرًا :والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصر ، والسين والتاء في استطار للمبالغة وأصله طار مثل استكبر . والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده تشبيهًا له بانتشار الطير في الجو ، ومنه قولهم : الفجر المستطير وهو الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه في الأفق ويقال : استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق . ثم وصفهم- سبحانه - بصفات أخرى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِحُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا : أي: ويُطْعِمونَ الطَّعامَ الذي هو قوامُ الأبدانِ - مع محَبَّتِهم إيَّاه، واشتِهائِهم له، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم.- فيُؤْثِرونَ به المِسكينَ، وهو المحتاج إلى غيره لفقره وسكونه عن الحركة..واليتيم: وهو الصَّغيرَ الَّذي فَقَدَ أباه، والأسير: وهو من أصبح أمره بيد غيره. "مُوجِبُ الجنةِ؛ إطعامُ الطعامِ، وإفشاءُ السلامِ، وحُسنُ الكلامِ." خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : هانئ بن يزيد بن نهيك أبو شريح - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب "يا أَيُّها الناسُ ! أَفْشُوا السلامَ ، و أطْعِمُوا الطعامَ، وصِلُوا الأرحامَ، وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيَامٌ، تَدْخُلوا الجنةَ بسَلامٍ"خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : عبدالله بن سلام - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع. "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"9. إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ: يَقولُ الأبرارُ بيان لشدة إخلاصهم، ولطهارة نفوسهم ، يقدمون الطعام لهؤلاء المحتاجين مع حبهم لهذا الطعام، ومع حاجتهم إليه.. ثم يقولون لهم بلسان الحال أو المقال: إنما نطعمكم ابتغاء وجه الله-تبارك وتعالى- وطلبًا لمثوبته ورحمته. النية هي روح العمل وأساسه، والعمل تابع يُبنى عليها، وبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة.وعلى العامل أن ينوي الإخلاص . والإخلاص هو: تصفية العمل من كل شائبة، بحيث لا يمازج هذا العملَ شيءٌ من الشوائب في والإرادات، وأعنى بذلك إرادات النفس، إما بطلب التزين في قلوب الخلق، وإما بطلب مدحهم، والهرب من ذمهم، أو بطلب تعظيمهم، أو بطلب أموالهم، أو خدمتهم، أو محبتهم، أو أن يقضوا له حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات السيئة التي تجتمع على شيء واحد، وهو: إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل. وعليه: فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد، أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيء مع الله -تبارك وتعالى. لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا: أي: لا نريد منكم جزاء على ما قدمناه لكم، ولا نريد منكم شكرًا ولا ثناءً على ما فعلناه، فإننا لا نلتمس ذلك إلا من الله-تبارك وتعالى- خالقنا وخالقكم. والمراد بالجزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة ، وبالشكور ذكرهم بالمزية ،والثناء عليهم. أي: لا جزاءً ماليًّا ماديًّا ولا ثناءً قوليًّا. يقولون ذلك لهم تأنيسًا لهم ودفعًا لانكسار النفس الحاصل عند الإطعام ، أي ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر الله ، فالمطعِم لهم هو الله . فالقول قول باللسان ، وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم . وعن مجاهد أنه قال : ما تكلموا به ولكن علمه الله فأثنى به عليهم .
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
"إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا" 10.. إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا: معنى الخوف من الله تعالى هو: استشعار عظمته والوقوف بين يديه، وأنه يعلم سر العبد وجهره،فإذا علم المؤمن أن الأنفاس تُعَد عليه، وأن الحفظة الكاتبين يراقبون أعماله،"مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" ق: 18. وأنه حيثما حلَّ مُتابع، وأن طريق الهروب من الله مسدود، ولا حيلة له إلا الاستسلام والانقياد والإقبال على طاعة الله، والاستفادة من المهلة الممنوحة له، إذ لا يدري متى يتخطفه الموت، ويصير إلى ما قدم. "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"لقمان:34. "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ" آل عمران: 185. إذا عَلِمَ كلَّ ذلك تولَّد عنده خوف الله وعاش معنى الخوف، وكان من الخاشعين الموقنين، الذين لا يرى الشك إلى قلوبهم سبيلاً، ولا تنتهي عزائمُهم ولا تفتر قواهُم، ولا تكسل جوارحُهم؛ لأن تفكيرَهُم مُنصبٌ على كَسبِ الخير، وجمع ما يمكن من أسباب العبور إلى دار الكرامة، وهم منشغلون بأهوال موقف الحساب وعرض الأعمال، وترقب نتائج أعمالهم في الدنيا، فهم فيها غرباء يمشون بأجسادهم وأنظارهم مقبلة على الآخرة، لا يستكثرون أعمال البر، ولا يحتقرون المعاصي؛ لأنهم لا يأمنون مكر الله تعالى، قال عز من قائل: فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ "الأعراف:99. جعلنا الله وإياك من الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه.. آمين .مقتبس من إسلام ويب.. عَبَسَ الْيَوْمُ: اِشْتَدَّ . - يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ :- : شَدِيدٌ وَعَسِيرٌ. أي: ويقول الأبرار عند تقديم الطعام لهؤلاء : إنا نخاف من ربنا يومًا، تعبس فيه الوجوه، من شدة هوله، وعظم أمره، وطول بلائه. وقيل وصف اليوم بهذا الوصف - عَبُوسًا - على سبيل المجاز في الإسناد، والمقصود وصف أهله بذلك.عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَتعَوَّذُ مِن ضِيقِ المقامِ يومَ القيامةِ:فعن عاصم بن حميد قال: سألتُ عائشةَ ماذا كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يفتتحُ بِهِ قيامَ اللَّيلِ قالت لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنْهُ أحدٌ قبلَكَ كانَ يُكبِّرُ عشرًا ويحمدُ عشرًا ويسبِّحُ عشرًا ويستغفرُ عشرًا ويقولُ اللَّهمَّ اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوَّذُ من ضيقِ المقامِ يومَ القيامةِ"خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه - " ويتعوَّذُ من ضيقِ المقامِ يومَ القيامةِ"، أي: الأهوالِ الَّتي تحدُثُ فيه. "فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا" 11.. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ : أي: فدَفَع اللهُ عن الأبرارِ شرَّ يَومِ القيامةِ ، والفاء في قوله: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ.. للتفريع على ما تقدم ولبيان ما ترتب على إخلاصهم وسخائهم من ثواب. أي: فترتب على وفائهم بالنذور، وعلى خوفهم من عذاب الله-تبارك وتعالى- وعلى سخائهم وإخلاصهم، ترتب على كل ذلك أن دفع الله-تبارك وتعالى- عنهم شر ذلك اليوم أي: آمنهم مما خافوا منه يوم القيامة. ففي يوم القيامة من المشاهد، والمواقف، والأهوال ما هو كاف لفزع، وخوف أي شخص، حتى لو كان قد بُشر من قبل بالنجاة، حيث يتغير نظام الكون بشكل لم يألفه الإنسان، فتدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، وتبدل الأرض غير الأرض، وتطوَى السماوات كطي السجل للكتب، ويؤتى بالنار ولها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، الى غير ذلك من المشاهد المفزعة، وقد أشار سبحانه إلى شدة الهول في ذلك اليوم فقال: "يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ"الحج:2. قال القرطبي رحمه الله : المعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة، إلا أنه يخففه عن المطيعين وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا، والله أعلم. انتهى. وبنحو هذا أجاب الرازي وأبو حيان وابن عادل في تفاسيرهم، وللألوسي جواب آخر يعتمد على التفريق بين خوف المكروهوخوف الجلال، حيث يقول: قال بعض الكبراء: خوف المكروه منفي عنهم مطلقًا، وأما خوف الجلال ففي غاية الكمال... وذكر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أو عندهم إلى لا خوف عليهم للإشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم.انتهى. وَلَقَّاهُمْ: أي: أكرمهم وأعطاهم ، نَضْرَةً : حُسْنًا وبهاءً ونورًا في وُجوهِهم ، وَسُرُورًا: وبهجة وفَرَحًا في قُلوبِهم. فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن ، وذلك أن القلب إذا سُرَّ استنار الوجه. "وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا "12. وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا :وجزاهم بما صبروا على طاعة الله، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها. أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله ، والصبر على اجتناب محارم الله ، والصبر على أقدار الله، والأقدار إما أن تكون مؤلمة، وإما أن تكون ملائمة، وفي الصبر على القدر المؤلم الخير الكثير. جَنَّةً وَحَرِيرًا: جزاهم لصبرهم هذا منزلًا رحبًا ، وعيشًا رغدًا جامع لكل نعيم، سالم من كل مُكدر ومُنَغص، ولباسًا حسنًا،ففي الآخرة يلبسون الحرير؛ لأنهم لم يلبسوه في الدنيا لتحريم الله لها. لم يلبسوا الحرير في الدنيا فلبسوه في الآخرة؛ لأنهم التزموا حدود الله، والتزموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم"مَن لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِ. "الراوي : أنس بن مالك - صحيح البخاري. قال ابن أبي ليلى أنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وضَعَ القَدَحَ في يَدِهِ رَمَاهُ به، وقالَ: لَوْلَا أنِّي نَهَيْتُهُ غيرَ مَرَّةٍ ولَا مَرَّتَيْنِ -كَأنَّهُ يقولُ: لَمْ أفْعَلْ هذا- ولَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ولَا الدِّيبَاجَ، ولَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّهَا لهمْ في الدُّنْيَا، ولَنَا في الآخِرَةِ."الراوي : حذيفة بن اليمان - صحيح البخاري. شرح الحديث: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ولَا الدِّيبَاجَ: وهو نوعٌ مِنَ الحريرِ من أفضَلِه وأنفَسِه، وذلك التحريمُ خاصٌّ بالرِّجالِ إن كان لَبِسَه مِن غيرِ عُذرٍ، " ولَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ "،" ولَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا" جمعُ صَحفةٍ، وهي الآنيةُ الكبيرةُ التي تُوضَعُ فيها الأطعِمةُ، وعلَّل ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّها للكُفَّارِ في الدُّنيا، -وليس معناه أنها مباحةٌ لهم، ولكنَّهم يجترؤون على مخالفةِ أمرِ اللهِ فيها لكُفْرِهم- وللمسلِمين في الآخرةِ مُكافأةً على تَرْكِها في الدُّنيا، ويُمْنَعُها أولئك جَزاءً لهم على مَعصِيَتِهم باستعمالِها. وفي الحَديثِ: تَكرارُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ. وفيه: الشِّدَّةُ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ لِمن يُباحُ له ذلك من ولاةِ الأُمورِ ونَحوِهم. وفيه: فضيلةُ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه بشِدَّتِه في الحَقِّ، والتزامِه أمْرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونَهْيَه. الدرر السنية. "مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا"13. مُّتَّكِئِينَ:الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة. الْأَرَائِكِ: والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين. وَلَا زَمْهَرِيرًا : والمُرادُ بالزَّمهريرِ شِدَّةُ البرْدِ. لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى طعامَهم ولِباسَهم؛ وصَفَ مَساكِنَهم، وأيضًا لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى أنَّه كفاهم المَخُوفَ، وحَبَاهم الجنَّةَ؛ أتْبَعَه حالَهم فيها وحالَها، فقال دالًّا على راحتِهم الدَّائِمةِ، ومفصِّلًا نعيمَ أهلِ الجنَّةِ: مُتَّكِئينَ في راحةٍ ورَفاهيَةٍ على السُّررِ المُغَطَّاةِ بقُبَّةٍ مِن الثِّيابِ الفاخِرةِ،لا يَرونَ في الجنَّةِ شَمْسًا والمراد بالشمس : حر أشعتها فيُؤذيَهم حَرُّها، ولا بَرْدًا شَديدًا ، بل جَوّ واحد معتدل دائم يناسب النعيم الذي هم فيه. "وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا" 14. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا : ومن نعيمَ أهلِ الجنَّةِ أيضًا ظلال أشجار الجنة قريبة منهم، ومحيطة بهم، زيادة في إكرامهم. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا : وسُهِّلَ لهم قَطْفُ ثمارِها تذليلًا، بحيث إن القاعد منهم والقائم والمضطجع، يستطيع أن يتناول هذه الثمار اللذيذة بدون جهد أو تعب. وبعد أن وصف جانبًا من طعامهم ولباسهم ومسكنهم - وصف شرابهم وأوانيه فقال: "وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا "15. ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيَّة، وأكواب الشراب من الزجاج، كَانَتْ: والمراد بالكينونة في قوله-تبارك وتعالى- كانَتْ قَوارِيرَا.. أنها تكونت ووجدت على هذه الصفة. قَوَارِيرَا: القوارير: جمع قارورة وهي في الأصل إناء رقيق من الزجاج النقي الشفاف، توضع فيه الأشربة وما يشبهها، فتستقر فيه.فالأكواب من الزجاج النقي الشفاف. "قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا"16 . أي: مادتها من فضة، وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء، أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير الزجاجية.والمراد تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها، ولون الفضة وبياضها. قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا : أي: قدرها السقاة من الخدم، الذين يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة، من دون زيادة ولا نقصان . لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تف بِرِيِّهِم. وقيل: قدرها الشاربون لها من أهل الجنة على مقدار حاجتهم، بمقدار يوافق لذاتهم، فأتتهم على ما قدَّرُوا في خواطرِهم.الوسيط. وتفسير السعدي. "وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا"17. ويُسْقَى هؤلاء الأبرار المُكَرَّمون كأسًا من خمر ممزوجة بالزنجبيل. وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته ; لأنه يحذو اللسان ، ويهضم المأكول ، فَرُغِّبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب . عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهُما قال : ليسَ في الجنَّةِ شيءٌ مِمَّا في الدُّنيا إلَّا الأسماءُ" خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب . وصف الله تعالى خمر الآخرة بما يخالف خمر الدنيا ، فقال : يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ" الصافات/45-47 . فوصف الله تعالى خمر الآخرة بأنها :بيضاء ، لذة للشاربين ، بخلاف خمر الدنيا ، فإنها كريهة عند الشرب .لَا فِيهَا غَوْلٌ :الغَولُ: وجَعُ البَطنِ، ليس فيها ضرر ما كخمر الدنيا. وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ: ولا بسببها يسكرون و تُنزع عقولهم، بخلاف خمر الدنيا التي تُذهب عقولَهم. وفي سورة الواقعة "لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا" أي : لا يصيبهم منها صُداع.انظر : "تفسير سورة الصافات" للشيخ ابن عثيمين :ص 107-109 . أي: لا تَذهَبُ عُقُولُهم، وذَلِكَ أنَّ المَقصُودَ مِنَ الخَمرِ إنَّما هو اللَّذَّةُ المُطْرِبةُ، وهي الحالةُ المُبهِجةُ الَّتي يَحصُلُ بها سُرُورُ النَّفسِ، وهذا حاصِلٌ كامِلٌ تامٌّ في خَمرِ الجَنَّةِ، فأمَّا ذَهابُ العَقلِ بحيثُ يَبقى شارِبُها كالحيَوانِ والمَجنُونِ، فهذا نَقصُ إنَّما يَنشَأُ عَن خَمْرِ الدُّنيا، فأمَّا خَمرُ الجَنَّةِ فلا تُحدِثُ لِشارِبها شيئًا مِن هذا، وإنَّما تُحدِثُ السُّرُورَ والِابتِهاجَ فهي من نعيمِ الجنةِ المبهج.
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
"عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا" 18. قيل :السلسبيل وصف مشتق من السلاسة بمعنى السهولة واللين، يقال: ماء سلسل، أي:عذب سائغ للشاربين، ومعنى تُسَمَّى على هذا القول أي: توصف بالسلاسة والعذوبة. وقيل: السلسبيل: اسم لهذه العين، لقوله-تبارك وتعالى- تُسَمَّى. أي: أن هؤلاء الأبرار- بجانب كل ما تقدم من نعم ؛ يسقون- أيضًا- من عين فيها- أي: في الجنة- تسمى سلسبيلا، وذلك لسلاسة مائها ولذته وعذوبته، وسهولة نزوله إلى الحلق. "وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا" 19.. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ :ويَطوفُ على الأبرارِ في الجنَّةِ بالشَّرابِ أو غَيرِه. والطواف : مشي مكرر حول شيء أو بين أشياء . وِلْدَانٌ : أولادٌ صِغارٌ على سنٍّ واحِدةٍ، فلا يَهرَمونَ ولا يموتونَ.، ويطلق الوليد على الصبي مجازًا مشهورًا بعلاقة ما كان ، لقصد تقريب عهده بالولادة ، وأحسن ما يُتخذ للخدمة الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشيًا ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم . مُّخَلَّدُونَ : دائمون على ما هم عليه من النضارة والشباب ، ووصفوا بأنهم مخلدون للاحتراس مما يوهمه اشتقاق ولدان من أنهم يَشُبُّون ويكتهلون ، أي لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دومًا وإلا فإن خلود الذوات في الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص . إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا: إذا رأيتَهم ظَنَنْتَهم -لحُسْنِهم وانتِشارِهم لخِدمةِ الأبرارِ- لُؤلؤًا مُفَرَّقًا. إذا رأيتَهم في انتِشارِهم لخِدمةِ الأبرارِ ، وكثرتهم ، وصباحة وجوههم ، وحسن ألوانهم وثيابهم وحُليهم ، حسبتهم لُؤلؤًا مُفَرَّقًا . ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. "وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا"20. ثَمَّ : ثم هنا ظرف مكان. مختص بالبعيد .معناه: أن بصرك أينما وقع في الجنة رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا عَظيمًا هنيئًا واسعًا -أهلَ الجَنَّةِ كلَّهم ملوكٌ فيها - وسُلطانًا باهِرًا أعَدَّه اللهُ تعالى للأبرارِ. وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول . " عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا"21. لفظةُ: عَالِيَهُمْ : تدل على كَونِ ذلك اللِّباسِ ظاهِرًا بارِزًا يُجَمِّلُ ظواهِرَهم، ليس بمَنزِلةِ الشِّعارِ الباطِنِ، بل الَّذي يُلبَسُ فوقَ الثِّيابِ للزِّينةِ والجَمالِ. قال الطبري في التفسير: والسندس: هو ما رق من الديباج، والإستبرق هو الديباج الغليظ. الدِّيباج هو نَسيج مِنَ الحرير الأَصيلِ، مُلَوَّنٌ أَلْوانًا مُخْتَلِفَةً وتصنع منه ثِياب ظاهرها وباطنها من الحرير. والمعنى: أن هؤلاء الأبرار، أصحاب النعيم المقيم، والمُلك الكبير، عليهم ثيابٌ مِن حريرٍ رقيقٍ ، ومِن فَوقِها ثيابٌ مِن حريرٍ غَليظٍ له بَريقٌ ولَمَعانٌ على سبيل التنعم والجمع بين محاسن الثياب. وكانت تلك الملابس من اللون الأخضر، لأنها أبهج للنفس، وشعار لباس الملوك. ثلاثة حُببت للناس : الماء والخضرة والوجه الحسن. فَرُغِّبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة. وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول مع اعتقاد "في الجنةِ ما لا عينٌ رأت ولا أُذُنٌ سمِعَت ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ."خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند. عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهُما قال : ليسَ في الجنَّةِ شيءٌ مِمَّا في الدُّنيا إلَّا الأسماءُ" خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب . وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ: والمعنى أن المؤمن يحلى في الجنة بالفضة. والأساور : جمع سوار وهو حُلي شكله أسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك. كان الملوك فى الزمان الأول يحلون بها ويسورون من يكرمونه. قال صلى الله عليه وسلم "تبلغُ الحِلْيةُ من المؤمِنِ حيث يبلُغُ الوضوءُ "خلاصة حكم المحدث : صحيح -الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم : 2911 -التخريج : أخرجه مسلم:250. "كُنْتُ خَلْفَ أبِي هُرَيْرَةَ وهو يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، فَكانَ يَمُدُّ يَدَهُ حتَّى تَبْلُغَ إبْطَهُ فَقُلتُ له: يا أبا هُرَيْرَةَ ما هذا الوُضُوءُ؟ فقالَ: يا بَنِي فَرُّوخَ أنتُمْ هاهُنا؟ لو عَلِمْتُ أنَّكُمْ هاهُنا ما تَوَضَّأْتُ هذا الوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ."الراوي : أبو هريرة - صحيح مسلم. يستفاد من الحديث: استحباب إتمام الوضوء، وإسباغه. ومما يتزين به المؤمنون يوم القيامة الحلي. تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ:أي تصلُ زينة المؤمن يوم القيامة إلى ما يصل إليه الماء الذي يتوضأ به، والوضوء يبلُغ إلى المرافق، وعلى هذا يكون الذراع كله مملوءًا بالحلية، نسأل اللّه تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يُحلَّون بهذا الحُلِيِّ. والمراد بالحلية:ما يُتزينُ به من الأساور، ونحوها، وقيل: النور. شرح الحديث: في هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ أبو حازمٍ الأشجعيُّ أنَّه كانَ واقِفًا خَلْفَ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه وهو يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ، فَكانَ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه يَغسِلُ يَدَيه وذِراعَيه إلى أن يَبلُغَ الإبطَينِ؛ مُبالَغةً ورَغبةً في غَسلِ أطوَلِ جُزءٍ مِنَ الذِّارعَينِ، فسألَه أبو حازمٍ عن سببِ هذا الوُضوءِ الذي لم يَعهَد أن يَرَى أحدًا يَتوضَّأُ مِثلَه، فقالَ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه"يا بَنِي فرُّوخَ، أنتُم هاهُنا؟" أي: حاضِرُونَ وتَرَوني، وبَنُو فرُّوخَ: هُمُ العَجَمُ، وقيلَ: إنَّ فرُّوخَ من وَلدِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وهُو أخو إسماعيلَ وإسحاقَ، ومِن ولدِه العَجَمُ، ثُمَّ أخبَرَ أنَّه لو يَعلَمُ أنَّ أحدًا يَراه ما تَوضَّأ هذا الوُضوءَ. وأرادَ أبو هُرَيرةَ بكَلامِه هذا أنَّه يَنبَغي لمَن يُقتدى به إذا تَرخَّصَ في أمرٍ أو تَشدَّدَ فيه مع نفسِه، أو لاعتقادِه في ذلك مَذهَبًا شَذَّ به عنِ النَّاسِ: ألَّا يَفعَلَه بحَضرةِ العامَّةِ؛ لئلَّا يَترخَّصوا برُخصتِه لغَيرِ ضَرورةٍ أو يَعتقِدُوا أنَّ ما تَشدَّدَ فيه هو الفرضُ. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: حلية المؤمن في الجنة، أبو هريرة فعل هذا ليُزاد له في الحلية، جاء في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فجعل يزيد حتى تكون الحليةُ تستمر، ولكن هذا لا يدل على شرعية الزيادة، يكون مبلغ الحلية مبلغ الوضوء إلى منتهى المرفقين، ما بعد المرفقين.ا.هـ. وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ولهذا أخفى وضوءه، وقال لما أُنكر عليه: لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء.كتاب شرح سنن النسائي – الراجحي. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا : أُسنِدَ سَقْيُ الشَّرابِ إلى ربِّهم؛ إظهارًا لكَرامتِهم، أي: أمَر هو بسَقْيِهم، كما يُقالُ: أطْعَمَهم رَبُّ الدَّارِ وسَقاهم . أو أُسنِدَ سَقْيُه إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه أُرِيدَ به نوعٌ آخَرُ يَفوقُ على النَّوعينِ المُتقدِّمَينِ. وجاء لفظ " طَهُورًا" بصيغة المبالغة، للإشعار بأن هذا الشراب قد بلغ النهاية في الطهارة. شَرَابًا طَهُورًا: طاهر مطهر .فالطاهر ليس بالضرورة مطهِّر فكثير من السوائل طاهرة لكنها ليست بالضرورة مطهِّرة. واستعمال طَهُور هنا مناسب لسياق الآيات وتشتمل المعاني كلها الطاهر والمطهر والمبالغة فيهما. عبارة طهور أنها لم ترد في القرآن إلا في موردين: أحدهما في مورد المطر "وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا "الفرقان 48 .الذي يطهر كل شئ ويحيي البلاد الميتة، والآخر في مورد الآية التي نحن بصدد بحثها، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا: وهو الشراب الخاص بأهل الجنة. ولم يذكر الكتاب ما يبين نوع ذلك الشراب، فلندع أمره إلى الله. "إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا"22 . ثم ختم- سبحانه - هذا العطاء الواسع العظيم، ببيان ما يُقالُ لهم، أو يقولُ لهم ربُّهم، عند تمتعهم بكل هذا النعيم، إِنَّ هذا النعيم الذي تعيشون فيه كانَ لَكُمْ جَزاءً على إيمانكم وعملكم الصالح في الدنيا. وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا:أي: مرضيًا ومقبولًا عند خالقكم، فازدادوا- أيها الأبرار- سرورًا على سروركم، وبهجة على بهجتكم. والإتيانُ بفِعلِ كَانَ في قولِه تعالى: وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ؛ للدَّلالةِ على تَحقيقِ كَونِه سَعْيًا مَشكورًا. وشكره للعبد قبول طاعته ، وثناؤه عليه ، وإثابته إياه. وبعد هذا التفصيل لما أعده الله-تبارك وتعالى- لعباده الأخيار من أصناف النعيم، المتعلق بمأكلهم، ومشربهم.. أخذت السورة الكريمة. في أواخرها- في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.فقال عز من قائل:
__________________
|
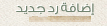 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
الساعة الآن 05:34 AM







 العرض المتطور
العرض المتطور
