|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الدرس الخامس من كتاب المختصر في النحو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الخامس من دروس النحو من كتاب : المختصر في النحو ‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على : أحوال البناء . قال المصنف عفا الله عنه : الفصل الثاني : أحوال البناء‹ وفيه خمس مسائل : المسألة الأولى : ما هي أحوال بناء الأسماء ؟ عرفنا قبل ذلك أن الأسماء : منها مبنيٌّ . ومنها معرب . وعرفنا أن أحوال البناء أربعة وهي : الفتح . والضم . والكسر . والسكون . وبناء الأسماء له أربعة أحوال : الحال الأولى : البناء على الفتح . ومن ذلك : كيفَ ، هُوَ ، الذينَ ، الآنَ . فهذه الكلمات كلها مبنية على الفتح . وعرفنا أن البناء هو : أن يلزم آخرَ الكلمة حالٌ واحدة . أما الحال الثانية فهي : البناء على الضم . ومن ذلك : تاء الفاعل ، تقول : أكلتُ ، شربتُ ، نمتُ ، صليتُ . فالتاء هنا مضمومة دائما . ومن ذلك أيضا : نحنُ ، حَيْثُ فكل هذه الكلمات مبنية على الضم دائما . وأما الحال الثالثة فهي : البناء على الكسر ومن ذلك : هؤلاءِ ، هذِهِ وأما الحال الرابعة فهي : البناء على السكون . ومن ذلك : همْ ، الذي ، مَنْ . فكل هذه الكلمات مبنية على السكون . ثم قال المسألة الثانية : ما هي أحوال بناء الفعل الماضي ؟ عرفنا قبل ذلك أن الفعل الماضي مبني دائما . قال : بناء الفعل الماضي له ثلاثة أحوال . الحال الأولى : يُبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء . يعني الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء . مثال ذلك تقول : جاءَ زيدٌ . هنا " جاءَ " فعل ماضي مبني على الفتح . تقول أيضا : ذهبَ عمروٌ . ذهب فعل ماضي مبني على الفتح . وذلك لعدم اتصالهما بشيء . و هذا هو الأصل بالفعل الماضي أن يبنى على الفتح . الحال الثانية : يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة . تقول : المسلمونَ اجتهدُوا . فهنا الفعل الماضي مبني على الضم . اجتهد آخرها ضم : اجتهدُوا . كذلك تقول : الطلابُ نجحُوا . هنا الفعل ( نجح ) مبني على الضم . وذلك لاتصالهما بواو الجماعة . و واو الجماعة هنا تعرب ضميرًا مبنيًا على السكون في محل رفع فاعل . أما الحال الثالثة لبناء الفعل الماضي فهي : البناء على السكون . وذلك إذا اتصلت به : التاء المتحركة أو نون النسوة أو نا الفاعلين . ومن الأمثلة على ذلك : تقول : حفظتُ القرآن . وتقول : حفظتَ القرآن . وتقول : حفظتِ القران . فهنا في هذه الأمثلة الثلاثة الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة . ومن الأمثلة أيضا : تقول : النساءُ حَفظْنَ القرآن . فهنا الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة . وتقول أيضا : حفظْنَا القرآن . فهنا الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله ب "نا" الفاعلين . وهذه الزيادات المتصلة وهي : التاء المتحركة . ونون النسوة . وناء الفاعلين . تعرب ضميرا مبنيا في محل رفع فاعل . إذن الفعل الماضي الأصل فيه أنه : يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء . ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة . ويبنى على السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة ، أو نون النسوة ، أو نا الفاعلين . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : ما هي أحوال بناء فعل الأمر ؟ عرفنا قبل ذلك أن فعل الأمر مبني دائمًا . قال : بناء فعل الأمر له أربعة أحوال : الحال الأولى : يُبنى على السكون إذا اتصلت به : نون النسوة . وإذا كان صحيحَ الآخر ولم يتصلْ به شيء . ومثال ذلك تقول : اقرأْنَ دروسَكُنَّ . فهنا فعل الأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة . وتقول أيضا : اِقرَأْ دروسَكَ . هنا فعل الأمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء . والصحيح الآخر هو ما لم ينتهِ بحرف علة . وحروف العلة ثلاثة وهي : الواو ، والألف ، والياء الكلمة التي تنتهي بحرف من هذه الحروف الثلاثة : الواو والألف والياء يسمى كلمة معتلة. أما إذا لم تنتهِ بحرف من هذه الحروف الثلاثة فتسمى : كلمة صحيحة . الحال الثاني : يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد . تقول : جَاهِدَنَّ في سبيل الله . فهنا فعل الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . كذلك تقول : حافظَنَّ على آداب النوم . هنا فعل الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . وهنا فائدة وهي : أن نون التوكيد نوعان : ثقيلة ، وخفيفة . أما الثقيلة فهي : المشددة . تقول : اُكتُبَنَّ . أما الخفيفة فهي : المخففة . تقول : اُكتُبَنْ . أما الحال الثالثة فهي : أن فعل الأمر يُبنى على حذف النون إذا اتصلت به : ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة تقول : تعامَلَا برفق . تعامَلُوا برفق . تعامَلِي برفق . فهنا الفعل في هذه الأمثلة الثلاثة مبني على حذف النون . وذلك لاتصاله : بألف الاثنين في المثال الأول . وبواو الجماعة في المثال الثاني . وياء المخاطبة في المثال الثالث . أما الحال الرابعة فهي : أن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر . مثال تقول مثلا : اُدْعُ ربك . صَلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم . فهنا فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة . وذلك لأنه معتل الآخر . صَلِّ : أصلها صَلِّي ، آخرها " ياء " . حذفت الياء لأنه فعل أمر . كذلك : اُدْعُ : أصلها اُدْعُو بالواو . حذفت الواو لأنه فعل أمر . كذلك تقول : تقول : تَحَرَّ الصدق . أصلها تحرى بالياء لكنها حذفت لأنه معتل الآخر . إذن فعل الأمر يبنى على السكون : إذا اتصلت به نون النسوة . وإذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء . و يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد . و يبنى على حذف النون إذا اتصلت به : ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر . يعني إذا كان آخره حرف علة . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الرابعة : ما هي أحوال بناء الفعل المضارع ؟ عرفنا قبل ذلك أن الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب ، و يبنى في حالين فقط وهما : إذا اتصلت به نون التوكيد . وإذا اتصلت به نون النسوة . تقول : لَنَحفَظَنَّ القرآن . و تقول : يَحفَظْنَ القرآن . فهنا الفعل المضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد كما في المثال الأول . و لاتصاله بنون النسوة كما في المثال الثاني . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الخامسة : ما هي أحوال بناء الحروف ؟ عرفنا قبل ذلك أن الحروف كلها مبنية ، وبناء الحروف له أربعة أحوال : الحال الأولى : البناء على الفتح ، ومن ذلك : لَعَلَّ ، ثم ، واو العطف الحال الثانية : البناء على الضم ، ومن ذلك : منذُ الحال الثالثة : البناء على الكسر ومن ذلك : لام الجر ، ولام التعليل . الحال الرابعة : البناء على السكون ومن ذلك : هلْ ، وقدْ . تقول : حرف مبني على : الفتح ، أو الضم ، أو الكسر ، أو السكون ســؤال الــدرس الســؤال الأول : اذكر أحوال بناء الكلمات الآتية ، وسبب بنائها إن وجد ؟ جاءَ . هؤلاءِ . كيفَ . جاؤُوا . جلستَ . جلستِ . جلستُ . اِشرَبْ . تَعلّمُوا . تَعَلّمْنَ . تَعَلّمَنَّ . يحفظن . يَحفَظنَ . عَلَى . أنَا . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#2
|
||||
|
||||
|
الـدرس السادس مـن كتــاب المختصــر في النحــو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . . وهـذا هـو الـدرس السادس مـن دروس النحــو مـن كتـاب المختـــصر في النحــو وفي هـذا الدرس نتعـرف إن شاء الله تعالى على : رفع ونصب الفعل المضارع . قال المصنف عفا الله عنه : الفصل الثالث : أحوال الإعراب ‹ وفيه مبحثان : المبحث الأول : أحوال إعراب الفعل المضارع . المبحث الثاني : أحوال إعراب الأسماء . قال : المبحث الأول : أحوال إعراب الفعل المضارع : وفيه ست مسائل : المسألة الأولى : ما هي أحوال إعراب الفعل المضارع ؟ عرفنا قبل ذلك أن الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب إلا في حالين وهما : إذا اتصلت به نون التوكيد . وإذا اتصلت به نون النسوة . قال : أحوال إعراب الفعل المضارع ثلاثة : الحال الأولى : الرفع إذا لم يُسبق بأداة من أدوات النصب أو الجزم . الحال الثانية : النصب إذا سُبق بأداة من أدوات النصب . الحال الثالثة : الجزم إذا سُبق بأداة من أدوات الجزم . يعني الفعل المضارع : يكون مرفوعا إذا لم يسبق بأداة من أدوات النصب أو الجزم . ويكون منصوبا إذا سبق بأداة من أدوات النصب . ويكون مجزوما إذا سبق بأداة من أدوات الجزم . ثم قال المسألة الثانية : بما يرفع الفعل المضارع ؟ يرفع الفعل المضارع بثلاث علامات : العلامة الأولى : الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر . يعني الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يُرفع بالضمة الظاهرة . تقول : يقومُ زيدٌ الليلَ . هنا الفعل : يقومُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . وذلك لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم ولأن الحرف الأخير صحيح غير معتل . تقول أيضا : يدرسُ عمروٌ الفقهَ . الفعل : يدرسُ : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . وذلك لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم ولأن الحرف الأخير فيه صحيح غير معتل . العلامة الثانية : الضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر . مثال تقول : يقضِي القاضِي بالحَقِّ . هنا الفعل المضارع " يقضِي" مرفوع بالضمة المقدرة ، منع من ظهورها الثقل . تقول أيضا : يدعُو المسلمُ ربَّهُ . يدعُو : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، منع من ظهورها الثقل . تقول أيضا : يرضَى المؤمنُ بقضاءِ ربِّهِ . يرضَى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر . العلامة الثالثة : ثبوت النون إذا اتصلت به : ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة . تقول : الطالِبَان يُشاركانِ في المسابقةِ . والطالبتَانِ تُشاركان في المسابقةِ . هنا الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بضمير التثنية . يُشاركان و تُشاركان وتقول : الطلابُ يُشاركون في المسابقة . وتقول : أنتم تُشاركون في المسابقة . هنا الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بضمير الجمع . وتقول أيضا : أنتِ تُشاركينَ في المسابقة . هنا الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة . وهذه الأفعال تسمى : بالأمثلة أو الأفعال الخمسة . تقول : يقومان ، تقومان ، يقومون ، تقومون ، تقومين . تقول : يحفظان ، تحفظان ، يحفظون ، تحفظون ، تحفظين . وتقول : يُصلّيان ، تُصلّيان ، يُصلّون ، تُصلّون ، تُصلّين . فكل هذه الأفعال تعرب فعلا مضارعا مرفوعا بثبوت النون ، لأنها من الأفعال الخمسة . والضمير وهو : ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة يعرب ضميرا مبنيا على السكون في محل رفع فاعل . إذن الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة ، أو الضمة المقدرة ، أو بثبوت النون . يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر . ويرفع بالضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر . ويرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال أو الأمثلة الخمسة . وهذا كله إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : بما ينصب الفعل المضارع ؟ ينصب الفعل المضارع بثلاث علامات : العلامة الأولى : الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالياء أو الواو . تقول : لن ينجحَ المهملُ . ينجحَ : فعل مضارع منصوب بالفتحة . تقول أيضا : لن يقضيَ القاضي بالباطل . يقضيَ: فعل مضارع منصوب بالفتحة . وتقول : لن ندعوَ إلا الله . ندعوَ: فعل مضارع منصوب بالفتحة . وتم نصب الفعل المضارع في هذه الأمثلة الثلاثة لأنه تقدمه ناصب كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله العلامة الثانية : الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف . ومن ذلك قوله تعالى " وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ " كلمة : ترضَى : فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة ، وذلك لأنه معتل الآخر بالألف . ونصب هنا الفعل المضارع لأجل أنه تقدمه ناصب . العلامة الثالثة : حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة . تقول مثلا : لن يأكلا من طعام ضار . ولن تأكلا من طعام ضار . ولن يأكلوا من طعام ضار . ولن تأكلوا من طعام ضار . ولن تأكلي من طعام ضار . فهنا الفعل المضارع في هذه الأمثلة الخمسة منصوب بحذف النون . وذلك لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة ونُصِبَ لأجل أن تقدمه ناصب . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الرابعة : ما هي أدوات نصب الفعل المضارع ؟ قال : ينصب الفعل المضارع بسبع أدوات وهي : أن ، لن ، كي ، إذن ، لام التعليل ، حتى ، لام الجحود هذه الأدوات السبعة متى وجدت واحدة منها قبل الفعل المضارع فاعلم أنه منصوب . ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى " أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم " فهنا الفعل المضارع ( يغفرَ ) منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه تقدمه ناصب . ومن ذلك أيضا قوله تعالى" أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ " يُؤْمِنُوا: فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ، ولأنه تقدمه ناصب وهو " أن " ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى " لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ " فهنا الفعل المضارع : نصبرَ : منصوب بالفتحة الظاهرة لأجل أنه تقدمه ناصب . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى " لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا " الفعل المضارع هنا " يعلم " منصوب بالفتحة الظاهرة لأجل أنه تقدمه حرف ناصب وهو " كي " ومن الأمثلة أيضا على ذلك أن تقول : إذَنْ أُكرِمَكَ .. لمن قال لك سآتيك غدا . فهنا الفعل المضارع : أكرِمَكَ: منصوب بالفتحة الظاهرة لأجل أنه تقدمه ناصب وهو " إذن " . والكاف : يعرب ضميرًا مبنيا على الفتح في محل نصب مفعول به . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى : " لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا " فالفعل المضارع هنا : لِيُدخِلَ :منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه سبق بناصب وهو" لام التعليل " . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى " فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" فهنا الفعل المضارع " يأتِيَ " منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه سبق بناصب وهو " حتى " . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى " لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ " فهنا الفعل المضارع " يغفرَ "منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه سبق بناصب وهو " لام الجحود" . أسئلة الدرس السؤال الأول : متى يرفع الفعل المضارع ، مع ذكر مثالين على ما تقول . السؤال الثاني : متى ينصب الفعل المضارع ؟ مع ذكر أمثلة على ما تقول . السؤال الثالث : استخرج من الجمل الآتية الأفعال المضارعة ، وبين نوعها : الأولى : أريدُ أنْ أحفظَ القرآنَ . الثانية : لن أتركَ نقابي . الثالثة : يأمرُ المسلمُ بالمعروفِ . الرابعة : سأعتَمِرُ هذا العامِ السؤال الرابع : أعرب الجمل الآتية : الأولى : لن يتكلمَ الطالبَ . الثانية : يفعلُ المؤمنُ الخيرَ . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#3
|
||||
|
||||
|
الدرس السابع من كتاب المختصر في النحو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس السابع من دروس النحو من كتاب : المختصر في النحو ‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على جزم الفعل المضارع . عرفنا في الدرس السابق أن الفعل المضارع : يرفع ، وينصب ، ويجزم . يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم . وينصب إذا سُبق بأداة من أدوات النصب . ويجزم إذا سُبق بأداة من أدوات الجزم . قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الخامسة : بما يجزم الفعل المضارع ؟ قال : يجزم الفعل المضارع بثلاث علامات : العلامة الأولى : السكون إذا كان صحيح الآخر . ومن ذلك قوله تعالى " وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ " هنا الفعل المضارع ( يُتقبلْ ) مجزوم بالسكون ، لأنه سبق بأداة من أدوات الجزم وهي : لم . العلامة الثانية : حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر . ومن ذلك قوله تعالى " وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ" هنا الفعل المضارع " يخشَ " مجزوم بحذف حرف العلة . وذلك لأنه سُبق بأداة جزم وهي : لم العلامة الثالثة : حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة . وعرفنا في الدرس السابق أن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هي : يفعلان ، تفعلان ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلين . فهنا الفعل المضارع يُجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة . تقول : لمْ يأكلا الطعام . لمْ تأكلا الطعام . لمْ يأكلوا الطعام . لمْ تأكلوا الطعام . لمْ تأكلي الطعام . فهنا الأفعال المضارعة كلها مجزومة بحذف النون . وذلك لأنها سبقت بأداة جزم . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة السادسة : ما هي أدوات جزم الفعل المضارع ؟ قال : يُجزم الفعل المضارع بثماني عشرة أداة وهي : لم ، ولمّا ، وألم ، وألمّا ، ولام الطلب ، ولا الطلبية ، وإن ، ومن ، وما ، وأيّ ، ومتى ، وأين ، وأيانَ ، وأنَّى ، وحيثما ، وكيفما ، وإذْ ما ، ومهما ،. هذه هي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع . متى وجدت أداة من هذه الأدوات قبل الفعل المضارع ، فاعلم أنه مجزوم . وهنا فائدة : وهي الفرق بين : لمْ و لمّا أن " لم " لا تفيد حدوث الفعل في المستقبل . يعني إذا قلت : لمْ ألعب ،يعني لا ألعب في المستقبل . أما" لمّا " فإنها تفيد حدوث الفعل في المستقبل . فإذا قلت : لمّا أحفظ ، يعني سأحفظ في المستقبل . وأدوات الجزم هذه تنقسم إلى قسمين : منها أدوات تجزم فعلا واحدا . ومنها أدوات تجزم فعلين . أما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا فهي ستة : لم ، ولمّا ، وألم ، وألمّا ، ولام الطلب ، ولا الطلبية، وهذه حروف بإجماع النحويين . ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى " وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي " " يطعمْه " فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه سُبق بأداة جزم : لم و " الهاء " ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به . و" الفاعل " ضمير مستتر جوازا تقديره : هو . ومن الأمثلة على ذلك أيضا قوله تعالى" قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا" تُؤْمِنُوا : فعل مضارع مجزوم بحذف النون . لأنه من الأفعال الخمسة . ولأنه سبق بأداة جزم : لم و الواو : ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . والأداة : لم: تعرب حرف نفي وجزم مبنيًا على السكون لا محل له من الإعراب . ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى " وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ " فالفعل المضارع هنا :يَعْلَمِ: مجزوم بالسكون المقدر ، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين . وجزم لأنه سبق بأداة جزم : لمّا . و هنا فائدة : في اللغة العربية لا يمكن التقاء ساكنين . لذلك يحرك الساكن الأول بحركة تناسب الحركة الأولى من الكلمة التالية . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى " أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ " الفعل المضارع هنا " نستحوذ" مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم وهي : ألم و ألم : تعرب حرف نفي وجزم مبنيا على السكون لا محل له من الإعراب . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : ألمّا أكرمْك هنا الفعل المضارع مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم وهي : ألما و الكاف : ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به . وتعرب الأداة وهي ألمّا : حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى" لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ" فهنا الفعل المضارع " ينفقْ" مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم : لام الطلب : التي تدل على الأمر . و لام الطلب : تعرب : حرفا مبنيا على السكون لا محل له من الإعراب . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى : " فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" فهنا الفعل المضارع : تقعدْ ، مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم : لا الطلبية ،التي تدل على النهي . أما أدوات الجزم التي تجزم فعلين فهي اثنا عشر أداة هي : إنْ ، ومَنْ ، وما ، وأي ، ومتى ، وأين ، وأيّانَ ، وأنَّى ، وحيثُما ، وكيفَما ، وإذْ ما ، ومهما فهذه الأدوات تجزم فعلين تسمى : أولهما : فعل الشرط . والثاني : جواب الشرط . ومن الأمثلة على ذلك قولك : إنْ تذاكرْ تنجحْ فهنا تذاكرْ : فعل مضارع ، وهو فعل الشرط مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم :إنْ . والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت و تنجحْ :فعل مضارع وهو جواب الشرط . مجزوم بالسكون لأنه سبق بأداة جزم: إنْ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : من يجتهدْ يَفُزْ يجتهدْ : هو فعل الشرط . و يفزْ :هو جواب الشرط . ويعرب فعل الشرط يجتهد : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم وهي : من والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت أما جواب الشرط وهو " يفز" فيعرب فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم : منْ . والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : ما تفعلْ تُحاسَبْ عليه هنا فعل الشرط : تفعلْ . وجواب الشرط : تحاسبْ فعل الشرط يعرب : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم :ما والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت . وأما جواب الشرط وهو " تحاسب " فيعرب : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم : ما و الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره : أنت . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : أيَّ معروفٍ تصنعْ تُجزَ به فهنا فعل الشرط : تصنع وجواب الشرط : تُجزَ فعل الشرط يعرب : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم" أي " والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره " أنت " وأما جواب الشرط فيعرب : فعلا مضارعا مجزوما بحذف حرف العلة لأنه سبق بأداة جزم " أي " والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره: أنت . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : متى تكلمَّ بالخيرِ اسمعْ له هنا فعل الشرط : تكلم وجواب الشرط : اسمعْ ويعربان : الإعراب السابق . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله تعالى : أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا هنا فعل الشرط : ثُقِفُوا وجواب الشرط :وأخِذُوا هنا فعل الشرط يعرب : فعلا مضارعا مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ، ولأنه سبق بأداة جزم هي : أين . و " الواو " ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل . و" أخذوا" تعرب : فعلا مضارعا مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ، ولأنه سبق بأداة جزم : أين و " الواو " ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل . ومن الأمثلة أيضًا على ذلك قولك : أيّانَ تقرأْ أقرأْ فهنا فعل الشرط : تقرأْ . وجواب الشرط : أقرأْ يعرب كل فعل منهما فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنهما سبقا بأداة جزم وهي : أيان ومن الأمثلة أيضا على ذلك : أنَّى تأمرْ بخير تَجدْ مُجيبًا هنا فعل الشرط : تأمر ، وجواب الشرط : تجد ويعرب كل فعل منهما فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم أنى والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره " أنت " . و من الأمثلة أيضا على ذلك قولك : حيثُما تستقِمْ تفلحْ هنا فعل الشرط "تستقمْ " وجواب الشرط " تفلحْ " . ويعربان الإعراب السابق . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : كيفما تكن همتك يكُنْ نجاحُك هنا فعل الشرط : تكن وجواب الشرط : يكن . فعل الشرط يعرب : فعلا ناقصا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم كيفما ، وحذفت الواو منعا لالتقاء الساكنين . ويعرب جواب الشرط : فعلا مضارعا ناقصا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم وهي : كيفما، وحذفت الواو منعا لالتقاء الساكنين . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : إذْ ما تحسنْ إلى الناس تطمئنْ هنا فعل الشرط "تحسنْ " وجواب الشرط " تطمئنْ " يعرب فعل الشرط : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم إذ ما ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت . وأما جواب الشرط فيعرب : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم : إذ ما . والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت . ومن الأمثلة أيضا على ذلك قولك : مهما تقرأْ تفهمْ فعل الشرط هو : تقرأ وجواب الشرط هو : تفهم ويعربان : فعلا مضارعا مجزوما بالسكون لأنه سبق بأداة جزم وهي : مهما والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت . و هنا فائدة وهي : ما هي الأفعال الخمسة ؟ وما إعرابها ؟ الأفعال الخمسة هي : كل فعل مضارع اتصل به : ضمير التثنية . أو ضمير الجمع . أو ضمير المؤنثة المخاطبة . مثل : يفعلان ، تفعلان ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلين و ترفع بثبوت النون . وتنصب وتجزم بحذف النون . تقول في حال الرفع : يحفظان ، تحفظان ، يحفظون ، تحفظون ، تحفظين وتقول في حال النصب : لن يحفظا ، لن تحفظا ، لن يحفظوا ، لن تحفظوا ، لن تحفظي . وتقول في حال الجزم : لم تحفظا ، لم تحفظا ، لم يحفظوا ، لم تحفظوا ، لم تحفظي . أسئلة الدرس السؤال الأول : متى يُجزم الفعل المضارع ؟ مع ذكر أمثلة على ما تقول . السؤال الثاني : استخرج الفعل المضارع ، وبين نوعه من الجمل الآتية : الأولى : لمّا يأتِ المسافرُ . الثانية : أينما يكُنِ المؤمنُ يكُنِ الخيرُ . الثالثة : ذاكرْ لتنجحَ . الرابعة : أيّان تجدِ العلماءَ تجدِ العلمَ . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#4
|
||||
|
||||
|
الـدرس الثامن مـن كتــاب المختصــر في النحــو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة .وهذا هو الدرس الثامن من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على رفع الأسماء . قال المصنف عفى الله عنه : المبحث الثاني : 《 أحوال إعراب الأسماء 》وفيه فرعان : الفرع الأول : أحوال إعراب الأسماء . الفرع الثاني : أنواع الأسماء المعربة . ثم قال الفرع الأول :《 أحوال إعراب الأسماء 》 عرفنا قبل ذلك أن الأسماء منها معرب ومنها مبني . وعرفنا الأسماء المبنية . هنا نتعرف إن شاء الله تعالى على 《 الأسماء المعربة 》 ثم قال : وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : ما هي أحوال إعراب الأسماء ؟ أحوال إعراب الأسماء أربعة : الحال الأولى : 《 الرفع 》إذا كانت أحد الأنواع الآتية : [ المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، ونائب الفاعل ، واسم كان وأخواتها ، وخبر إن وأخواتها ] . يعني هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة . الحال الثانية : 《 النصب 》إذا كانت أحد الأحوال التالية : [ المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول لأجله ، والمفعول معه ، وظن وأخواتها ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والحال ، والتمييز ، والاستثناء ، واسم لا النافية للجنس ، وخبر كان وأخواتها ، واسم إن وأخواتها ، والمنادى ] . هذه الأنواع كلها تكون منصوبة . الحال الثالثة : 《 الجر 》إذا كانت أحد الأنواع التالية : المجرور بحرف الجر ، والمجرور بالإضافة . الحال الرابعة : 《 الرفع أو النصب أو الجر 》إذا كانت أحد الأنواع التالية : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل ثم شرع في تفصيل ذلك فقال : المسألة الثانية : بِمَا ترفع الأسماء ؟ ترفع الأسماء بثلاث علامات وهي [ الضمة ، والواو ، والألف ] والضمة : علامة أصلية . أما الواو والألف : فعلامتان فرعيتان . وهذا مجمل علامات رفع الأسماء . وفيما يلي تفصيل ذلك . العلامة الأولى وهي : الضمة . وتكون في ثلاثة مواضع : الأول : الاسم المفرد . وهو ما دل على مفرد [ كزيدٌ ، وعمروٌ ، وخديجةُ ، وأسدٌ ، وبيتٌ ، وشجرةٌ ] تقول : (حضرَ زيدٌ ) ( حضرَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و( زيدٌ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وتقول أيضا : ( فازَتْ خديجةُ ) ( فازَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و التاء : حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( خديجةُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . الموضع الثاني : جمع تكسير . وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده تقول : أسَد : أُسْد سَرير : سُرُر كتَاب : كُتُب سَبَب : أسْباب . هذا يسمى بجمع التكسير . ومن الأمثلة عليه تقول : ( انتصرَ الرجالُ ) ( انتصرَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( الرجالُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . تقول أيضا : ( قامَ المرضَى ) ( قامَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( المرضَى ) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر . أما الموضع الثالث فهو : جمع المؤنث السالم . وهو ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره [ كمسلمات ، ومؤمنات ، وقانتات ، وساجدات ، وصائمات ] إلى أخر ذلك . تقول : جاءَت المسلماتُ . ( جاء ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( التاء ) حرف مبني على السكون المقدر ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين ، ولا محل له من الإعراب . و ( المسلماتُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وهنا فائدة : متى كانت الألف أو التاء غير زائدة لم يكن جمع مؤنث سالما وإنما يكون جمع تكسير . مثال منتهي بألف أصلية : القاضي : القضاة الداعي : الدعاة ومثال منتهي بتاء أصلية : أخت : أخوات بيت : أبيات صوت : أصوات فهذه ليست من جمع المؤنث السالم وإنما هي من جمع التكسير . إذن الأسماء ترفع بالضمة في ثلاثة مواضع : الأول : الاسم المفرد . الثاني : جمع التكسير . الثالث : جمع المؤنث السالم . ثم قال : العلامة الثانية : 《 الواو 》 الواو : تكون علامة لرفع الأسماء في موضعين : الموضع الأول : جمع المذكر السالم . وهو ما دل على أكثر من اثنين . مع زيادة واو ونون ، أو ياء ونون [ كالمسلمون ، والمجتهدون ] [ والمستقيمون ، والمنتصرون ] [ والمسلمين ، والمجتهدين ] [ والمستقيمين ، والمنتصرين ] فهذا يسمى بجمع المذكر السالم . إذن المفرد إذا أضفنا إليه : واوًا ونونًا ، أو ياءً ونونًا صار جمع مذكر سالما . أما إذا أضفنا إليه : ألفًا وتاءً صار جمع مؤنث سالما . ومن ذلك تقول : يجتهد المسلمون . هنا ( يجتهدُ ) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( المسلمون ) فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوضٌ عن التنوين الحادث في الاسم المفرد وهو : مسلم . الموضع الثاني : الأسماء الخمسة وهي : [أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال ] الأسماء الخمسة ترفع بالواو ، تقول : تكلم أبوك . وقال أخوك . ويجلس حموك (حموك هو أبو زوجتك) . وسكت فوك . وتقول : أبوك ذو مال . وأخوك ذو جاه . هنا الأسماء الخمسة رفعت بالواو نيابة عن الضمة . وهنا فائدة وهي : أن الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفرت فيها خمسة شروط : الشرط الأول : أن تكون مفردة . فإذا كانت مجموعة أو مثناة لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة . تقول : ( حضر الآباء ، أو حضر الإخوة ) فهنا ( الآباء ) جمع . فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس . وكذلك ( الإخوة ) جمع . فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس . تقول أيضا : ( جلس الأبون ، أو جلس أبواك ) فهنا لا تعرب ( الأبون ) إعراب الأسماء الخمسة ، لأنها جمع مذكر سالم . وكذلك لا تعرب ( أبواك ) إعراب الأسماء الخمسة ، لأنها مثنى . أما الشرط الثاني فهو : ألا تكون مصغرة . فإذا كانت مصغرة أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول مثلًا : ( جاء أُبَيٌّ ) و( جلس أُخَيٌّ ) فهنا ( أُبَيّ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة . وكذلك ( أخَيّ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، لأنهما مصغرتان . وإنما يعربان إعراب الاسم المفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . أما الشرط الثالث فهو : أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم . فإذا كانت غير مضافة أو مضافة لياء المتكلم أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول مثلا : ( جاء أبٌ ) أو ( جاء أبي ) فهنا كلمة ( أب ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، وإنما تعرب إعراب الاسم المفرد . الشرط الرابع : ( أن تخلوَ "فُوكَ" من الميم ) . فإذا اتصلت بها الميم أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول : ( هذا فمٌ حسن ) فكلمة ( فمٌ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، وإنما تعرب إعراب الاسم المفرد . الشرط الخامس : أن تكون ( ذُو ) بمعنى صاحب ، وأن يكون المضاف إليها اسم جنس ظاهرا ليس بوصف . فإذا كانت موصولة بمعنى "الذي" ، أو كان المضاف إليها وصفا لم تعرب إعراب الأسماء الخمس . تقول مثلا : ( جاء ذو قامة ) هنا ( ذو ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمس لأنها بمعنى : الذي . وكذلك تقول : ( مررت برجل ذي قائم ) هنا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها جاءت وصفا وليست اسم جنس . ثم قال : العلامة الثالثة لرفع الأسماء : الألف . وتكون في المثنى . والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون . يعني الاسم المفرد إذا أضيف إليه ألف ونون ، أو ياء ونون صار مثنى . تقول : ( حضر الطالبان ) و ( جلست المرأتان ) فهنا ( الطالبان ) و ( المرأتان ) يعربان فاعلًا مرفوعًا بالألف نيابة عن الضمة لأنهما مثنى . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : استخرج مما يأتي الأسماء المرفوعة وبين أنواعها : الأولى : محمدٌ مجتهدٌ . الثانية : نجحَ الطلابُ . الثالثة : المسلمونَ أقوياءُ . الرابعة : أحبُّ أبي . الخامسة : بكرٌ لَهُ أخٌ . السادسة : أبوكَ كريمٌ . السابعة : الطالبان مجتهدان . الســـؤال الثــاني : أعرِب الجمل الأتية : الأولى : فازَ الطالبُ . الثانية : جلسَ أخوك . الثالثة : سافرَ أبواك . الرابعة : جلسَ الأميران . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الـدرس التاسع مـن كتــاب المختصــر في النحــو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس التاسع من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على:علامات نصب الأسماء قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : بِمَا تنصب الأسماء ؟ قال تنصب الأسماء بأربع علامات وهي : الفتحة . والألف . والكسرة . والياء . أما الفتحة فهي : علامة أصلية . وأما الألف والكسرة والياء : فعلامات فرعية . هذا مجمل علامات نصب الأسماء وفيما يلي سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . قال : العلامة الأولى : الفتحة في موضعين : الموضع الأول : الاسم المفرد . الاسم المفرد ينصب بالفتحة . تقول مثلا : كلمتُ زيدًا كلمتُ: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( زيدًا ) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . ومثال ذلك أيضا قولك : ( رأيتُ الفتى ) ( رأيتُ ) فعل ماضٍ مني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( الفتى ) مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر . أما الموضع الثاني فهو : جمع التكسير . ينصب جمع التكسير بالفتحة . تقول : ( كرمتُ الأبطالَ ) ( الأبطالَ ) تعرب مفعولا به منصوبا بالفتحة الظاهرة . ثم قال العلامة الثانية : الألف: في الأسماء الخمسة وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال . الأسماء الخمسة تنصب بالألف . تقول : كلمت أباك . و رأيت أخاك . و كلِّمْ حماك . وأغلِقْ فاك . وأبصرتُ ذَا علم . هنا الأسماء الخمسة كلها تعرب مفعولا به منصوبا بالألف نيابة عن الفتحة . و( الكاف ) فيها يعرب ضميرا مبنيا على الفتح في محل جر مضاف إليه . وكلمة ( علم ) في ذَا مال تعرب : مضافا إليه مجرورا بالكسرة الظاهرة . ثم قال : العلامة الثالثة : الكسرة : في جمع المؤنث السالم . مثال : رأيتُ الكاتباتِ الناجحاتِ فهنا الاسم : الكاتباتِ ، يعرب مفعولا به منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم . ويعرب الاسم ( الناجحاتِ ) نعتا منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم . ثم قال : العلامة الرابعة : الياء : في المثنى وجمع المذكر السالم . كأن تقول : علّمتُ المسلمَيْنِ كيفيةَ الوضوءِ فهنا الاسم : المسلمَيْنِ : يعرب مفعولا به منصوبا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى . و النون : عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مسلمٌ . وتقول : علّمتُ المسلمِينَ الجُدُدَ كيفيةَ الوضوءِ فهنا الاسم : المسلمِين : يعرب مفعولا به منصوبا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم . و النون: عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مسلم . وهنا فائدة : كيف نفرق بين (ياء المثنى) و (ياء جمع المذكر السالم) الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا . وأما الياء في جمع المذكر السالم : فيكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا . إذن علامات نصب الأسماء أربعة : الفتحة . والألف . والكسرة . والياء . أما الفتحة : فتنصب الأسماء في موضعين : الاسم المفرد و جمع التكسير . وأما الألف : فتكون علامةً لنصب الأسماء الخمسة فقط . وأما الكسرة : فتكون علامةً لنصب جمع المؤنث السالم فقط . وأما الياء : فتكون علامة لنصب المثنى وجمع المذكر السالم . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : بِمَا تُنصب الأسماء ؟ الســـؤال الثــاني : هات من الكلمات الآتية مفردًا مرة وجمع تكسير مرة وضع كل واحد منهما في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا : عالمان . رجلان . قلمان . الســــؤال الثــالث : اُذكر خمسَ جُمل كل جملة تشتمل على اسم من الأسماء الخمسة بحيث يكون منصوبا . الســـؤال الرابـــع : اذكر جملتين بحيث تشتمل كل جملة منهما على جمع مؤنث سالم منصوب واذكر علامة نصبه . الســـؤال الخــامس : هات من الكلمات الآتية جمع مذكر سالما مرة ومثنى مرة أخرى وضع كل واحد منهما في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا : مُخلص . المُجرم . الطائع . المُسلم . الســـؤال الســادس : أعرب الجمل الأتية : الأولى : شرحَ الأستاذُ الدرسَ . الثانية : رأيتُ أباك . الثالثة : كلمتُ الطالباتِ الناجحاتِ . الرابعة : اشتريتُ كتابَينِ . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#6
|
||||
|
||||
|
الـدرس العاشر مـن كتــاب المختصــر في النحــو والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس العاشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: علامات جر الأسماء . قال المصنف عفى الله عنه : المسألة الرابعة : بِمَا تُجر الأسماء ؟ تُجر الأسماء بثلاث علامات وهي : الكسرة . والياء . والفتحة . أما الكسرة : فعلامة أصلية . وأما الياء والفتحة : فعلامتان فرعيتان . ثم شرع المصنف عفا الله عنه في بيان هذه العلامات فقال : العلامة الأولى : الكسرة . في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : الاسم المفرد المنصرف :وهو الذي يلحقه التنوين . تقول مثلا : سلمتُ على زيدٍ فهنا : سلمْتُ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و التاء : ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( على ) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( زيدٍ ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . الموضع الثاني : جمع التكسير المنصرف :وهو الذي يلحقه التنوين . تقول : ( التقيْتُ بالطلابِ المتفوقين ) هنا ( التقيْتُ ) فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( الباء ) حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب . و ( الطلاب ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . و ( المتفوقين ) نعت مجرور بالياء ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : متفوق . أما الموضع الثالث فهو : جمع المؤنث السالم : ومن ذلك قولك : ( دخلتُ على الطالباتِ المتفوقاتِ ) فهنا الاسم ( الطالباتِ ) يعرب : اسم مجرور بالكسرة ، لأنه جمع مؤنث سالم . ويعرب : الاسم ( المتفوقاتِ ) نعتا مجرورا بالكسرة ، لأنه جمع مؤنث سالم . ثم قال المصنف عفا الله عنه : العلامة الثانية : الياء ،في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : الأسماء الخمسة وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال . تقول مثلا : سلمتُ على أبيك . ومررتُ بأخيك . وسعدتُ بحميك . وضَعْ يدك على فيك . وتحدثت مع ذي علم . هنا الأسماء الخمسة كلها مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة . والضمير : الكاف : يعرب ضميرا مبنيا على الفتح في محل جر مضاف إليه . وكلمة : علم : تعرب مضافا إليه مجرورا بالكسرة الظاهرة . أما الموضع الثاني فهو : المثنى تقول : سلمت على الصديقَيْنِ هنا إذا تأملت الاسم " الصديقَيْن " وجدته مجرورا بالياء نيابة عن الكسرة . لماذا ؟ لأنه مثنى . و ( النون ) عوضا عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : صديق . أما الموضع الثالث فهو : جمع المذكر السالم : عرفنا قبل ذلك أن جمع المذكر السالم هو كل مفرد أضيف إليه واوٌ ونون ، أو ياءٌ ونون . ومن ذلك أن تقول : نظرتُ إلى المصلّينَ فهنا إذا تأملت الاسم المُصلين ،وجدته مجرورا بالياء نيابة عن الكسرة ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مصلي . ثم قال : العلامة الثالثة لجر الأسماء : الفتحة في الممنوع من الصرف وهو الذي لا يقبل التنوين . تقول : سافرتُ إليّ مكةَ . مررتُ بعثمانَ . تكلمتُ عن حبيبةَ . فهنا إذا تأملت الأسماء : مكة ، وعثمان ، وحبيبة وجدتها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة . لماذا ؟ لأنها ممنوعة من الصرف . فكل منها يعرب اسما مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنها ممنوعة من الصرف . والممنوع من الصرف قسمان : الأول : ما يُمنع من الصرف لوجود علة واحدة فيه . وهو ثلاثة أنواع : الأول : ما كان آخره ألف تأنيث ممدودة . مثل : صفراء ، خضراء ، حمراء ، بيضاء ، عمياء النوع الثاني : ما كان آخره ألف تأنيث مقصورة . مثل : سلوى ، لبنى ، سلمى ، ليلى النوع الثالث : صيغة منتهى الجموع وهي : جمع التكسير الذي وقع بعد ألفه حرفان . مثل : مساجد ، مقابر ، أفاضل ، منابر أو جمع التكسير الذي وقع بعد ألفه ثلاثة أحرف وسطها ساكن . مثل : مفاتيح ، عصافير ، عجاجين ، عقاقير هذه كلها تسمى بصيغة منتهى الجموع وتعرب إعراب الممنوع من الصرف تجر : بالفتحة . أما القسم الثاني من الممنوع من الصرف فهو : ما يمنع من الصرف لوجود علتين فيه : إحداهما : أن يكون عَلَمًا أو وَصْفًا وهو نوعان : النوع الأول : ما يمنع من الصرف من الأعلام وهي : الأول : الأعلام المؤنثة : تأنيثا معنويا أو لفظيا بالتاء . أو معنويا لفظيا . والتأنيث المعنوي مثل : زينب ، وسعاد ، ورباب . وأما التأنيث اللفظي بالتاء فهو ما كان آخره ( تاء ) وإن لم يكن في الحقيقة مؤنثا مثل : حمزة ، وطلحة ، وشعبة . وأما التأنيث المعنوي اللفظي مثل : خديجة ، حبيبة ، عائشة ، فاطمة ، عزة ، كريمة . الثاني : الأعلام الأعجمية ممنوعة من الصرف . مثل جميع أسماء الأنبياء ، عدا : صالح ، ونوح ، وشعيب ، ومحمد ، ولوط ، وهود . عليهم السلام . تقول مثلا : قرأت عن إبراهيمَ وآدمَ ويونسَ وإسماعيلَ . سلمتُ على صالحٍ ونوحٍ وشعيبٍ ومحمدٍ ولوطٍ وهودٍ . كذلك جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف عدا : مالكًا عليه السلام . تقول : قرأتُ عن ميكائيلَ وجِبْرِيلَ وإسرافيلَ الثالث : الأعلام المنتهية بألف ونون زائدتين . مثل : رمضان ، شعبان ، غسّان ، حسّان . فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف . تقول : سلمت على رمضانَ وشعبانَ وحسّانََ الرابع : الأعلام المركبة تركيبا مزجيًا . مثل : حضر موت ، وبعلبك ، وبور سعيد . هذه الأسماء ممنوعة من الصرف . الخامس : الأعلام التي على وزن الفعل . مثل : أكرم ، أحمد ، أمجد ، أدهم ، يزيد ، وتدمر ، ويشكر . تقول مثلا : سلمتُ على أكرمَ وأحمدَ وأمجدَ وأدهمَ ويزيدَ وتدمرَ ويجبرَ . فكلها مجرورة بالفتحة ، لأنها ممنوعة من الصرف . السادس : الأعلام المعدولة من وزن إلى وزن أخر . مثل : عُمَرَ أصلها عَامِر . فَعُدِلَ عنها إلى عُمَر . كذلك : زُفَر أصلها زَافِر . فَعُدِلَ عنها إلى زُفَر . أما النوع الثاني : فهو ما يمنع من الصرف من الأوصاف . الأول : الأوصاف التي على وزن الفعل . مثل : أجمَل ، وأقبَح ، وأفضَل ، وأنجَح . هذه كلها ممنوعة من الصرف . الثاني : الأوصاف التي تنتهي بألف ونون . مثل : ريّان ، وعطشان ، وجوعان ، وغضبان ، وفرحان . هذه كلها ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة . الثالث : الأوصاف المعدولة من وزن إلى وزن آخر وهي شيئان : الأول : ما كان على وزن : فُعَالٍ و مَفْعَلٍ مثل : أُحادَ ، وثُناءَ ، وثُلاثَ ، ورُباعَ ، ومَوْحَدَ ، ومَثنَى ، ومَثْلَثَ ، ومَرْبَعَ ، إلى عُشَارَ ومَعْشَرَ فهذه كلها ممنوعة من الصرف ، لأنها معدولة عن : واحد واحد . اثنين اثنين . ثلاثة ثلاثة . أربعة أربعة . عشرة عشرة . أما الثاني فهي كلمة : أُخَر ، فهي معدولة عن : آخَر ويشترط لجر الممنوع من الصرف بالفتحة شرطان : الشرط الأول : ألا يبدأ ب : ال . فإن بدأ ب : ال ، أُعرِبَ إعراب الاسم المنصرف . تقول : أغلقتُ قفصًا على عصافيرَ عصافيرَ : هنا تعرب باسم مجرور بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف . أما إذا قلت : أغلقتُ القفصَ على العصافيرِ فهنا تعرب اسما مجرورا بالكسرة ولا تعرب إعراب الممنوع من الصرف . أما الشرط الثاني فهو : ألا يضاف إلى اسم بعده . فإن أضيف إلى اسم بعده أعرِبَ إعراب الاسم المنصرف . مثال تقول : مررتُ بمساجدَ كثيرةٍ هنا مساجد تعرب إعراب الممنوع من الصرف ، لأنها غير مضافة . أما إذا قلت : مررتُ بمساجدِ القريةِ فهنا لا تعرب إعراب الممنوع من الصرف لأنها مضافة . إذن نستطيع أن نلخص علامات إعراب الأسماء فيما يلي : الاسم المفرد : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالكسرة . جمع التكسير : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالكسرة . جمع المؤنث السالم : يرفع بالضمة . وينصب بالكسرة . ويجر بالكسرة . جمع المذكر السالم : يرفع بالواو . وينصب بالياء . ويجر بالياء . المثنى : يرفع بالألف . وينصب بالياء . ويجر بالياء . الأسماء الخمسة : ترفع بالواو . وتنصب بالألف . وتجر بالياء . الممنوع من الصرف : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالفتحة . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : هات من الكلمات الآتية مفردًا وضعه في جملة مفيدة بحيث يكون مجرورا : المتقون . الطلاب . الســـؤال الثــاني : هات من الكلمات الآتية جمع تكسير مرة وجمع مؤنثٍ سالما مرة وضعه في جملة مفيدة بحيث يكون مجرورا . الطالب . الكاتب . الســــؤال الثــالث : استخرج الأسماء المجرورة بالياء من الجمل الآتية : - قوله تعالى " وكونوا مع الصادقين " - اسمع كلام أخيك وأبيك وحميك . الســـؤال الرابـــع : استخرج الممنوع من الصرف من الجمل الآتية ، وبين سبب منعه : - أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها . تزوج النبي صَلَّى الله عليه وسلم خديجة وعائشة وسودة وجويرية وصفية وزينب وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن . - أحب السفر لمكة . جاء الطلاب رباع خماس . لا تتكلم وأنت غضبان ولا تأكل وأنت شبعان . الســـؤال الخــامس : أعرب الجمل الآتية : - صليتُ بمساجد . - سلمتُ على المتفوقين . تكلمتُ عن العلماء . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#7
|
||||
|
||||
|
الـدرس الحادي عشر مـن كتــاب المختصــر في النحــو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: المبتدأ والخبر . قال المصنف عفا الله عنه : الفرع الثاني :《 أنواع الأسماء المُعربة 》 و فيه ثلاثة وعشرون نوعا النوع الأول : المبتدأ والخبر . النوع الثاني : الفاعل . النوع الثالث : نائب الفاعل . النوع الرابع : المفعول به . النوع الخامس : كان وأخواتها . النوع السادس : إن وأخواتها . النوع السابع : النعت . النوع الثامن : العطف . النوع التاسع : التوكيد . النوع العاشر : البدل . النوع الحادي عشر : ظن وأخواتها . النوع الثاني عشر : المفعول المطلق . النوع الثالث عشر : المفعول لأجله . النوع الرابع عشر : المفعول معه . النوع الخامس عشر : ظرف الزمان . النوع السادس عشر : ظرف المكان . النوع السابع عشر : الحال . النوع الثامن عشر : التمييز . النوع التاسع عشر : الاستثناء . النوع العشرون : اسم لا النافية للجنس . النوع الحادي والعشرون : المنادى . النوع الثاني والعشرون : حروف الجر . النوع الثالث والعشرون : المضاف إليه . هذا مجمل أنواع الأسماء المعربة ثم يأتي تفصيل كل نوع من هذه الأنواع كل على حدة . قال المصنف عفا الله عنه : النوع الأول : المبتدأ والخبر . وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : عرف المبتدأ والخبر : المبتدأ هو : الاسم المرفوع في أول الجملة . والخبر هو : الاسم المرفوع الذي يكوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . تسمى الجملة المكونة من المبتدأ والخبر ( جملة اسمية ) إذن عندنا المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة . والخبر اسم مرفوع يكوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . ومن ذلك قولك : ( زيدٌ مجتهدٌ ) ( زيدٌ ) هنا مبتدأ . ( ومجتهدٌ ) خبر ، لأنه كوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . إذن ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( مجتهدٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . من ذلك أيضا قولك : ( الزيدون مجتهدون ) ( الزيدون ) مبتدأ مرفوع بالواو ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : زيد . و ( مجتهدون ) خبر مرفوع بالواو ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مجتهد . المسألة الثانية : ما الذي يشترط في المبتدأ والخبر ؟ قال : يشترط في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في شيئين : الأول : [ الإفراد ، والتثنية ، والجمع ] يعني المبتدأ لو كان مفردا فلا بد أن يكون الخبر مفردا . و المبتدأ لو كان مثنى فلا بد أن يكون الخبر مثنى . و كذلك المبتدأ لو كان جمعا فلا بد أن يكون الخبر جمعا . تقول في حال الإفراد : ( زيد مجتهد ) . هنا المبتدأ مفرد ، والخبر مفرد . وتقول في حال التثنية : ( الزيدان مجتهدان ) المبتدأ هو : ( الزيدان ) مثنى . والخبر وهو : ( مجتهدان ) مثنى . وتقول : ( الزيدون مجتهدون ) المبتدأ هنا ( الزيدون ) جمع . والخبر ( مجتهدون ) جمع . الأمر الثاني الذي لا بد أن يتطابقا فيه : التذكير ، والتأنيث يعني لو كان المبتدأ مذكرا فلا بد أن يكون الخبر مذكرا . ولو كان المبتدأ مؤنثا فلا بد أن يكون الخبر مؤنثا . تقول في حال الإفراد : ( هندُ مجتهدةٌ ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا بالإفراد والتأنيث . وتقول في حال التثنية : ( الهندان مجتهدتان ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا في حالتي التثنية والتأنيث . وتقول في حال الجمع : ( الهندات مجتهدات ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا في حالتي الجمع والتأنيث . وكذلك في الأمثلة التي ذكرتها لكم قبل ذلك تطابق المبتدأ والخبر في التذكير . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : ما هي أقسام المبتدأ ؟ قال ينقسم المبتدأ قسمين : القسم الأول : مبتدأ ظاهر ، و هو ما تقدم ذكره . تقول : زيدٌ محبوبٌ - المسلمون مجتهدون . فهنا كل من : ( زيدٌ ) و ( المسلمون ) مبتدأ ظاهر . القسم الثاني : مبتدأ مُضمَر . وهو ثلاثة أنواع : الأول : ضمير التكلم وهو : أنا ، ونحن أنا : للمفرد ونحن : للجماعة . تقول : أنا زيدٌ ، نحن أبطالٌ . فهنا : أنا ونحن ، مبتدأ مضمَر ، نوعه ضمير تكلم . وعند الإعراب نقول : ( أنا ) ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . و ( زيدٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . ( نحنُ ) ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . و ( أبطالٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . النوع الثاني : ضمير المخاطَبة وهو : [ أنت ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن ] أنت : المخاطَب المفرد . وأنت : للمخاطَبَة المفردة . وأنتما : للمخاطَبَيْن المثنى المذكرين أو الأنثيين . وأنتم : للمخاطَبين الذكور . وأنتن : للمخاطَبات الإناث . تقول : أنت زيدٌ . أنتِ خديجةُ . أنتما مجتهدان . أنتم أحرارٌ . أنتن مسلماتٌ . فهنا المبتدأ : مضمر . نوعه : ضمير مخاطَبة . ويعرب المبتدأ في كل هذه الأمثلة : ضميرا مبنيا في محل رفع مبتدأ . أما النوع الثالث فهو : ضمير الغيب : هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهنَّ هو : للغائب المفرد . وهي : للمفردة المؤنثة . وهما : للغائبَيْن المثنى الذكرين أو الأنثيين . وهم : للغائبين الذكور . وهن : للغائبات الإناث . تقول : هو عمرو . هي سعادٌ . وهما حاضران . وهم عبيدٌ . وهن محجباتٌ . هنا المبتدأ في كل هذه الأمثلة : مُضمَر . نوعه : ضمير غيب . يعرب : ضميرا مبنيا في محل رفع مبتدأ ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الرابعة : ما هي أقسام الخبر ؟ قال ينقسم الخبر خمسة أقسام : القسم الأول : خبر مفرد . وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة . كأن تقول : زيدٌ قائمٌ . الرجالُ قائمون . فاطمةُ مهذبةٌ . هنا الخبر في هذه الأمثلة الثلاثة خبر مفرد ليس بجملة ولا شبه جملة . القسم الثاني : خبر جملة اسمية . كأن تقول : زيدٌ علمهُ غزيرٌ . فهنا الخبر ( علمُهُ غزيرٌ ) جملة اسمية . ويعرب ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( علمُهُ ) مبتدأ ثانٍ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( الهاء ) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . و ( غزيرٌ ) خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة . والجملة الاسمية ( علمُهُ غزيرٌ ) في محل رفع خبر المبتدأ الأول : ( زيدٌ ) القسم الثالث : خبر جملة فعلية . كأن تقول : ( عمروٌ جلسَ أبوهُ ) هنا ( جلسَ أبوهُ ) خبر وهو جملة فعلية . وعند الإعراب تقول : ( عمروٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( جلسَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( أبوهُ ) فاعل مرفوع بالواو ، لأنه من الأسماء الخمسة . و ( الهاء ) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . والجملة الفعلية : ( جلسَ أبوهُ ) في محل رفع خبر المبتدأ وهو : ( عمروٌ ) القسم الرابع : خبر جار ومجرور . كأن تقول : ( بكرٌ في المسجدِ ) هنا الخبر قوله : ( في المسجدِ ) جار ومجرور . وعند الإعراب تقول :( بكرٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . ( في ) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( المسجدِ ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( في المسجدِ ) في محل رفع خبر المبتدأ وهو : ( بكرٌ ) القسم الخامس : خبر ظرف مكان أو زمان . تقول : ( زيدٌ فوقَ البيتِ ) . أو تقول : ( الراحةُ يومَ الجمعةِ ) فهنا قوله : ( فوقَ البيتِ ) خبر للمبتدأ ( زيدٌ ) وهو ظرف مكان . وفي المثال الثاني قوله : ( يومَ الجمعةِ ) خبر للمبتدأ وهو : ( الراحةُ ) وهو ظرف زمان . وعند الإعراب تقول : ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( فوقَ ) ظرف مكان مبني على الفتح . و ( البيتِ ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( فوقَ البيتِ ) في محل رفع خبر المبتدأ : ( زيدٌ ) و تقول في المثال الثاني :( الراحةُ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( يومَ ) ظرف زمان مبني على الفتح . و ( الجمعةِ ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( يومَ الجمعةِ ) في محل رفع خبر المبتدأ : ( الراحةُ ) وهنا فائدة : إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربطه بالمبتدأ ، والرابط نوعان : النوع الأول : ضمير في جملة الخبر يعود إلى المبتدأ .كأن تقول : ( محمدٌ فازَ أبوهُ ) . ف( الهاء ) هنا هي الرابط الذي ربط الخبر بالمبتدأ . أما النوع الثاني فهو : اسم إشارة في جملة الخبر يعود إلى المبتدأ . كأن تقول : ( زيدٌ هذا طالبٌ مجتهدٌ ) . الرابط هنا اسم الإشارة : ( هذا ) إذن نستطيع أن نلخص هذا الدرس في عدة عناصر :الأول : التعريف . المبتدأ : هو الاسم المرفوع في أول الجملة . والخبر : هو الاسم المرفوع الذي يكون مع المبتدأ جملة مفيدة . المبتدأ : ينقسم قسمين . مبتدأ ظاهر . ومبتدأ مُضمَر . مثال : المبتدأ الظاهر : ( زيدٌ محبوبٌ ) والمبتدأ المُضمَر : ثلاثة أنواع . الأول : ضمير التكلم ( أنا ونحن ) . الثاني : ضمير المخاطبة : ( أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن ) . والثالث : ضمير الغيب : ( هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهن ) أما الخبر : فينقسم خمسة أقسام . الأول : خبر مفرد . الثاني : خبر جملة اسمية . الثالث : خبر جملة فعلية . الرابع : خبر جار ومجرور . الخامس : خبر ظرف مكان أو زمان . ويشترط في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في شيئين : الإفراد والتثنية والجمع . والتذكير والتأنيث . فإن كان المبتدأ مفردا فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان مثنى فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان جمعًا فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان المبتدأ مذكرا فلا بد أن يكون الخبر مذكرا . وإن كان المبتدأ مؤنثا فلا بد أن يكون الخبر مؤنثا . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : استخرج كل مبتدأ وكل خبر من الجمل الآتية : الأولى : المسلمُ مؤدبٌ . الثانية : الإسلامُ عظيمٌ . الثالثة : الولدُ جاءَ أبوهُ . الرابعة : أنا مسلمٌ . الخامسة : العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ . الســـؤال الثــاني : ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة اسمية مفيدة بحيث تكون مبتدأ : البلد . الكتاب . العلم . هو . الشجرة . الطيور . الســــؤال الثــالث : ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة اسمية مفيدة بحيث تكون خبرا : الكبيرة . مؤمنون . حلو . قادم . الباكية . الســـؤال الرابـــع : أعرب الجمل الآتية : الأولى : البيت واسع . الثانية : هو طبيب مسلم . الثالثة : الأسد أكل الغزال . الرابعة : عمرو سافر أبوه . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
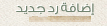 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 10:46 AM





 العرض المتطور
العرض المتطور
