|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الـدرس الثامن مـن كتــاب المختصــر في النحــو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة .وهذا هو الدرس الثامن من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على رفع الأسماء . قال المصنف عفى الله عنه : المبحث الثاني : 《 أحوال إعراب الأسماء 》وفيه فرعان : الفرع الأول : أحوال إعراب الأسماء . الفرع الثاني : أنواع الأسماء المعربة . ثم قال الفرع الأول :《 أحوال إعراب الأسماء 》 عرفنا قبل ذلك أن الأسماء منها معرب ومنها مبني . وعرفنا الأسماء المبنية . هنا نتعرف إن شاء الله تعالى على 《 الأسماء المعربة 》 ثم قال : وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : ما هي أحوال إعراب الأسماء ؟ أحوال إعراب الأسماء أربعة : الحال الأولى : 《 الرفع 》إذا كانت أحد الأنواع الآتية : [ المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، ونائب الفاعل ، واسم كان وأخواتها ، وخبر إن وأخواتها ] . يعني هذه الأنواع كلها تكون مرفوعة . الحال الثانية : 《 النصب 》إذا كانت أحد الأحوال التالية : [ المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول لأجله ، والمفعول معه ، وظن وأخواتها ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والحال ، والتمييز ، والاستثناء ، واسم لا النافية للجنس ، وخبر كان وأخواتها ، واسم إن وأخواتها ، والمنادى ] . هذه الأنواع كلها تكون منصوبة . الحال الثالثة : 《 الجر 》إذا كانت أحد الأنواع التالية : المجرور بحرف الجر ، والمجرور بالإضافة . الحال الرابعة : 《 الرفع أو النصب أو الجر 》إذا كانت أحد الأنواع التالية : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل ثم شرع في تفصيل ذلك فقال : المسألة الثانية : بِمَا ترفع الأسماء ؟ ترفع الأسماء بثلاث علامات وهي [ الضمة ، والواو ، والألف ] والضمة : علامة أصلية . أما الواو والألف : فعلامتان فرعيتان . وهذا مجمل علامات رفع الأسماء . وفيما يلي تفصيل ذلك . العلامة الأولى وهي : الضمة . وتكون في ثلاثة مواضع : الأول : الاسم المفرد . وهو ما دل على مفرد [ كزيدٌ ، وعمروٌ ، وخديجةُ ، وأسدٌ ، وبيتٌ ، وشجرةٌ ] تقول : (حضرَ زيدٌ ) ( حضرَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و( زيدٌ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وتقول أيضا : ( فازَتْ خديجةُ ) ( فازَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و التاء : حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( خديجةُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . الموضع الثاني : جمع تكسير . وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده تقول : أسَد : أُسْد سَرير : سُرُر كتَاب : كُتُب سَبَب : أسْباب . هذا يسمى بجمع التكسير . ومن الأمثلة عليه تقول : ( انتصرَ الرجالُ ) ( انتصرَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( الرجالُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . تقول أيضا : ( قامَ المرضَى ) ( قامَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( المرضَى ) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر . أما الموضع الثالث فهو : جمع المؤنث السالم . وهو ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره [ كمسلمات ، ومؤمنات ، وقانتات ، وساجدات ، وصائمات ] إلى أخر ذلك . تقول : جاءَت المسلماتُ . ( جاء ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( التاء ) حرف مبني على السكون المقدر ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين ، ولا محل له من الإعراب . و ( المسلماتُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وهنا فائدة : متى كانت الألف أو التاء غير زائدة لم يكن جمع مؤنث سالما وإنما يكون جمع تكسير . مثال منتهي بألف أصلية : القاضي : القضاة الداعي : الدعاة ومثال منتهي بتاء أصلية : أخت : أخوات بيت : أبيات صوت : أصوات فهذه ليست من جمع المؤنث السالم وإنما هي من جمع التكسير . إذن الأسماء ترفع بالضمة في ثلاثة مواضع : الأول : الاسم المفرد . الثاني : جمع التكسير . الثالث : جمع المؤنث السالم . ثم قال : العلامة الثانية : 《 الواو 》 الواو : تكون علامة لرفع الأسماء في موضعين : الموضع الأول : جمع المذكر السالم . وهو ما دل على أكثر من اثنين . مع زيادة واو ونون ، أو ياء ونون [ كالمسلمون ، والمجتهدون ] [ والمستقيمون ، والمنتصرون ] [ والمسلمين ، والمجتهدين ] [ والمستقيمين ، والمنتصرين ] فهذا يسمى بجمع المذكر السالم . إذن المفرد إذا أضفنا إليه : واوًا ونونًا ، أو ياءً ونونًا صار جمع مذكر سالما . أما إذا أضفنا إليه : ألفًا وتاءً صار جمع مؤنث سالما . ومن ذلك تقول : يجتهد المسلمون . هنا ( يجتهدُ ) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( المسلمون ) فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوضٌ عن التنوين الحادث في الاسم المفرد وهو : مسلم . الموضع الثاني : الأسماء الخمسة وهي : [أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال ] الأسماء الخمسة ترفع بالواو ، تقول : تكلم أبوك . وقال أخوك . ويجلس حموك (حموك هو أبو زوجتك) . وسكت فوك . وتقول : أبوك ذو مال . وأخوك ذو جاه . هنا الأسماء الخمسة رفعت بالواو نيابة عن الضمة . وهنا فائدة وهي : أن الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفرت فيها خمسة شروط : الشرط الأول : أن تكون مفردة . فإذا كانت مجموعة أو مثناة لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة . تقول : ( حضر الآباء ، أو حضر الإخوة ) فهنا ( الآباء ) جمع . فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس . وكذلك ( الإخوة ) جمع . فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس . تقول أيضا : ( جلس الأبون ، أو جلس أبواك ) فهنا لا تعرب ( الأبون ) إعراب الأسماء الخمسة ، لأنها جمع مذكر سالم . وكذلك لا تعرب ( أبواك ) إعراب الأسماء الخمسة ، لأنها مثنى . أما الشرط الثاني فهو : ألا تكون مصغرة . فإذا كانت مصغرة أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول مثلًا : ( جاء أُبَيٌّ ) و( جلس أُخَيٌّ ) فهنا ( أُبَيّ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة . وكذلك ( أخَيّ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، لأنهما مصغرتان . وإنما يعربان إعراب الاسم المفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . أما الشرط الثالث فهو : أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم . فإذا كانت غير مضافة أو مضافة لياء المتكلم أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول مثلا : ( جاء أبٌ ) أو ( جاء أبي ) فهنا كلمة ( أب ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، وإنما تعرب إعراب الاسم المفرد . الشرط الرابع : ( أن تخلوَ "فُوكَ" من الميم ) . فإذا اتصلت بها الميم أعربت إعراب الاسم المفرد . تقول : ( هذا فمٌ حسن ) فكلمة ( فمٌ ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة ، وإنما تعرب إعراب الاسم المفرد . الشرط الخامس : أن تكون ( ذُو ) بمعنى صاحب ، وأن يكون المضاف إليها اسم جنس ظاهرا ليس بوصف . فإذا كانت موصولة بمعنى "الذي" ، أو كان المضاف إليها وصفا لم تعرب إعراب الأسماء الخمس . تقول مثلا : ( جاء ذو قامة ) هنا ( ذو ) لا تعرب إعراب الأسماء الخمس لأنها بمعنى : الذي . وكذلك تقول : ( مررت برجل ذي قائم ) هنا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنها جاءت وصفا وليست اسم جنس . ثم قال : العلامة الثالثة لرفع الأسماء : الألف . وتكون في المثنى . والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون . يعني الاسم المفرد إذا أضيف إليه ألف ونون ، أو ياء ونون صار مثنى . تقول : ( حضر الطالبان ) و ( جلست المرأتان ) فهنا ( الطالبان ) و ( المرأتان ) يعربان فاعلًا مرفوعًا بالألف نيابة عن الضمة لأنهما مثنى . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : استخرج مما يأتي الأسماء المرفوعة وبين أنواعها : الأولى : محمدٌ مجتهدٌ . الثانية : نجحَ الطلابُ . الثالثة : المسلمونَ أقوياءُ . الرابعة : أحبُّ أبي . الخامسة : بكرٌ لَهُ أخٌ . السادسة : أبوكَ كريمٌ . السابعة : الطالبان مجتهدان . الســـؤال الثــاني : أعرِب الجمل الأتية : الأولى : فازَ الطالبُ . الثانية : جلسَ أخوك . الثالثة : سافرَ أبواك . الرابعة : جلسَ الأميران . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الـدرس التاسع مـن كتــاب المختصــر في النحــو 🍃📚🍃 بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس التاسع من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على:علامات نصب الأسماء قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : بِمَا تنصب الأسماء ؟ قال تنصب الأسماء بأربع علامات وهي : الفتحة . والألف . والكسرة . والياء . أما الفتحة فهي : علامة أصلية . وأما الألف والكسرة والياء : فعلامات فرعية . هذا مجمل علامات نصب الأسماء وفيما يلي سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . قال : العلامة الأولى : الفتحة في موضعين : الموضع الأول : الاسم المفرد . الاسم المفرد ينصب بالفتحة . تقول مثلا : كلمتُ زيدًا كلمتُ: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( زيدًا ) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة . ومثال ذلك أيضا قولك : ( رأيتُ الفتى ) ( رأيتُ ) فعل ماضٍ مني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( الفتى ) مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر . أما الموضع الثاني فهو : جمع التكسير . ينصب جمع التكسير بالفتحة . تقول : ( كرمتُ الأبطالَ ) ( الأبطالَ ) تعرب مفعولا به منصوبا بالفتحة الظاهرة . ثم قال العلامة الثانية : الألف: في الأسماء الخمسة وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال . الأسماء الخمسة تنصب بالألف . تقول : كلمت أباك . و رأيت أخاك . و كلِّمْ حماك . وأغلِقْ فاك . وأبصرتُ ذَا علم . هنا الأسماء الخمسة كلها تعرب مفعولا به منصوبا بالألف نيابة عن الفتحة . و( الكاف ) فيها يعرب ضميرا مبنيا على الفتح في محل جر مضاف إليه . وكلمة ( علم ) في ذَا مال تعرب : مضافا إليه مجرورا بالكسرة الظاهرة . ثم قال : العلامة الثالثة : الكسرة : في جمع المؤنث السالم . مثال : رأيتُ الكاتباتِ الناجحاتِ فهنا الاسم : الكاتباتِ ، يعرب مفعولا به منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم . ويعرب الاسم ( الناجحاتِ ) نعتا منصوبا بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم . ثم قال : العلامة الرابعة : الياء : في المثنى وجمع المذكر السالم . كأن تقول : علّمتُ المسلمَيْنِ كيفيةَ الوضوءِ فهنا الاسم : المسلمَيْنِ : يعرب مفعولا به منصوبا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى . و النون : عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مسلمٌ . وتقول : علّمتُ المسلمِينَ الجُدُدَ كيفيةَ الوضوءِ فهنا الاسم : المسلمِين : يعرب مفعولا به منصوبا بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم . و النون: عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مسلم . وهنا فائدة : كيف نفرق بين (ياء المثنى) و (ياء جمع المذكر السالم) الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا . وأما الياء في جمع المذكر السالم : فيكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا . إذن علامات نصب الأسماء أربعة : الفتحة . والألف . والكسرة . والياء . أما الفتحة : فتنصب الأسماء في موضعين : الاسم المفرد و جمع التكسير . وأما الألف : فتكون علامةً لنصب الأسماء الخمسة فقط . وأما الكسرة : فتكون علامةً لنصب جمع المؤنث السالم فقط . وأما الياء : فتكون علامة لنصب المثنى وجمع المذكر السالم . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : بِمَا تُنصب الأسماء ؟ الســـؤال الثــاني : هات من الكلمات الآتية مفردًا مرة وجمع تكسير مرة وضع كل واحد منهما في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا : عالمان . رجلان . قلمان . الســــؤال الثــالث : اُذكر خمسَ جُمل كل جملة تشتمل على اسم من الأسماء الخمسة بحيث يكون منصوبا . الســـؤال الرابـــع : اذكر جملتين بحيث تشتمل كل جملة منهما على جمع مؤنث سالم منصوب واذكر علامة نصبه . الســـؤال الخــامس : هات من الكلمات الآتية جمع مذكر سالما مرة ومثنى مرة أخرى وضع كل واحد منهما في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا : مُخلص . المُجرم . الطائع . المُسلم . الســـؤال الســادس : أعرب الجمل الأتية : الأولى : شرحَ الأستاذُ الدرسَ . الثانية : رأيتُ أباك . الثالثة : كلمتُ الطالباتِ الناجحاتِ . الرابعة : اشتريتُ كتابَينِ . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#3
|
||||
|
||||
|
الـدرس العاشر مـن كتــاب المختصــر في النحــو والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس العاشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: علامات جر الأسماء . قال المصنف عفى الله عنه : المسألة الرابعة : بِمَا تُجر الأسماء ؟ تُجر الأسماء بثلاث علامات وهي : الكسرة . والياء . والفتحة . أما الكسرة : فعلامة أصلية . وأما الياء والفتحة : فعلامتان فرعيتان . ثم شرع المصنف عفا الله عنه في بيان هذه العلامات فقال : العلامة الأولى : الكسرة . في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : الاسم المفرد المنصرف :وهو الذي يلحقه التنوين . تقول مثلا : سلمتُ على زيدٍ فهنا : سلمْتُ: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و التاء : ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( على ) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( زيدٍ ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . الموضع الثاني : جمع التكسير المنصرف :وهو الذي يلحقه التنوين . تقول : ( التقيْتُ بالطلابِ المتفوقين ) هنا ( التقيْتُ ) فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( الباء ) حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب . و ( الطلاب ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . و ( المتفوقين ) نعت مجرور بالياء ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : متفوق . أما الموضع الثالث فهو : جمع المؤنث السالم : ومن ذلك قولك : ( دخلتُ على الطالباتِ المتفوقاتِ ) فهنا الاسم ( الطالباتِ ) يعرب : اسم مجرور بالكسرة ، لأنه جمع مؤنث سالم . ويعرب : الاسم ( المتفوقاتِ ) نعتا مجرورا بالكسرة ، لأنه جمع مؤنث سالم . ثم قال المصنف عفا الله عنه : العلامة الثانية : الياء ،في ثلاثة مواضع : الموضع الأول : الأسماء الخمسة وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفوك ، وذو مال . تقول مثلا : سلمتُ على أبيك . ومررتُ بأخيك . وسعدتُ بحميك . وضَعْ يدك على فيك . وتحدثت مع ذي علم . هنا الأسماء الخمسة كلها مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة . والضمير : الكاف : يعرب ضميرا مبنيا على الفتح في محل جر مضاف إليه . وكلمة : علم : تعرب مضافا إليه مجرورا بالكسرة الظاهرة . أما الموضع الثاني فهو : المثنى تقول : سلمت على الصديقَيْنِ هنا إذا تأملت الاسم " الصديقَيْن " وجدته مجرورا بالياء نيابة عن الكسرة . لماذا ؟ لأنه مثنى . و ( النون ) عوضا عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : صديق . أما الموضع الثالث فهو : جمع المذكر السالم : عرفنا قبل ذلك أن جمع المذكر السالم هو كل مفرد أضيف إليه واوٌ ونون ، أو ياءٌ ونون . ومن ذلك أن تقول : نظرتُ إلى المصلّينَ فهنا إذا تأملت الاسم المُصلين ،وجدته مجرورا بالياء نيابة عن الكسرة ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عِوَض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مصلي . ثم قال : العلامة الثالثة لجر الأسماء : الفتحة في الممنوع من الصرف وهو الذي لا يقبل التنوين . تقول : سافرتُ إليّ مكةَ . مررتُ بعثمانَ . تكلمتُ عن حبيبةَ . فهنا إذا تأملت الأسماء : مكة ، وعثمان ، وحبيبة وجدتها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة . لماذا ؟ لأنها ممنوعة من الصرف . فكل منها يعرب اسما مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنها ممنوعة من الصرف . والممنوع من الصرف قسمان : الأول : ما يُمنع من الصرف لوجود علة واحدة فيه . وهو ثلاثة أنواع : الأول : ما كان آخره ألف تأنيث ممدودة . مثل : صفراء ، خضراء ، حمراء ، بيضاء ، عمياء النوع الثاني : ما كان آخره ألف تأنيث مقصورة . مثل : سلوى ، لبنى ، سلمى ، ليلى النوع الثالث : صيغة منتهى الجموع وهي : جمع التكسير الذي وقع بعد ألفه حرفان . مثل : مساجد ، مقابر ، أفاضل ، منابر أو جمع التكسير الذي وقع بعد ألفه ثلاثة أحرف وسطها ساكن . مثل : مفاتيح ، عصافير ، عجاجين ، عقاقير هذه كلها تسمى بصيغة منتهى الجموع وتعرب إعراب الممنوع من الصرف تجر : بالفتحة . أما القسم الثاني من الممنوع من الصرف فهو : ما يمنع من الصرف لوجود علتين فيه : إحداهما : أن يكون عَلَمًا أو وَصْفًا وهو نوعان : النوع الأول : ما يمنع من الصرف من الأعلام وهي : الأول : الأعلام المؤنثة : تأنيثا معنويا أو لفظيا بالتاء . أو معنويا لفظيا . والتأنيث المعنوي مثل : زينب ، وسعاد ، ورباب . وأما التأنيث اللفظي بالتاء فهو ما كان آخره ( تاء ) وإن لم يكن في الحقيقة مؤنثا مثل : حمزة ، وطلحة ، وشعبة . وأما التأنيث المعنوي اللفظي مثل : خديجة ، حبيبة ، عائشة ، فاطمة ، عزة ، كريمة . الثاني : الأعلام الأعجمية ممنوعة من الصرف . مثل جميع أسماء الأنبياء ، عدا : صالح ، ونوح ، وشعيب ، ومحمد ، ولوط ، وهود . عليهم السلام . تقول مثلا : قرأت عن إبراهيمَ وآدمَ ويونسَ وإسماعيلَ . سلمتُ على صالحٍ ونوحٍ وشعيبٍ ومحمدٍ ولوطٍ وهودٍ . كذلك جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف عدا : مالكًا عليه السلام . تقول : قرأتُ عن ميكائيلَ وجِبْرِيلَ وإسرافيلَ الثالث : الأعلام المنتهية بألف ونون زائدتين . مثل : رمضان ، شعبان ، غسّان ، حسّان . فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف . تقول : سلمت على رمضانَ وشعبانَ وحسّانََ الرابع : الأعلام المركبة تركيبا مزجيًا . مثل : حضر موت ، وبعلبك ، وبور سعيد . هذه الأسماء ممنوعة من الصرف . الخامس : الأعلام التي على وزن الفعل . مثل : أكرم ، أحمد ، أمجد ، أدهم ، يزيد ، وتدمر ، ويشكر . تقول مثلا : سلمتُ على أكرمَ وأحمدَ وأمجدَ وأدهمَ ويزيدَ وتدمرَ ويجبرَ . فكلها مجرورة بالفتحة ، لأنها ممنوعة من الصرف . السادس : الأعلام المعدولة من وزن إلى وزن أخر . مثل : عُمَرَ أصلها عَامِر . فَعُدِلَ عنها إلى عُمَر . كذلك : زُفَر أصلها زَافِر . فَعُدِلَ عنها إلى زُفَر . أما النوع الثاني : فهو ما يمنع من الصرف من الأوصاف . الأول : الأوصاف التي على وزن الفعل . مثل : أجمَل ، وأقبَح ، وأفضَل ، وأنجَح . هذه كلها ممنوعة من الصرف . الثاني : الأوصاف التي تنتهي بألف ونون . مثل : ريّان ، وعطشان ، وجوعان ، وغضبان ، وفرحان . هذه كلها ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة . الثالث : الأوصاف المعدولة من وزن إلى وزن آخر وهي شيئان : الأول : ما كان على وزن : فُعَالٍ و مَفْعَلٍ مثل : أُحادَ ، وثُناءَ ، وثُلاثَ ، ورُباعَ ، ومَوْحَدَ ، ومَثنَى ، ومَثْلَثَ ، ومَرْبَعَ ، إلى عُشَارَ ومَعْشَرَ فهذه كلها ممنوعة من الصرف ، لأنها معدولة عن : واحد واحد . اثنين اثنين . ثلاثة ثلاثة . أربعة أربعة . عشرة عشرة . أما الثاني فهي كلمة : أُخَر ، فهي معدولة عن : آخَر ويشترط لجر الممنوع من الصرف بالفتحة شرطان : الشرط الأول : ألا يبدأ ب : ال . فإن بدأ ب : ال ، أُعرِبَ إعراب الاسم المنصرف . تقول : أغلقتُ قفصًا على عصافيرَ عصافيرَ : هنا تعرب باسم مجرور بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف . أما إذا قلت : أغلقتُ القفصَ على العصافيرِ فهنا تعرب اسما مجرورا بالكسرة ولا تعرب إعراب الممنوع من الصرف . أما الشرط الثاني فهو : ألا يضاف إلى اسم بعده . فإن أضيف إلى اسم بعده أعرِبَ إعراب الاسم المنصرف . مثال تقول : مررتُ بمساجدَ كثيرةٍ هنا مساجد تعرب إعراب الممنوع من الصرف ، لأنها غير مضافة . أما إذا قلت : مررتُ بمساجدِ القريةِ فهنا لا تعرب إعراب الممنوع من الصرف لأنها مضافة . إذن نستطيع أن نلخص علامات إعراب الأسماء فيما يلي : الاسم المفرد : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالكسرة . جمع التكسير : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالكسرة . جمع المؤنث السالم : يرفع بالضمة . وينصب بالكسرة . ويجر بالكسرة . جمع المذكر السالم : يرفع بالواو . وينصب بالياء . ويجر بالياء . المثنى : يرفع بالألف . وينصب بالياء . ويجر بالياء . الأسماء الخمسة : ترفع بالواو . وتنصب بالألف . وتجر بالياء . الممنوع من الصرف : يرفع بالضمة . وينصب بالفتحة . ويجر بالفتحة . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : هات من الكلمات الآتية مفردًا وضعه في جملة مفيدة بحيث يكون مجرورا : المتقون . الطلاب . الســـؤال الثــاني : هات من الكلمات الآتية جمع تكسير مرة وجمع مؤنثٍ سالما مرة وضعه في جملة مفيدة بحيث يكون مجرورا . الطالب . الكاتب . الســــؤال الثــالث : استخرج الأسماء المجرورة بالياء من الجمل الآتية : - قوله تعالى " وكونوا مع الصادقين " - اسمع كلام أخيك وأبيك وحميك . الســـؤال الرابـــع : استخرج الممنوع من الصرف من الجمل الآتية ، وبين سبب منعه : - أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها . تزوج النبي صَلَّى الله عليه وسلم خديجة وعائشة وسودة وجويرية وصفية وزينب وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن . - أحب السفر لمكة . جاء الطلاب رباع خماس . لا تتكلم وأنت غضبان ولا تأكل وأنت شبعان . الســـؤال الخــامس : أعرب الجمل الآتية : - صليتُ بمساجد . - سلمتُ على المتفوقين . تكلمتُ عن العلماء . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#4
|
||||
|
||||
|
الـدرس الحادي عشر مـن كتــاب المختصــر في النحــو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العـالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: المبتدأ والخبر . قال المصنف عفا الله عنه : الفرع الثاني :《 أنواع الأسماء المُعربة 》 و فيه ثلاثة وعشرون نوعا النوع الأول : المبتدأ والخبر . النوع الثاني : الفاعل . النوع الثالث : نائب الفاعل . النوع الرابع : المفعول به . النوع الخامس : كان وأخواتها . النوع السادس : إن وأخواتها . النوع السابع : النعت . النوع الثامن : العطف . النوع التاسع : التوكيد . النوع العاشر : البدل . النوع الحادي عشر : ظن وأخواتها . النوع الثاني عشر : المفعول المطلق . النوع الثالث عشر : المفعول لأجله . النوع الرابع عشر : المفعول معه . النوع الخامس عشر : ظرف الزمان . النوع السادس عشر : ظرف المكان . النوع السابع عشر : الحال . النوع الثامن عشر : التمييز . النوع التاسع عشر : الاستثناء . النوع العشرون : اسم لا النافية للجنس . النوع الحادي والعشرون : المنادى . النوع الثاني والعشرون : حروف الجر . النوع الثالث والعشرون : المضاف إليه . هذا مجمل أنواع الأسماء المعربة ثم يأتي تفصيل كل نوع من هذه الأنواع كل على حدة . قال المصنف عفا الله عنه : النوع الأول : المبتدأ والخبر . وفيه أربع مسائل : المسألة الأولى : عرف المبتدأ والخبر : المبتدأ هو : الاسم المرفوع في أول الجملة . والخبر هو : الاسم المرفوع الذي يكوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . تسمى الجملة المكونة من المبتدأ والخبر ( جملة اسمية ) إذن عندنا المبتدأ اسم مرفوع في أول الجملة . والخبر اسم مرفوع يكوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . ومن ذلك قولك : ( زيدٌ مجتهدٌ ) ( زيدٌ ) هنا مبتدأ . ( ومجتهدٌ ) خبر ، لأنه كوّن مع المبتدأ جملة مفيدة . إذن ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( مجتهدٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . من ذلك أيضا قولك : ( الزيدون مجتهدون ) ( الزيدون ) مبتدأ مرفوع بالواو ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : زيد . و ( مجتهدون ) خبر مرفوع بالواو ، لأنه جمع مذكر سالم . و ( النون ) عوض عن التنوين الحادث في الاسم المفرد : مجتهد . المسألة الثانية : ما الذي يشترط في المبتدأ والخبر ؟ قال : يشترط في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في شيئين : الأول : [ الإفراد ، والتثنية ، والجمع ] يعني المبتدأ لو كان مفردا فلا بد أن يكون الخبر مفردا . و المبتدأ لو كان مثنى فلا بد أن يكون الخبر مثنى . و كذلك المبتدأ لو كان جمعا فلا بد أن يكون الخبر جمعا . تقول في حال الإفراد : ( زيد مجتهد ) . هنا المبتدأ مفرد ، والخبر مفرد . وتقول في حال التثنية : ( الزيدان مجتهدان ) المبتدأ هو : ( الزيدان ) مثنى . والخبر وهو : ( مجتهدان ) مثنى . وتقول : ( الزيدون مجتهدون ) المبتدأ هنا ( الزيدون ) جمع . والخبر ( مجتهدون ) جمع . الأمر الثاني الذي لا بد أن يتطابقا فيه : التذكير ، والتأنيث يعني لو كان المبتدأ مذكرا فلا بد أن يكون الخبر مذكرا . ولو كان المبتدأ مؤنثا فلا بد أن يكون الخبر مؤنثا . تقول في حال الإفراد : ( هندُ مجتهدةٌ ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا بالإفراد والتأنيث . وتقول في حال التثنية : ( الهندان مجتهدتان ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا في حالتي التثنية والتأنيث . وتقول في حال الجمع : ( الهندات مجتهدات ) هنا المبتدأ والخبر تطابقا في حالتي الجمع والتأنيث . وكذلك في الأمثلة التي ذكرتها لكم قبل ذلك تطابق المبتدأ والخبر في التذكير . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثالثة : ما هي أقسام المبتدأ ؟ قال ينقسم المبتدأ قسمين : القسم الأول : مبتدأ ظاهر ، و هو ما تقدم ذكره . تقول : زيدٌ محبوبٌ - المسلمون مجتهدون . فهنا كل من : ( زيدٌ ) و ( المسلمون ) مبتدأ ظاهر . القسم الثاني : مبتدأ مُضمَر . وهو ثلاثة أنواع : الأول : ضمير التكلم وهو : أنا ، ونحن أنا : للمفرد ونحن : للجماعة . تقول : أنا زيدٌ ، نحن أبطالٌ . فهنا : أنا ونحن ، مبتدأ مضمَر ، نوعه ضمير تكلم . وعند الإعراب نقول : ( أنا ) ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . و ( زيدٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . ( نحنُ ) ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . و ( أبطالٌ ) خبر مرفوع بالضمة الظاهرة . النوع الثاني : ضمير المخاطَبة وهو : [ أنت ، وأنت ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن ] أنت : المخاطَب المفرد . وأنت : للمخاطَبَة المفردة . وأنتما : للمخاطَبَيْن المثنى المذكرين أو الأنثيين . وأنتم : للمخاطَبين الذكور . وأنتن : للمخاطَبات الإناث . تقول : أنت زيدٌ . أنتِ خديجةُ . أنتما مجتهدان . أنتم أحرارٌ . أنتن مسلماتٌ . فهنا المبتدأ : مضمر . نوعه : ضمير مخاطَبة . ويعرب المبتدأ في كل هذه الأمثلة : ضميرا مبنيا في محل رفع مبتدأ . أما النوع الثالث فهو : ضمير الغيب : هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهنَّ هو : للغائب المفرد . وهي : للمفردة المؤنثة . وهما : للغائبَيْن المثنى الذكرين أو الأنثيين . وهم : للغائبين الذكور . وهن : للغائبات الإناث . تقول : هو عمرو . هي سعادٌ . وهما حاضران . وهم عبيدٌ . وهن محجباتٌ . هنا المبتدأ في كل هذه الأمثلة : مُضمَر . نوعه : ضمير غيب . يعرب : ضميرا مبنيا في محل رفع مبتدأ ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الرابعة : ما هي أقسام الخبر ؟ قال ينقسم الخبر خمسة أقسام : القسم الأول : خبر مفرد . وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة . كأن تقول : زيدٌ قائمٌ . الرجالُ قائمون . فاطمةُ مهذبةٌ . هنا الخبر في هذه الأمثلة الثلاثة خبر مفرد ليس بجملة ولا شبه جملة . القسم الثاني : خبر جملة اسمية . كأن تقول : زيدٌ علمهُ غزيرٌ . فهنا الخبر ( علمُهُ غزيرٌ ) جملة اسمية . ويعرب ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( علمُهُ ) مبتدأ ثانٍ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( الهاء ) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . و ( غزيرٌ ) خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالضمة الظاهرة . والجملة الاسمية ( علمُهُ غزيرٌ ) في محل رفع خبر المبتدأ الأول : ( زيدٌ ) القسم الثالث : خبر جملة فعلية . كأن تقول : ( عمروٌ جلسَ أبوهُ ) هنا ( جلسَ أبوهُ ) خبر وهو جملة فعلية . وعند الإعراب تقول : ( عمروٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( جلسَ ) فعل ماضٍ مبني على الفتح . و ( أبوهُ ) فاعل مرفوع بالواو ، لأنه من الأسماء الخمسة . و ( الهاء ) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه . والجملة الفعلية : ( جلسَ أبوهُ ) في محل رفع خبر المبتدأ وهو : ( عمروٌ ) القسم الرابع : خبر جار ومجرور . كأن تقول : ( بكرٌ في المسجدِ ) هنا الخبر قوله : ( في المسجدِ ) جار ومجرور . وعند الإعراب تقول :( بكرٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . ( في ) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب . و ( المسجدِ ) اسم مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( في المسجدِ ) في محل رفع خبر المبتدأ وهو : ( بكرٌ ) القسم الخامس : خبر ظرف مكان أو زمان . تقول : ( زيدٌ فوقَ البيتِ ) . أو تقول : ( الراحةُ يومَ الجمعةِ ) فهنا قوله : ( فوقَ البيتِ ) خبر للمبتدأ ( زيدٌ ) وهو ظرف مكان . وفي المثال الثاني قوله : ( يومَ الجمعةِ ) خبر للمبتدأ وهو : ( الراحةُ ) وهو ظرف زمان . وعند الإعراب تقول : ( زيدٌ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( فوقَ ) ظرف مكان مبني على الفتح . و ( البيتِ ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( فوقَ البيتِ ) في محل رفع خبر المبتدأ : ( زيدٌ ) و تقول في المثال الثاني :( الراحةُ ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( يومَ ) ظرف زمان مبني على الفتح . و ( الجمعةِ ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة . وشبه الجملة : ( يومَ الجمعةِ ) في محل رفع خبر المبتدأ : ( الراحةُ ) وهنا فائدة : إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربطه بالمبتدأ ، والرابط نوعان : النوع الأول : ضمير في جملة الخبر يعود إلى المبتدأ .كأن تقول : ( محمدٌ فازَ أبوهُ ) . ف( الهاء ) هنا هي الرابط الذي ربط الخبر بالمبتدأ . أما النوع الثاني فهو : اسم إشارة في جملة الخبر يعود إلى المبتدأ . كأن تقول : ( زيدٌ هذا طالبٌ مجتهدٌ ) . الرابط هنا اسم الإشارة : ( هذا ) إذن نستطيع أن نلخص هذا الدرس في عدة عناصر :الأول : التعريف . المبتدأ : هو الاسم المرفوع في أول الجملة . والخبر : هو الاسم المرفوع الذي يكون مع المبتدأ جملة مفيدة . المبتدأ : ينقسم قسمين . مبتدأ ظاهر . ومبتدأ مُضمَر . مثال : المبتدأ الظاهر : ( زيدٌ محبوبٌ ) والمبتدأ المُضمَر : ثلاثة أنواع . الأول : ضمير التكلم ( أنا ونحن ) . الثاني : ضمير المخاطبة : ( أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن ) . والثالث : ضمير الغيب : ( هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهن ) أما الخبر : فينقسم خمسة أقسام . الأول : خبر مفرد . الثاني : خبر جملة اسمية . الثالث : خبر جملة فعلية . الرابع : خبر جار ومجرور . الخامس : خبر ظرف مكان أو زمان . ويشترط في المبتدأ والخبر أن يتطابقا في شيئين : الإفراد والتثنية والجمع . والتذكير والتأنيث . فإن كان المبتدأ مفردا فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان مثنى فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان جمعًا فلا بد أن يكون الخبر كذلك . وإن كان المبتدأ مذكرا فلا بد أن يكون الخبر مذكرا . وإن كان المبتدأ مؤنثا فلا بد أن يكون الخبر مؤنثا . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : استخرج كل مبتدأ وكل خبر من الجمل الآتية : الأولى : المسلمُ مؤدبٌ . الثانية : الإسلامُ عظيمٌ . الثالثة : الولدُ جاءَ أبوهُ . الرابعة : أنا مسلمٌ . الخامسة : العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ . الســـؤال الثــاني : ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة اسمية مفيدة بحيث تكون مبتدأ : البلد . الكتاب . العلم . هو . الشجرة . الطيور . الســــؤال الثــالث : ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة اسمية مفيدة بحيث تكون خبرا : الكبيرة . مؤمنون . حلو . قادم . الباكية . الســـؤال الرابـــع : أعرب الجمل الآتية : الأولى : البيت واسع . الثانية : هو طبيب مسلم . الثالثة : الأسد أكل الغزال . الرابعة : عمرو سافر أبوه . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#5
|
||||
|
||||
|
الـدرس الثاني عشر مـن كتــاب المختصــر في النحــو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على:الفاعل ونائب الفاعل . قال المصنف عفا الله عنه : النوع الثاني : الفاعل . وفيه مسألتان : المسألة الأولى : عرف الفاعل : قال : الفاعل : هو اسم مرفوع تقدمه فعل ، ويدل على الذي أسند إليه الفعل . يعني لا بد أن يتقدم الفعل على الفاعل . فإن تقدم الفاعل على الفعل ، أعرِبَ مبتدأ . ومثال ذلك تقول : ( فازَ الطالبُ ) ( فازَ ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( الطالبُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . أما إذا قلت : ( الطالبُ فازَ ) فهنا ( الطالبُ ) يعرب مبتدأ . وتقول مثلا :( جاءَ الأسدُ ) ( جاءَ ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( الأسدُ ) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وهنا فائدة : وهي أنك تستطيع أن تعرف الفاعل بأن تسأل عنه : ( بمن ) للعاقل أو ( ما ) لغير العاقل . مثلا في المثال الأول : ( فاز الطالب ) أين الفاعل ؟ نقول : من الذي فاز ؟ الجواب : الطالب . فالطالب هو الفاعل . مثلا لو قلت : ( أكلَ الولدُ ) تسأل وتقول : من الذي أكل ؟ الجواب هو : الولد . إذن الولد يعرب فاعلا . وفي المثال الثاني : ( جاءَ الأسدُ ) الأسد هنا غير عاقل . هنا نسأل ( بما ) ما الذي جاء ؟ الجواب : الأسد . إذن الأسد هو الفاعل . ثم قال المصنف عفا عنه : المسألة الثانية : ما هي أقسام الفاعل ؟ ينقسم الفاعل قسمين : القسم الأول : فاعل ظاهر . وهو خمسة أنواع : النوع الأول : مفرد . كأن تقول : جلسَ زيدٌ . جاءَ عمروٌ . فهنا الفاعل : مفرد . ( زيدٌ ) و ( عمروٌ ) النوع الثاني : مثنى . تقول : جلس الطالبان . جلست الطالبتان . الفاعل هنا : ( الطالبان ) و ( الطالبتان ) مثنى . النوع الثالث : جمع التكسير . تقول : جلسَ الرجالُ . جلست الهنودُ . فهنا الفاعل : ( الرجالُ ) و ( الهنودُ ) جمع تكسير . النوع الرابع : جمع مذكر سالم . تقول : جلس الحاضرون . يجلس الحاضرون . هنا الفاعل هو : ( الحاضرون ) جمع مذكر سالم . النوع الخامس : جمع مؤنث سالم . تقول : جلست الحاضراتُ . تجلس الحاضراتُ . فهنا ( الحاضراتُ ) فاعل . ونوعه : جمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني فهو : الفاعل المضمر . وهو ثلاثة أنواع : النوع الأول : ضمير التكلم : [ تاء الفاعل ، ونا الفاعلين ] تقول : ( قرأتُ ) ( قرأنَا ) . الفاعل هنا : تاء الفاعل ، ونا الفاعلين . وعند الإعراب تقول : ( قرأتُ ) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل . و ( قرأنا ) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب(نا) الفاعلين . و ( نا ) ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . النوع الثاني : ضمير المخاطَبة وهو : تاء المخاطَب . وتاء المخاطَبة . وضمير المخاطَبين المثنى . وضمير المخاطَبين الجمع . وضمير المخاطَبات . تقول : قرأتَ . قرأتِ . قرأتُما . قرأتمْ . قرأتُنَّ . فهنا الفاعل في جميع هذه الأمثلة هو : ضمير المخاطبة . فهنا ضمير المخاطبة في هذه الأمثلة كلها يعرب ضميرا مبنيا في محل رفع فاعل . أما النوع الثالث فهو : ضمير الغَيْب وهو : ضمير المفرد المذكر . وضمير المفردة المؤنثة . وضمير المثنى . وضمير الجمع المذكر . وضمير الجمع المؤنث . تقول : جلسَ . جلسَتْ . جلسَا . جلسَتَا . جلسُوا . جلسْنَ . فهنا في المثال الأول ( جلسَ ) الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو وفي المثال الثاني ( جلسَتْ ) . الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هي . وفي المثال الثالث ( جلسَا ) الفاعل هو : [الألف] ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . وفي المثال الرابع ( جلسَتَا ) [ الألف ] ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . وفي المثال الخامس ( جلسوا ) [ الواو ] ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل . وفي المثال السادس ( جلسْنَ ) [ النون ] ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل . إذن نستطيع أن نلخص درس الفاعل في أمرين : الأول : تعريفه ، وهو اسم مرفوع تقدمه فعل ، ويدل على الذي أسند إليه الفعل . الثاني : أقسامه . والفاعل ينقسم قسمين : القسم الأول : فاعل ظاهر . والقسم الثاني : فاعل مضمر . أما الفاعل الظاهر فهو خمسة أنواع : مفرد . ومثنى . وجمع تكسير . وجمع مذكر سالم . وجمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني وهو الفاعل المضمر فهو ثلاثة أنواع : ضمير التكلم . وضمير المخاطبة . وضمير الغيب . ثم قال المصنف عفا الله عنه : النوع الثالث : نائب الفاعل . وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : عرف نائب الفاعل : قال : نائب الفاعل هو اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه . كأن تقول : حُفِظَ الدرسُ . وكُسِرَ الإناءُ . هنا إذا تأملت كلمتي : ( الدرسُ ) و ( الإناءُ ) وجدتهما اسمين مرفوعين حلّا محل الفاعل بعد حذفه . وإذا تأملت الفعلين : ( حُفِظَ ) و ( كُسِرَ ) وجدتهما فعلين مبنيين لم يُسَمَّ فاعلهما . وأصل المثال الأول : ( حفظَ زيدٌ الدرسَ ) فلما حذف الفاعل وهو : ( زيدٌ ) أسند الفعل إلى المفعول . وصار ( حُفِظَ الدرسُ ) فالدرس هنا في الأصل مفعول به صار نائب فاعل . وأصل المثال الثاني : ( كسَرَ عمروٌ الإناءَ ) حُذف الفاعل وهو : ( عمروٌ ) . وأسند الفعل إلى المفعول فصار ( كُسِرَ الإناءُ ) وعند الإعراب تقول : في المثال الأول : ( حفظ الدرس ) ( حُفِظَ ) فعل ماض مبني لَما لم يُسمَّ فاعله . و ( الدرسُ ) نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وفي المثال الثاني : ( كُسرَ الإناءُ ) ( كُسِرُ ) فعل ماض مبني للمجهول ، أو مبني لما لم يُسَمَّ فاعله . و ( الإناءُ ) نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . المسألة الثانية : ماذا يحدث للفعل إذا حُذف فاعله ؟ قال : إذا حذف الفاعل وأسند الفعل إلى المفعول فله حالان : الحال الأولى : إذا كان الفعل ماضيا ، ضم أوله وكسر ما قبل آخره . تقول : أَكَلَ أُكِلَ . حَفِظَ حُفِظَ . شَرِبَ شُرِبَ . جَلَسَ جُلِسَ . فهنا ضُم الحرف الأول وكُسِرَ ما قبل الآخر . الحال الثانية : إذا كان الفعل مضارعا ضُم أوله وفُتح ما قبل آخره . تقول : يَأكُلُ يُؤكَلُ . يَدرُسُ يُدرَسُ . يَفتَحُ يُفتَحُ . يَسمَعُ يُسْمَعُ . ويسمى الفعل حينئذ فعلًا مبنيًا لِما لم يُسمَّ فاعله أو فعلا مجهولا . ومن الأمثلة على ذلك إذا قلت : ( أكلَ زيدٌ الطعامَ ) نريد أن نجعل هذه الجملة مبنية للمجهول . ماذا نفعل ؟ نحذف الفاعل ، وهو (زيدٌ) ، فصارت ( أكل الطعام ) ( أكل ) هذا فعل ماض . إذن ماذا نفعل فيه ؟ نضم أوله ونكسر ما قبل آخره . فتصير ( أُكِلَ الطعامُ ) . و( الطعامُ ) تصير مرفوعة كذلك نقول : ( يأكلُ زيدٌ الطعام ) هنا تريد أن تحول هذه الجملة للبناء للمجهول . تحذف الفاعل . ثم تنظر إلى الفعل : إن كان (ماضيا) تضم أوله وتكسر ما قبل آخره وإن كان (مضارعا) تضم أوله وتفتح ما قبل أخره . هنا الفعل (مضارع) إذن نضم أوله ونفتح ما قبل آخره ( يؤكل الطعام ) ( الطعام ) مفعول به يصير نائب فاعل مرفوع بالضمة . ثم قال : المسألة الثالثة : ما هي أقسام نائب الفاعل ؟ ينقسم نائب الفاعل قسمين : الأول : نائب فاعل ظاهر وهو خمسة أنواع كما تقدم في أقسام الفاعل . النوع الأول : مفرد . كأن تقول : ( أكرِمَ زيدٌ ) . ف( زيد ) هنا نائب فاعل مفرد . النوع الثاني : مثنى . كأن تقول : ( أكرِمَ الطالبان ) . ( الطالبان ) نائب فاعل مثنى . النوع الثالث : جمع التكسير . كأن تقول : ( أكرِمَ الطلاب ) . ( الطلاب ) هنا نائب فاعل نوعه جمع تكسير . النوع الرابع : جمع مذكر سالم . تقول : ( أكرم الحاضرون ) . ( الحاضرون ) هنا نائب فاعل ونوعه : جمع مذكر سالم . النوع الخامس : جمع مؤنث سالم . تقول : ( أكرمَت الحاضرات ) . ( الحاضرات ) هنا نائب فاعل ونوعه : جمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني فهو : 《 نائب فاعل مضمر 》وهو أنواع ثلاثة : الأول : ضمير التكلم : [ تاء فاعل ، ونا الفاعلين ] تقول : ( أكرمْتُ ) ( أكرِمْنا ) فهنا نائب الفاعل هو : ( تاء الفاعل ) في المثال الأول . (و نا الفاعلين ) في المثال الثاني . النوع الثاني : ضمير المخاطبة وهو : تاء المخاطب . وتاء المخاطبة. وضمير المخاطبَيْن المثنى . وضمير المخاطبين الجماعة . وضمير المخاطبات . كأن تقول : [ أكرمتَ ، أكرمتِ ، أكرمتُما ، أكرمتمْ ، أكرمْتُنّ ] أما النوع الثالث فهو : ضمير الغيب . وهو ضمير المفرد المذكر . وضمير المفردة المؤنثة . وضمير المثنى . وضمير الجمع المذكر . وضمير الجمع المؤنث . كأن تقول : أكرمَ ، أكرمَتْ ، أكرِما ، أكرِمَتَا ، أكرِمُوا ، أكرِمْنَ فهنا نائب الفاعل هو : ضمير الغيب . في المثال الأول : نائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره : هو والمثال الثاني : أكرمَتْ : نائب الفاعل : ضمير مستتر جوازا تقديره : هي وفي المثال الثالث : [ أكرمَا ] نائب الفاعل : ألف الاثنين . وفي المثال الرابع : [ أكرمتَا ] نائب الفاعل : ألف الاثنين . وفي المثال الخامس :[ أكرموا ] نائب الفاعل : واو الجماعة . وفي المثال السادس : [ أكرمْنَ ] نائب الفاعل : نُون النسوة . إذن نستطيع أن نلخص نائب الفاعل في أمرين : الأول : تعريفه . نائب الفاعل هو : اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه . الثاني : أقسامه : نائب الفاعل ينقسم قسمين ... القسم الأول : نائب فاعل ظاهر وهو : خمسة أنواع : مفرد . ومثنى . وجمع تكسير . وجمع مذكر سالم . وجمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني فهو : نائب فاعل مضمر . وهو ثلاثة أنواع : الأول : ضمير التكلم . الثاني : ضمير المخاطَبة . الثالث : ضمير الغيب . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة فعلية مفيدة ، بحيث تكون (فاعلا) : الأب . المعلم . الطلاب . الســـؤال الثــاني : استخرج الفاعل من الجمل الآتية ، وبين نوعه : الأولى : حافظوا على المسجد . الثانية : جلسا على المائدة . الثالثة : جلست الحاضرات . الســــؤال الثــالث : حول الجمل الآتية إلى البناء للمجهول واضبطها بالشكل : الأولى : شرب زيد اللبن . الثانية : سمعت عائشة القرآن . الثالثة : ألقى المدير خطابا . الســـؤال الرابـــع : استخرج نائب الفاعل من الجمل الآتية ، وبين نوعه ، ثم رد كل جملة إلى أصلها مكونة من : فعل ، وفاعل ، ومفعول : الأولى : كُسِرَ الزجاجُ . الثانية : طُبِعَ الكتابُ . الثالثة : ضُرِبَتْ فاطمةُ . الســـؤال الخــامس : أعرب الجمل الآتية : الأولى : كتب العامل رسالة . الثانية : قُرِأ الكتاب . الثالثة : تحجبت الفتيات . الرابعة : حُفِظَ القرآن . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#6
|
||||
|
||||
|
الدرس الثالث عشر من كتاب المختصر في النحو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: المفعول به . قال المصنف عفا الله عنه : النوع الرابع : 《 المفعول به 》وفيه مسألتان : المسألة الأولى : عرف المفعول به . قال : المفعول به هو اسم منصوب يدل على الذي وقع عليه الفعل . ومن ذلك قولك : ( شرحَ الأستاذُ الدرسَ ) فهنا ( الدرسَ ) مفعول به . لماذا ؟ لأنه هو الذي وقع عليه الفعل . لذلك يعرب : مفعول به . وتستطيع أن تعرف المفعول به بأن تسأل عنه ب( ماذا ؟ ) تقول في هذا المثال : ما الذي شرح الأستاذ ؟ الجواب : الدرس . هذا هو المفعول به . ولا يشترط يتقدم الفعلُ على المفعول به . فقد يتقدم المفعول به على الفعل وقد يتأخر . ومن ذلك أيضا قولك : ( لمْ تشربْ خديجةُ اللبنَ ) هنا كلمة : ( اللبن ) مفعول به . لماذا ؟ لأنها هي الذي وقع عليها الفعل . لذلك تعرب : مفعولا به . ثم قال المصنف عفا الله عنه : المسألة الثانية : ما هي أقسام المفعول به ؟ قال : ينقسم المفعول به قسمين : القسم الأول : مفعول به ظاهر . وهو خمسة أنواع : النوع الأول : مفرد . كأن تقول : ( كرّمَ المديرُ الفائزَ ) فهنا ( الفائزَ ) مفعول به مفرد . وعند الإعراب تقول : ( كرمَ ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( المديرُ ) فاعل مرفوع بالضمة . و ( الفائزَ ) مفعول به منصوب بالفتحة . النوع الثاني : مُثنى . كأن تقول : ( كرّمَ المديرُ الفائزَيْن ) فهنا كلمة ( الفائزَيْن ) مفعول به . نوعه : مثنى . النوع الثالث : جمع تكسير . كأن تقول : ( كرمَ المديرُ الطلابَ ) فهنا ( الطلاب ) مفعول به منصوب بالفتحة . نوعه : جمع تكسير . النوع الرابع : جمع مذكر سالم . كأن تقول : ( كرمَ المديرُ الفائزين ) فهنا ( الفائزين ) مفعول به . نوعه : جمع مذكر سالم . النوع الخامس : جمع مؤنث سالم . كأن تقول : ( كرمَت المديرةُ الفائزاتِ ) فهنا ( الفائزاتِ ) مفعول به . نوعه : جمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني فهو : مفعول به مضمر وهو نوعان : النوع الأول : مفعول به مضمر متصل . النوع الثاني : مفعول به مضمر منفصل . أما المفعول به المضمر المتصل فهو : ما لا يمكن الابتداء به في أول الكلام . أما المفعول به المضمر المنفصل فهو : ما يمكن الابتداء به في أول الكلام . والمضمر المتصل ثلاثة أنواع : الأول : ضمير التكلم وهو : [ ياء المتكلم ، نا المتكلمين ] تقول : ( أكرَمَني عمروٌ ) ( يُكرمُنا عمروٌ ) فهنا [ ياء المتكلم ] في المثال الأول مفعول به . [ والنا ] في المثال الثاني مفعول به أيضا . وعند الإعراب : ( أكرمني ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( النون ) للوقاية . نون الوقاية هذه تقي الفعل من الكسر إذا اتصلت به ياء التكلم ، ولولاها لكُسِر الفعل . و كسرُ الفعل لا يصح في اللغة . و ( الياء ) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به . و ( يكرمُنا ) فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( النا ) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به . و ( عمروٌ ) في المثالين يعرب : فاعلا مرفوعًا بالضمة الظاهرة . أما النوع الثاني فهو : ضمير المخاطبة وهو : كاف المخاطَب المذكر . وكاف المخاطَبة المؤنثة . وكاف المخاطبَيْن . وكاف المخاطبِين . وكاف المخاطَبات . تقول : أسعدَكَ أخوكَ . أسعدَكِ أخوكِ . وأسعدَكُما الأميرُ . وأسعدَكُم الأميرُ . وأسعدَكُنَّ القاضي . فهنا المفعول به في هذه الأمثلة الخمسة هو : ضمير المخاطبة . و عند الإعراب تقول : ( أسعدَك ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( الكاف ) ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم . و كذلك تقول في الأمثلة الباقية . النوع الثالث : ضمير الغيب وهو : هاء المفرد المذكر . وهاء المفردة المؤنثة . وهاء المثنى . وهاء جمع المذكر . وهاء جمع المؤنث . تقول : أجلسَهُ ابنُهُ . وأجلسَها ابنُهَا . وأجلسَهُما القاضي . وأجلسَهُمْ عمروٌ . وأجلسَهُنَّ الفتَى . فهنا المفعول به في هذه الأمثلة الخمسة هو : ضمير الغيب . وعند الإعراب تقول : ( أجلسَهُ ) فعل ماض مبني على الفتح . و ( الهاء ) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به . و هكذا تقول في باقي الأمثلة . أما المفعول به المضمر المنفصل فهو ثلاثة أنواع : وهذا كما قلنا يمكن الابتداء به في أول الكلام . النوع الأول : ضمير التكلم وهو : [ إيّاي ، وإيّانا ] تقول مثلا : ( إيّايَ أكرَمْتَ) و ( إيّانا أكرَمْتَ ) فهنا عند الإعراب تقول : ( إيّا ) ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم . و ( الياء ) حرف دال على المتكلم المفرد . و ( النا ) حرف دال على المتكلم الجماعة أو المفرد المعظم نفسه . و النوع الثاني هو : ضمير المخاطبة وهو : [ إيّاكَ ، وإيّاكِ ، وإيّاكُما ، وإيّاكُم ، وإيّاكُنَّ] تقول مثلا : إيّاكَ أكرمتُ . وإيّاكِ أكرمتُ . وإيّاكُما أكرمتُ . وإيّاكُمْ أكرمْنَا . وإيّاكُنَّ أكرَمْنَا . فهنا المفعول به في هذه الأمثلة هو : ضمير المخاطبة . وعند الإعراب تقول : ( إيّا ) ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم . و ( الكاف ) في إياكَ حرف دال على المخاطب المفرد المذكر . و ( الكاف ) في إياكِ حرف دال على المخاطبة المفردة المؤنثة . و ( الكاف ) في إياكُما حرف دال على المخاطبين الذكرين أو الانثيين . و ( الميم والألف ) علامة التثنية . و ( الكاف ) في إياكُم حرف دال على المخاطبين الذكور . و ( الميم ) علامة جمع المذكر السالم . و ( الكاف ) في إياكُن حرف دال على المخاطبات الإناث . و ( النون ) علامة جمع المؤنث السالم . النوع الثالث : ضمير الغيب وهو : [ إيّاهُ ، وإيّاهَا ، وإيّاهُمَا ، وإيّاهُمْ ، وإيّاهُنَّ] تقول مثلا : إياهُ أكرَمْتُ . وإياها أكرَمْتُ . وإياهُما أكرَمْتُ . وإيّاهُمْ أكرَمْنَا . وإيّاهُنَّ أكرَمْنَا . فهنا المفعول به في هذه الأمثلة كلها هو : ضمير الغيب . وعند الإعراب تقول : ( إيا ) ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم . و ( الهاء ) في إيّاه حرف دال على الغائب المفرد المذكر . و ( الهاء ) في إيّاها حرف دال على الغائبة المفردة المؤنثة . و ( الهاء ) في إياهما حرف دال على الغائبَيْنِ الذّكرَيْنِ أو الأنثَيَيْنِ . و ( الميم والألف ) علامة التثنية . و ( الهاء ) في إيّاهم حرف دال على الغائبِينَ الذكور . و ( الميم ) علامة جمع المذكر السالم . و ( الهاء ) في إيّاهن حرف دال على الغائبات الإناث . و ( النون ) علامة جمع المؤنث السالم . إذن نستطيع أن نلخص درس المفعول به في أمرين : الأول : تعريفه . الثاني : أقسامه . أما تعريفه فهو : اسم منصوب يدل على الذي وقع عليه الفعل . أما أقسامه : ينقسم المفعول به قسمين : القسم الأول : مفعول به ظاهر . وهو : خمسة أنواع : مفرد . ومثنى . وجمع تكسير . وجمع مذكر سالم . وجمع مؤنث سالم . أما القسم الثاني فهو : مفعول به مضمر . وهو نوعان : الأول : مفعول به مضمر متصل وهو : ما لا يمكن الابتداء به في أول الكلام وهو : ضمير التكلم . وضمير المخاطبة . وضمير الغيب . النوع الثاني : مفعول به مضمر منفصل وهو ما يمكن الابتداء به في أول الكلام وهو ثلاثة أنواع : ضمير التكلم . وضمير المخاطبة . وضمير الغيب . و هنا فائدة : ما الفرق بين : ( الفاعل ) و ( المفعول ) ؟ نستطيع أن نفرق بين الفاعل والمفعول من عدة وجوه : الوجه الأول : النوع . الفاعل اسم ️ والمفعول اسم . الوجه الثاني : التعريف . الفاعل هو الذي أسنِدَ إليه الفعل . أما المفعول فهو الذي وقع عليه الفعل . الوجه الثالث : الإعراب . يُرفَع الفاعل بالضمة أو ما ناب عنها . أما المفعول فيُنصَب بالفتحة أو ما ناب عنها . الوجه الرابع : الشروط . يشترط بالفاعل أن يُسبَقَ بفعل . أما المفعول فلا يشترط أن يُسبَقَ بفعل ، بل قد يأتي قبل الفعل . أسئــلة الــدرس الســؤال الأول : استخرِج المفعول به من الجمل الآتية ، وبين نوعه : الأولى : ضرب بكر سعدا . الثانية : أطاعه ابنه . الثالثة : أسعدها أبوها . الرابعة : صليت الفجر . الســـؤال الثــاني : أعرب الجمل الآتية : الأولى : حفظ الولد القرآن . الثانية : أعجبني القارئ . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
|
#7
|
||||
|
||||
|
الدرس الرابع عشر من كتاب المختصر في النحو بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة العلمية المباركة . وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس النحو من كتاب المختصر في النحو‹ وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على: كان وأخواتها . وإن وأخواتها . قال المصنف عفى الله عنه : النوع الخامس : 《 كان وأخواتها 》 وفيه خمس مسائل : المسألة الأولى : ما عمل كان وأخواتها ؟ قال : تدخل كان وأخواتها على المبتدأ فترفعه ويُسمى : اسمها . وتدخل على الخبر فتنصبه ويسمى : خبرها . أي أن (كان) تدخل على الجملة الاسمية فالمبتدأ يصير اسمها والخبر يصير خبرها . ومن ذلك إذا قلت : ( التلميذُ مجتهدٌ ) إذا أدخلت (كان) على هذه الجملة تصير : ( كان التلميذُ مجتهدًا ) فكلمة : ( التلميذُ ) تعرب : اسم كان مرفوع بالضمة . و ( مجتهدًا ) تعرب خبر كان منصوب بالفتحة . ومن ذلك أيضا إذا قلت : ( المعلمُ مُتعَبٌ ) إذا أدخلت ( أمسى ) وهى من أخوات كان تصير الجملة : ( أمسى المعلمُ مُتعَبًا ) ( المعلمُ ) اسم أمسى مرفوع بالضمة . و ( متعبًا ) خبر أمسى منصوب بالفتحة . ومن ذلك أيضا إذا قلت : ( زيدٌ جالسٌ ) إذا أردت أن تدخل ( صار ) وهي من أخوات كان على هذه الجملة تصير : ( صار زيدٌ جالسًا ) ( زيدٌ ) اسم صار مرفوع بالضمة . و ( جالسًا ) خبر صار منصوب بالفتحة . ثم قال : المسألة الثانية : ما هي أخوات كان ؟ وما إعرابها ؟ قال : كان وأخواتها ثلاثة عشر فعلا وهي : كان . أمسى . أصبح . أضحى . ظل . بات . صار . ليس . ما زال . ما انفك . ما فتِئَ . ما برح . ما دام . ومعنى ما انفك : لم يزل . ومعنى ما فتِئَ : ما زال . ومعنى ما برح : ما زال . وتعرب جميعها الإعراب التالي : فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر . وسمي بفعل ناقص لأنه لا يكتفي بمرفوعه . وتعرب ( ما ) في [ما زال ، وما انفك ، وما فتِئَ ، وما بَرِحَ وما دام ] : حرف نفي مبنيّ على السكون . فإذا قلت مثلا : ( ما زال الإسلامُ عظيمًا ) ( ما ) حرف نفي مبني على السكون . و ( زال ) فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر . و ( الإسلامُ ) اسم ما زال مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( عظيمًا ) خبر ما زال منصوب بالفتحة الظاهرة . ثم قال : المسألة الثالثة : ما هي أقسام كان وأخواتها من حيث عملها ؟ قال : تنقسم كان وأخواتها من حيث عملها - وهو رفع الاسم ونصب الخبر - ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يعمل عملها بدون شروط وهو ثمانية أفعال : كان . وأمسى . وأصبح . وأضحى . وظل . وبات . وصار . وليس . هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها وهو : رفع الاسم ونصب الخبر ، بدون شروط . أما القسم الثاني فهو : ما يعمل عملها بشرط أن يتقدمها : نفي . أو استفهام . أو نهي . وهو أربعة أفعال : زال . انفك . فتِئَ . برِحَ . هذه الأفعال الأربعة لكي تعمل عمل كان وأخواتها لا بد أن يتقدمها : نفي ، أو استفهام ، أو نهي تقول في : ( زال ) : ما زالَ . هل زالَ ؟ لا تزلْ . وتقول في : انفَكَّ : ما انفَكَّ . هل انفَكَّ ؟ لا تنفَكّْ . وتقول في : فتِئَ ما فتِئَ . هل فتِئَ ؟ لا تفْتَأْ . وتقول في : بَرِحَ ما برحَ . هل برِحَ ؟ لا تبرَحْ . أما القسم الثالث فهو ما يعمل عملها بشرط أن يتقدمها :ما المصدرية الظرفية ، وهو فعل واحد ( دام ) ومِن ذلك قوله تعالى : { وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا } أي مد دوامي حيًّا . فهنا ( ما ) ظرفية . و ( دُمْتُ ) تعرب : فعلا ماضيا ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر . و ( التاء ) ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم ما دام . و ( حيًا ) تعرب : خبر ما دام منصوبا بالفتحة الظاهرة . ثم قال : المسألة الرابعة : ما هي أقسام كان وأخواتها من حيث التصرف ؟ قال : تنقسم كان وأخواتها من حيث التصرف ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يتصرفُ تصرُّفًا مطلقًا . أي يأتي منه [ الماضي ، والمضارع ، والأمر ] وهو سبعة أفعال : كان . وأمسى . وأصبح . وأضحى . وظل . وبات . وصار . هذه الأفعال السبعة يمكن أن تأتي بالأفعال الثلاثة منها . تقول في : ( كان ) : [ كان ، يكونُ ، كُنْ ] وفي : ( أمسى ) : [ أمسى ، يُمسي ، اِمْسِ ] وفي : ( أصبح ) : [ أصبَحَ ، يُصبِحُ ، أَصْبِحْ ] وهكذا ... أما القسم الثاني فهو ما يتصرف تصرفًا ناقصًا . أي يأتي منه الماضي والمضارع فقط وهو أربعة أفعال : زال . وانفك . وفَتِئَ . وبَرِحَ . يعني لا يأتي من هذه الأفعال الأربعة فعل الأمر . تقول : زال ، يزال انفكَّ ، ينفَكُّ فتِئَ ، يفتَأُ برِحَ ، يبرَحُ أما القسم الثالث فهو : ما لا يتصرف مطلقا . أي يلزم صيغة الماضي لا يمكن أن يأتي منه المضارع أو الأمر . وهو فعلان : ليس . وما دام . ويسمى كل فعل منهما فعلًا ( جامدًا ) ثم قال : المسألة الخامسة : هل صيغة المضارع والأمر تعملان عمل صيغة الماضي ؟ نعم ، صيغة المضارع والأمر تعملان عمل صيغة الماضي فترفعان الاسم وتنصبان الخبر . تقول مثلا في : ( كان ) : ( كان الولدُ مجتهدًا ) ، هذا في الماضي . وفي المضارع تقول : ( يكونُ الولدُ مجتهدًا ) وفي الأمر تقول : ( كُنْ مجتهدًا ) وعند إعراب صيغة المضارع تقول : ( يكونُ ) فعل مضارع متصرف من كان الناقصة ، يرفع الاسم وينصب الخبر . و ( الولدُ ) اسم (يكون) مرفوع بالضمة الظاهرة . و ( مجتهدًا ) خَبر (يكون) منصوب بالفتحة الظاهرة . وعند إعراب صيغة الأمر تقول : ( كُنْ ) فعل أمر متصرف من كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر . واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره : ( أنت ) كُنْ أنتَ . و( مجتهدًا ) خبر (كن) منصوب بالفتحة الظاهرة . ومن الأمثلة أيضًا على ذلك تقول في حال الماضي : ( أمسَى الرجلُ مؤمنًا ) وفي المضارع : ( يُمسِي الرجلُ مؤمنًا ) وفي الأمر : ( اِمْسِ مؤمنًا ) وتقول أيضا في حال الماضي : ( صارَ الطالبُ ذكيًا ) وفي حال المضارع : ( يَصيرُ الطالبُ ذكيًا ) وفي حال الأمر تقول : ( صِرْ ذكيًا ) ومن ذلك أيضا تقول في حال الماضي : ( ما انفَكَّ المريضُ متعَبًا ) وتقول في حال المضارع : ( لا ينفكُّ المريضُ متعَبًا ) وهكذا في جميع أخوات كان . ثم قال المصنف عفا الله عنه : النوع السادس : 《 إن وأخواتها 》 وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : ما عمل إن وأخواتها ؟ قال : تدخل إن وأخواتها على المبتدأ فتنصبه ويسمى : اسمها . وتدخل على الخبر فترفعه ويسمى : خبرها . يعني عكس كان وأخواتها . كان وأخواتها تدخل على المبتدأ فترفعه ، وتدخل على الخبر فتنصبه . أما إن وأخواتها فتدخل على المبتدأ فتنصبه ، وتدخل على الخبر فترفعه . ومن ذلك إذا قلت : ( التلميذُ مجتهدٌ ) إذا أدخلت ( إنَّ ) على هذه الجملة تصير : ( إنَّ التلميذَ مجتهدٌ ) هنا ( التلميذَ ) اسم إنَّ منصوب بالفتحة . و ( مجتهدٌ ) خبر إن مرفوع بالضمة . تقول أيضا : ( الجوُّ حارٌّ ) إذا أدخلت : ( كأنَّ ) وهي من أخوات (إن) على هذه الجملة تصير : ( كأنَّ الجوَّ حارٌّ ) ( الجوَّ ) اسم كأن منصوب بالفتحة . و ( حارٌّ ) خبر كأن مرفوع بالضمة . تقول أيضا : ( المسجدُ مزدحمٌ ) إذا أردت أن تتدخل : ( لعل ) على هذه الجملة وهي من أسماء إن تصير : ( لعلَّ المسجدَ مزدحمٌ ) ( المسجدَ ) اسم لعل منصوب بالفتحة . و ( مزدحمٌ ) خبر لعل مرفوع بالضمة . ثم قال : المسألة الثانية : ما هي أخوات إن ؟ وما إعرابها ؟ قال : إن وأخواتها ستة حروف وهي : إنَّ . وأنَّ . ولكنَّ . وكأنَّ . وليتَ . ولعلَّ . وتعرب جميعها حرفًا مبنيًّا على الفتح لا محل له من الإعراب . ثم قال : المسألة الثالثة : ما هي معاني إن وأخواتها ؟ مع ذكر أمثلة على ما تقول . قال لكل حرف من حروف إن وأخواتها معنى : أما ( إنّ ) فمعناه توكيد نسبة الخبر للمبتدأ . ومن ذلك تقول : ( إنَّ الإسلامَ قادمٌ ) وهنا تؤكد قدومَ الإسلامِ . و ( أنَّ ) كذلك معناها : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ . تقول : ( أُخْبِرْتُ أنَّ زيدًا ناجحٌ ) هنا تؤكد نسبة الخبر وهو : ( النجاح ) إلى المبتدأ وهو : ( زيد ) أما ( لكن ) فمعناها الاستدراك وهو إثبات ما يتوهم نفيه . كأن تقول : ( محمدٌ مجتهدٌ لكنَّ أخاهُ مهمِلٌ ) فهنا أثبت ما قد يتوهم نفيه وهو إهمال الأخ . وأما ( كأنَّ ) فمعناها تشبيه المبتدأ بالخبر . تقول : ( كأن الرجلَ أسدٌ ) فهنا شبه المبتدأ وهو : ( الرجل ) بالخبر وهو : ( الأسد ) وأما ( لَيْتَ ) فمعناها التمني . ومن ذلك تقول : ( ليتَ الشبابَ راجعٌ ). أو ( ليتً المهملَ ناجحٌ ). و أما ( لعَلَّ ) فمعناها الترجي . تقول : ( لعلَّ أبِي قادِمٌ ) يعني أرجو قدوم أبي . وعند إعراب هذه الجملة تقول : ( لعل ) حرف تَرَجٍّ ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر . و ( أبي ) اسم لعل منصوب بالفتحة المقدرة ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة . و ( الياء ) ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . و ( قادم ) خبر لعل مرفوع بالضمة الظاهرة . وكذلك في سائر الجمل تقول مثل هذا الإعراب . ️ أسئلة الدرس السؤال الأول : بيّن كل اسم وخبر لكان وأخواتها في الجمل الآتية : الأولى : كان زيد مريضا . الثانية : بات القط جائعا . الثالثة : ما زال العلم متاحا . الرابعة : ما دام الأمن منتشرا . الخامسة : يمسي الجو باردا . السادسة : ما برح الحارس واقفا . السؤال الثاني : أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل الآتية ، ثم اضبطها بالشكل بحيث لا تكرر الفعل في أكثر من جملة : الأولى : التاجر أمين . الثانية : الشارع مزدحم . الثالثة : الغني فقير . الرابعة : الحق ظاهر . السؤال الثالث : بيّن كل اسم وخبر لإن وأخواتها في الجمل الآتية : الأولى : إن زيدا مريض . الثانية : لعل المريض نشيط . الثالثة : لكن الصلاة فريضة . الرابعة : كأن القط أسد . السؤال الرابع : أدخل إن أو إحدى أخواتها على الجمل الآتية ، ثم اضبطها بالشكل بحيث لا تكرر الحرف في أكثر من جملة . الأولى : التاجر أمين . الثانية : البلد واسعة . الثالثة : الشارع مزدحم . الرابعة : الحق ظاهر . السؤال الخامس : أعرب الجمل الآتية : الأولى : كان الطالب نشيطا . الثانية : ليس الإسلام إرهابا . الثالثة : إن الولد نشيط . الرابعة : لعل الخير راجع . نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . |
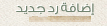 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 04:30 PM





 العرض المتطور
العرض المتطور
