|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
ومن مات على التوحيد فقد مات على لُب الدين وأساسِه،
فلا غَرْو أن يكون له من الفضل ما يؤهله لدخول الجنة، والفوز برضوان الله، ومعنى التوحيد لا يقتصر على قول كلمته دون العلم بمعناها، والعمل بمقتضاها، فالدين عقيدة وشريعة،ولا تتم النجاة في الآخرة إلا بالإتيان بهما معًا . والسؤال الذي يطرح نفسه : ماهي الآلية التي نحتاجها كأفراد وتحتاجها الأمة عامةً للعمل بمقتضاه؟؟؟؟؟ الجواب الآلية المطلوبة منا هي أن تكون جميع أعمالنا خالصة لله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أوامر الله نصب أعيينا ، ماذا يريد الله منَّا في هذه اللحظة ؟! وفي كل الأ حوال نؤثر رضا الله ومراده على مرادنا ومراد أحبابنا وهذا لا يتأتى في الغالب إلا في وسط بيئة إيمانيه مع صحبة يشاطرونك نفس المقصد ويعينونك عليه!!! قال تعالى "فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ " النور36 "رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ " النور37 "فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ " إشارة إلى المكان المناسب . "وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا"إشارة للأعمال الصالحه . "رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ" إشارة إلى الرفقة الصالحه اللهم ارزقنا الرفقة الصالحة سبق ونوهنا بقول ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: إفراد الله بالعبادة فلا يعبد معه غيره، ما هي العبادة المقبولة؟ - تعريف العبادة : *قال ابن سيده: أصل العبادة في اللغة : التذلل، من قولهم - طريق معبد - أي مذلل ، ومنه أخذ " العبد " لذلته لمولاه .*وقال الجوهري: أصل العبودية : الخضوع والذل ، والعبادة الطاعة تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين /ص: 38 العبادة في الاصطلاح : عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين /ص: 38 *شروط العبادة وأصولها حقيقة عبادة الله تعالى وأصلها : كمال المحبة له مع كمال الذل والخضوع .فمن يحب مَن لايخضع له ، فليس عابدًا له ، وكذلك من يخضع ويذل لمن لايحبه فليس عابدًا له .وعبادة الله تعالى لاتكون مقبولة ولا مرضية له جل وعلا حتى تستكمل شروطها وأركانها. تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين /ص: 42 *شروط العبادة * العمل لا يقبل إلا بشرطين :الشرط الأول: الإخلاص: وهو : أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون سواه . قال تعالى : " وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " سورة البينة / آية : 5 هنا الشرط الثاني: موافقة شرع الله .أي "خالصًا وصوابًا" وهذا جاء في قوله تعالى "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ "سورة البقرة : 111 ، 112 قوله " مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ " هذا هو الإخلاص، الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر. وقوله " وَهُوَ مُحْسِنٌ" هذا هو الشرط الثاني، فالإحسان هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة الصحيحة *وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى"فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" قال: "فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا" أي: ما كان موافقًا لشرع الله، "وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" وهو الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبَّل، لا بدَّ أن يكون خالصاً لله صوابًا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". مقتبس من كتاب:الحث على اتِّباع السنَّة والتحذير من البدع وبيان خطرها للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " .قالوا : يا رسول الله ومن يأبى . قال :"من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " . صحيح البخاري / ( 96 ) ـ كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة /باب ( 2 ) / حديث رقم : 7280 /ص : 845 . - عن عبدِ اللهِ قالَ " لعنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُتَوشِّماتِ ، والمُتَنَمِّصَات والمُتَفَلِّجَاتِ للحسْنِ ، المُغِّيراتِ خلقَ اللهِ " . فبلغَ ذلكَ امرأةً من بني أسدٍ يُقالُ لها أمُّ يعقوبَ ، فجاءَت فقالتْ : إنَّهُ بلغَني أنكَ لعَنْتَ كيْتَ وكيْتَ ، فقالَ : وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومَنْ هوَ في كتابِ اللهِ ، فقالت : لقدْ قرأتُ ما بينَ اللوحينِ ، فمَا وجدْتُ فيهِ ما تقولُ ، قالَ : لئن كنتِ قرَأتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ ، أما قرأتِ " مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " . قالتْ : بلى ، قالَ : فإنَّهُ قدْ نهَى عنهُ ، قالت : فإنِّي أرَى أهْلَكَ يفعَلونَهُ ، قالَ : فاذْهَبي فانْظُرِي ، فَذَهَبتْ فَنَظَرتْ ، فلمْ تَرَ من حاجَتِها شيئًا ، فقالَ : لو كانَتْ كذَلِك مَا جَامَعَتْنا . الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4886- خلاصة حكم المحدث: صحيح.الدرر السنية *- لقِيني أبو بكرٍ فقال : كيف أنت ؟ يا حنظلةُ ! قال قلت : نافق حنظلةُ . قال : سبحان اللهِ ! ما تقول ؟ قال قلتُ : نكون عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . يُذكِّرنا بالنار والجنةِ . حتى كأنا رأيَ عَينٍ . فإذا خرجنا من عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والضَّيعاتِ . فنسِينا كثيرًا . قال أبو بكرٍ : فواللهِ ! إنا لنلقى مثل هذا . فانطلقتُ أنا وأبو بكرٍ ، حتى دخلْنا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . قلتُ : نافق حنظلةُ . يا رسولَ اللهِ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ " وما ذاك ؟ " قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! نكون عندك . تُذكِّرُنا بالنارِ والجنةِ . حتى كأنا رأىُ عَينٍ . فإذا خرجْنا من عندِك ، عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والضَّيعاتِ . نسينا كثيرًا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ " والذي نفسي بيده ! إن لو تدومون على ما تكونون عندي ، وفي الذِّكر ، لصافحتْكم الملائكةُ على فُرشِكم وفي طرقِكم . ولكن ، يا حنظلةُ ! ساعةٌ وساعةٌ " ثلاثَ مراتٍ . الراوي: حنظلة بن حذيم الحنفي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2750- خلاصة حكم المحدث: صحيحالدرر السنية ومما يبين عقوبة من خالف أمر الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحديث الآتي : * قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا زيد بن الْحُبابِ ،عن عِكرمة بن عمار ، قال حدثني إياسُ بنُ سلمة بن الأكوع ؛ أن أباه حدثهُ ؛ أن رجلاً أكل عند رسول الله ـ رضي الله عنه ـ بشماله ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" كل بيمينك " . قال : " لا أستطيع " . قال " لا استطعت " . ما منعه إلا الكِبرُ .قال : فما رفعها إلى فيه . صحيح مسلم / ( 36 ) ـ كتاب : الأشربة / ( 13 ) ـ باب : آداب الطعام والشراب وأحكامها / حديث رقم : 2021 / ص : 528 فهذه عقوبة عاجلة ـ والعياذ بالله ـ فهذا دليل على أن من خالف سنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تكبرًا أنه مُعَرَّض للعقوبة والعياذ بالله . وعلى النقيض الحديث الآتي : * عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل . فنزعه فطرحه وقال : "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده "فقيل للرجل ، بعد ما ذهب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خذ خاتمك انتفع به، قال : لا .والله ! لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . صحيح مسلم / ( 37 ) ـ كتاب : اللباس والزينة / باب : ( 11 ) /حديث رقم : 2090 / ص : 547 . قال البخاري في صحيحه حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ،قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِيأَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" صحيح البخاري - كِتَاب الصُّلْحِ - لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام موقع الإسلام فمهما حسنت نية الإنسان وقصده إذا كان يعمل عملاً لم يشرعه الرسول ، فهو بدعة ومردود عليه ولا يقبل مه شيء، وهذا هو معنى شهادة أن إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: متابعته والاقتداء به وترك ما نهى عنه وتصديقه. أصل المعلومة مستخلصة من كتاب أهمية التوحيد للشيخ الفوزان |
|
#2
|
||||
|
||||
|
قال علامة الهند الإمام المحدث صديق حسن الحسيني
" لاخلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله" وبناءًا على هذا الشرط ، فمن أدى العبادة ونوى بها غير وجه الله ،كأن يريد مدح الناس ، أو يريد مصلحة دنيوية ، أو فعلها تقليدًا لغيره دون أن يقصد بعمله وجه الله ، أو أراد بعبادته التقرب إلى أحد من الخلق، أو فعلها خوفًا من السلطان أو من غيره،فلا تقبل منه ،ولا يثاب عليها،وهذا مجمع عليه بين أهل العلم . وإن قصد بالعبادة وجه الله وخالط نيته رياء حبط عمله أيضًا تسهيل العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين /ص: 42 فالعبادة حتى تكون مقبولة لها شرطان : 1 ـ الإخلاص : وذلك بألا يراد بها إلا وجه الله تعالى وهذا لا يتأتى إلا بدراسة التوحيد . 2 ـ صوابًا : أي : المتابعة : وذلك بأن تكون العبادة على الكتاب والسنة الصحيحة . وهذا يتأتى بتعلم العلم الشرعي بمقاصده الشرعية الصحيحة ، بأن يراد من تعلم العلم أن يكون وقودًا للإيمان فيزيده ، وأن يكون على المنهج الصحيح وذلك باتباع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ . · والسلف الصالح خير من حقق الاتباع . فقد كان العرب شتيتًا متناثرًا لا يأتلف ولا يتجمع رغم وجود كل عوامل التجمع ، من وحدة الأرض ، ووحدة البيئة ، ووحدة اللغة ، ووحدة المعتقدات ، ووحدة الثقافة ، ووحدة التاريخ .. ومن هناك التقطهم الإسلام فأخرج منهم " خير أمة أخرجت للناس ".كان العرب شتيتًا متناثرًا لا يأتلف ولا يتجمع رغم وجود كل عوامل التجمع ، من وحدة الأرض ، ووحدة البيئة ، ووحدة اللغة ، ووحدة المعتقدات ، ووحدة الثقافة ، ووحدة التاريخ .. ومن هناك التقطهم الإسلام فأخرج منهم " خير أمة أخرجت للناس ". لم تكن الأصنام وحدها هي الأرباب المعبودة في الجزيرة العربية كما تلح بعض كتب التاريخ التي تحصر قضية لا إله إلا الله في إزالة ذلك اللون الحسّي الغليظ من الشرك ، ولا كان الفساد مقصورًا على تلك المفاسد الخلقية من الخمر والميسر والزنا ووأد البنات وغارات السلب والنهب والمظالم الاجتماعية كما تلح كتب أخرى من كتب التاريخ! لقد كانت لا إله إلا الله تستخلص النفوس من الشرك كافة ، ولم يكن الشرك لونًا واحدًا وإنما ألوانًا متعددة تندرج في النهاية تحت هاتين القضيتين الرئيسيتين : تعدد الآلهة واتباع غير ما أنزل الله .. كانت القبيلة ربًا معبودًا ، كما يقول الشاعر: وهل أنا من غُزَيَّة ، إن غوت غويت ، وإن ترشد غُزَيَّة أرشد! وكان عرف الآباء والأجداد ربًا معبودًا، قال تعالى "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا "سورة لقمان 21. وكان الهوى والشهوات أربابًا معبودة: ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟! وكانت قريش وغيرها من القبائل الكبيرة أربابًا تحرِّم للعرب ما تشاء وتحل ما تشاء ، كما كان كهنة الأصنام" إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ "سورة التوبة : 37 . " وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ " سورة الأنعام : 136 - 140. ومن كل هذه الألوان من الشرك - إلى جانب عبادة الأصنام - وعلى درجة واحدة من الأهمية ، كان القرآن يدعو - بلا إله إلا الله - لتخليص النفوس والقلوب ، والمشاعر والسلوك. وكان جهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة موجهًا إليها جميعًا. ولئن كانت قضية البعث والحساب قد شغلت حيزًا كبيرًا من خطاب القرآن للمشركين في مكة ، فإن الله يعلم - سبحانه - ما للإيمان باليوم الآخر من أثر في اقتلاع الشرك بجميع أنواعه وجميع آثاره من القلوب ، ذلك أنهم إن لم يؤمنوا الإيمان القاطع أنهم سيبعثون بعد الموت ، ويحاسبون على شركهم ، فلن يَدَعُوا ذلك الشرك ولن يقلعوا عنه ، سواء كان شرك العبادة أو شرك الاتباع .. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
لم يكن الشرك لونًا واحدًا وإنما ألوانًا متعددة تندرج في النهاية تحت هاتين القضيتين الرئيسيتين : تعدد الآلهة واتباع غير ما أنزل الله ..
كانت القبيلة ربًا معبودًا ،وكان عرف الآباء والأجداد ربًا معبودًا،وكان الهوى والشهوات أربابًا معبودة،من كل هذه الألوان من الشرك - إلى جانب عبادة الأصنام - وعلى درجة واحدة من الأهمية ، كان القرآن يدعو - بلا إله إلا الله - لتخليص النفوس والقلوب ، والمشاعر والسلوك. وكان جهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة موجهًا إليها جميعًا .ولئن كانت قضية البعث والحساب قد شغلت حيزًا كبيرًا من خطاب القرآن للمشركين في مكة ، فإن الله يعلم - سبحانه - ما للإيمان باليوم الآخر من أثر في اقتلاع الشرك بجميع أنواعه وجميع آثاره من القلوب ، ذلك أنهم إن لم يؤمنوا الإيمان القاطع أنهم سيبعثون بعد الموت ، ويحاسبون على شركهم ، فلن يَدَعُوا ذلك الشرك ولن يقلعوا عنه ، سواء كان شرك العبادة أو شرك الاتباع. ـ فحين خَلُصَت نفوس المؤمنين بـ " لا إله إلا الله " من ألوان الشرك المختلفة ، فقد حدث في نفوسهم تحول هائل ... كأنه ميلاد جديد . لم يكن مجرد التصديق ، ولا مجرد الإقرار ، لقد كان كأنه إعادة ترتيب ذرات نفوسهم على وضع جديد ، كما يعاد ترتيب الذرات في قطعة الحديد ، فتتحول إلى طاقة مغناطيسية كهربائية ... كان الاهتداء إلى " الحق " هائل الأثر في كل جوانب حياتهم . لقد صارت " لا إله إلا الله " هي مفتاح التجمع والافتراق ، هي الرباط الذي يربط القلوب التي آمنت بها ، ويفصل بينها وبين غيرها من القلوب . ـ ولم ينحصر مفهوم " لا إله إلا الله " في حسهم في نطاق الشعائر التعبدية وحدها ، كما انحصر في حس الأجيال المتأخرة التي جاءت بفهم للإسلام غريب عن الإسلام . إن شعائر التعبد لا يمكن بداهةً أن تكون هي كل " العبادة " المطلوبة من الإنسان . فما دامت غاية الوجود الإنساني كما تنص الآية الكريمة ، محصورة في عبادة الله .قال تعالى"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " سورة الذاريات / آية : 56 . فأنى يستطيع الإنسان أن يوفي العبادة المطلوبة بالشعائر التعبدية فحسب ؟ كم تستغرق الشعائر من اليوم والليلة ؟ وكم تستغرق من عمرالإنسان ؟ وبقية العمر؟ وبقية الطاقة ؟ وبقية الوقت ؟ أين تُنفَق ، وأين تذهب ؟ ـ كان في حسهم أن حياتهم كلها عبادة ، وأن الشعائر إنما هي لحظات مركزة ، يتزود الإنسان فيها بالطاقة الروحية التي تعينه على أداء بقية العبادة المطلوبة منه . كانوا يقومون بالعبادة وهم يمارسون الحياة في شتَّى مجالاتها ، كانوا يذكرون الله فيسألون أنفسهم : هل هم في الموضع الذي يُرضي الله ، أم فيما يُسخط الله ؟ ! فإن كانوا في موضع الرضى حمدوا الله ، وإن كانوا على غير ذلك استغفروا الله وتابوا إليه . ـ وكانوا يذكرون الله ، فيسألون أنفسهم : ماذا يريد الله منا في هذه اللحظة ؟ ! أي : ما التكليف المفروض علينا في هذه اللحظة ؟ ! - إذا كان التكليف " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ".سورة النساء / آية : 19 .كان ذكر الله مؤديًا إلى القيام بهذا الواجب الذي أمر به الله تجاه الزوجات . - وإذا كان التكليف" قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا " .سورة التحريم / آية : 6 . كان ذكر الله مؤديًا إلى القيام بتربية الأهل والأولاد على النهج الرباني الذي يضبط سلوكهم بالضوابط الشرعية . - وإذا كان التكليف " فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " .سورة الملك / آية : 15 . كان مقتضى ذكر الله ، هو المشي في مناكب الأرض وابتغاء رزق الله في حدود الحلال الذي أحلَّهُ الله ، لأنه إليه النشور فيحاسب الناس على ما اجترحوا في الحياة الدنيا . وهكذا ... فقد فهموا أن الصلاةَ والنُّسُك " أى : الشعائر " إنما هي المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان ليقوم ببقية العبادة التي تشمل الحياة كلها ، بل الموت كذلك . فالشعائر مجرد محطات شحن للانطلاق إلى بقية العبادة ، ويشمل ذلك الموت. الموت في حد ذاته لا يمكن أن يكون عبادة بطبيعة الحال ، لأنه لا خيار للإنسان فيه ، ولكن المقصود في قوله تعالى " وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ ".سورة الأنعام / آية : 162 ، 163 . هو أن يموت الإنسان غيـر مشرك بالله ، وذلك هو الحد الأدنى الذي يكون به الإنسان ( في موته ) عابدًا لله ، أما الحد الأعلى فهو أن يكون موتُه في سبيل الله ، أما اليوم فقد حدثت انحرافات كثيرة في حياة المسلمين ، وانحراف المسلمين في سلوكهم أمر واضح ، تفشَّى في حياتهم الكذب والغش والنفاق ، والضعف والجبن والبدع والمعاصي والتبلُّد والفجور والمنكر... ـ فهذا واقـع المسلمين ومع ذلك فليس الانحراف السلوكي هو الانحراف الوحيد في حياة المسلمين ، ولكن الأمـر تجاوز ذلك إلى الانحراف في " المفاهيم " كل مفاهيم الإسلام الرئيسية ابتداءً من مفهوم " لا إله إلا الله" وحين تجد إنسانًا منحرفًا في سلوكه ،ولكن تصوره لحقيقة الدين صحيح ،فستبذل جهدًا ما لرده عن انحرافه السلوكي ،ولكنك لا تحتاج أن تبذل جهدًا في تصحيح مفاهيمه ، لأنها صحيحة عنده وإن كان سلوكه منحرفًا عنها . أي : أنه حين يقع الانحراف في المفاهيم ذاتها ، فكم تحتاج من الجهد لتصحيح المفاهيم أولاً ثم تصحيح السلوك بعد ذلك . منقول بتصرف ******** عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة :*أصول العبادة* المحبة *والخوف * والرجاء فيعبد المسلم ربه محبة له * وخوفًا من عقابه *ورجاء لثوابه *أصول العبادة* عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة :المحبة والخوف والرجاء،فيعبد المسلم ربه :محبة له وخوفًا من عقابه ورجاءًا لثوابه . من أصول العبادة: أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعًا.وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق،
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. الزنديق : قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وأيضًا لفظ الزندقة لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد في القرآن الكريم وهو لفظ أعجمي مُعَرَّب؛ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام؛ وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك ,, ثم قال - أي شيخ الإسلام - والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن , وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا , وسواء كان معطلاً للصانع وللنبوة أو للنبوة فقط أو لنبوة بنينا صلى الله عليه وآله وسلم فقط فهو زنديق وهو منافق , وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول هذا بإجماع المسلمين هنا حروري: حرورية " مؤنث " حروري " نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة . ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج (حروري) لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة ، فاشتهروا بالنسبة إليها ، وهم فرق كثيرة ، ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ، ولهذا اسنفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في " فتح الباري " المرجئ :المرجئة هم فرقة إسلامية، خالفوا رأي الخوارج وكذلك أهل السنة في مرتكب الكبيرة وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفر, لأن الحكم عليه موكول إلى الله تعالى وحده يوم القيامة, مهما كانت الذنوب التي اقترفها. وهم يستندون في اعتقادهم إلى قوله تعالى "وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". والعقيدة الأساسية عندهم عدم تكفير أي إنسان، أيا كان، ما دام قد اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، مهما ارتكب من المعاصي، تاركين الفصل في أمره إلى الله تعالى وحده، لذلك كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة . هنا عبادة الله عز وجل عند كل عابد لله عز وجل لا بد أن تقوم في قلبه على ثلاثة أسس وأركان موجودة جميعًا وفي آثار أعماله القلبية على جوارحه، وعلى لسانه وأعماله، وهذه الأركان الثلاثة هي: من أصول العبادةالمحبة المحبة، ومعناها أن محبة التعظيم والتقديس لا تكون إلا لله عز وجل، فالواجب على العباد أن يحبوا الله سبحانه، وتمتلئ قلوبهم بمحبة الله تعظيماً وإجلالاً وتقديسًا وتأليهًا وانجذابًا إلى الله عز وجل، وأن يكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء، محبة التقديس والتعظيم والكمال.ثم لا بد بعد ذلك من الركنين الأساسيين، وهما: الرجاء من جانب والخوف من جانب آخر، وهما لا يفترقان، بل لا بد أن تعلق كل منهما بالمحبة؛ ولذلك شبه بعض أهل العلم العبادة بالطير، فالمحبة رأسه، والرجاء جناحه الأيمن، والخوف جناحه الأيسر، ولا يمكن أن يطير الطير إلا بهذه الكيانات الثلاث، فعلى هذا لا بد أن يتعلق قلب المسلم برجاء الله، وأن يكون راجياً لله عز وجل، لا يتطرق إليه اليأس، والرجاء لا بد أن تقترن به الأسباب. وكذلك الخوف لا بد أن يكون الإنسان خائفاً من الله، فيجمع بين المحبة والرجاء والخوف، ويوازن بينها، فلا يطغى جانب على جانب، وعلى هذا فإن من لوازم المحبة والرجاء والخوف العمل بشرع الله عز وجل؛ لأن مسألة المحبة إذا لم ينبثق عنها رجاء وخوف ثم عمل؛ تصبح مجرد دعوى، والله عز وجل قال على لسان نبيه: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ "آل عمران:31، "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا"الأحزاب:36 فلا بد من الاتباع، والاتباع يجمع بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء والعمل بالأحكام. فالمسلم لا بد أن يجمع بين هذه الأصول الثلاثة: أن يكون محبًا لله، ثم راجيًا لثواب الله، ويعمل بالأسباب، وخائفًا من عقاب الله ويدرأ هذا العقاب باجتناب النواهي، فيعمل بالأوامر رجاء فضل الله، وينتهي عن النواهي خوفًا من الله، ومع ذلك كله لا بد أن يحب الله، وأن يعظم الله في المحبة، وأن يحب ما يحبه الله، ويحب من يحبهم الله. وهذه الأمور إذا ضعف فيها جانب اختل الإيمان، وإذا فقد جانب فقد يفقد الإيمان كله، فالنقص في هذه الأصول الثلاثة أو في أحدها نقص في الإيمان، مع أنه يلزم من وجود بعضها وجود البعض الآخر، بمعنى أن من اكتملت محبته لله؛ اكتمل رجاؤه وخوفه، والعكس كذلك؛ ولذلك فإن من نقص أو اختل عنده أصل من هذه الأصول نقص إيمانه واختل إيمانه، وقد يفقد الإيمان بالكلية. وقوله"من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق"، معنى ذلك: أنه يوجد من المتفلسفة وبعض المتعبدة الجهال الذين ينتسبون للإسلام، من يزعم أنه يكفيهم التعلق القلبي بالله، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يستغني عن العمل بالشرع، ولا يعول على الرجاء ولا على الخوف، ويزعم أنه بالمحبة حقق كمال العبادة وكمال المطلوب، وهذا خلاف قطعيات النصوص، والله عز وجل طلب من عباده أن يرجوه ويخافوه، وجعل ذلك هو أصل الدين والعبادة. وأيضًا قد يترتب على هذه النزعة الاستهانة بشرع الله، فالذين زعموا أنهم يعبدون الله بالمحبة وتعلق القلوب بالله بالتقديس فحسب، سواء كان هذا عن طريق التفكر، أو عن طريق الرياضة القلبية أو الرياضة العقلية، أو تحت أي شعار من الشعارات التي عليها عباد الأمم وكثير من الفلاسفة؛ كل ذلك ضلال، مهما كانت المسالك المؤدية إليه؛ لأنه لا يمكن أن تكتمل المحبة إلا بتعلق القلب برجاء الله والعمل بأسباب الرجاء، وتعلق القلب بالخوف من الله والعمل بأسباب ذلك. فعلى هذا فإن من عبد الله بالحب وحده تزندق، لأنه وقع في الاستهتار في الدين، وأقرب عبارة في عصرنا لمفهوم التزندق: الاستهتار، وهو اللامبالاة، لا يعمل بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي، ويزعم أنه وصل إلى درجة فوق مستوى أن يلتزم الشرع. وهناك مقولة خطيرة قال بها بعض العباد، ومن خلالها انغرست هذه المناهج الباطلة عند بعض الطرق الصوفية، وهي قول القائل: اللهم إني لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفًا من نارك، ونحن نعبد الله رجاءً وخوفًا، نعبد الله محبة له سبحانه، لكن نجمع مع ذلك رجاء الثواب والنعيم، وعلى رأس الثواب الجنة كما يلزم من محبتنا لله عز وجل الخوف من ناره ومن عقابه، نسأل الله أن يعيذنا من النار؛ فعلى هذا لا بد للمسلم أن يجمع بين هذه الأصول. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
2- من أصول العبادة الخوف منزلة الخوف الخوف عبادة من أجل العبادات، بل هو أصل التقوى،وإنما سمِّي المتقي متقيًا لأنه يجعل بينه وبين ما يخاف وقاية؛ فالحامل على التقوى في الأصل هو الخوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله هنا وقد أمر الله تعالى بإفراده بالخوف وتعظيم مقامه جلَّ وعلا فقال تعالى:" إنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوِّفُ أوْلِيَآءَهُ فَلاَ تَخَافُـوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" هنا من أنواع العبادة الخوف من الله: وقد أمر الله تعالى بإفراده بالخوف وتعظيم مقامه جلَّ وعلا فقال تعالى" إنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوِّفُ أوْلِيَآءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"، وَقَالَ سُبْحَانَهُ "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ"الرَّحْمَنِ: 46، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ" وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ"وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ"الْإِسْرَاءِ: 57، وَقَالَ تبارك اسمه"أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ"الزُّمَرِ: 9، الْآيَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْآيَاتِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. *وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَا أَدْرِي، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ» "طار لنا عُثمانُ بنُ مَظعونٍ في السُّكنى، حين اقتَرَعَتِ الأنصارُ على سُكنى المهاجرينَ، فاشتَكى فمرَّضْناه حتى تُوُفِّيَ، ثم جعَلْناه في أثوابِه، فدخَل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ : رحمةُ اللهِ عليك أبا السائِبِ، فشَهادَتي عليك لقد أكرَمَك اللهُ، قال " وما يُدريكِ " . قلتُ : لا أدري واللهِ، قال " أمَّا هو فقد جاءَه اليقينُ، إني لأرجو له الخيرَ منَ اللهِ، واللهِ ما أدري - وأنا رسولُ اللهِ - ما يُفعَلُ بي ولا بِكم " . قالتْ أمُّ العَلاءِ : فواللهِ لا أُزَكِّي أحدًا بعدَه، قالتْ : ورَأَيتُ لعُثمانَ في النومِ عينًا تَجري، فجئتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتُ ذلك له، فقال " ذاك عمَلُه يَجري له " . الراوي: أم العلاء عمة حزام بن حكيم الأنصاري- المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7018-خلاصة حكم المحدث:صحيح.الدرر * الدرر السنية وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا» "ما رأيتُ مثلَ النَّارِ نامَ هاربُها ، ولا مثلَ الجنَّةِ نامَ طالبُها " الراوي: أبو هريرة- المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2601 - خلاصة حكم المحدث: حسن الدرر السنية وَفِيهِ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ. أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ». "من خافَ أدلَجَ ، ومن أدلَجَ بلغَ المنزلَ ، ألا إنَّ سلعةَ اللَّهِ غاليةٌ ، ألا إنَّ سلعةَ اللَّهِ الجنَّةُ" الراوي: أبو هريرة-المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2450 -خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن هذِهِ الآيةِ" وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ" قالت عائشةُ : أَهُمُ الَّذينَ يشربونَ الخمرَ ويسرِقونَ قالَ:" لا يا بنتَ الصِّدِّيقِ ، ولَكِنَّهمُ الَّذينَ يصومونَ ويصلُّونَ ويتصدَّقونَ ، وَهُم يخافونَ أن لا تُقبَلَ منهُم أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ" الراوي: عائشة أم المؤمنين- المحدث: - الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3175 - خلاصة حكم المحدث: صحيح - الدرر السنية "شيبتني هودٌ وأخوَاتُها قبل المشيبِ" الراوي: أبو بكر الصديق المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3721 خلاصة حكم المحدث: صحيح-الدرر السنية - قالَ أبو بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يا رسولَ اللَّهِ قد شِبتَ، قالَ"شيَّبتني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتَسَاءَلُونَ، وإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ"الراوي:عبدالله بن عباس-المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3297 - خلاصة حكم المحدث:صحيح- الدرر السنية هنا بتصرف في الأحاديث وتخريجها وهو ثلاثة أقسام: الأول: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله: من وثن، أو طاغوت، أو ميت، أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره؛ كما قال الله عن قوم هود -عليه السلام- أنهم قالوا له" إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِي ". هود: 54-55. وقد خوَّف المشركون رسول الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- من أوثانهم؛ كما قال تعالى" وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ". الزمر: 36. وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان؛ يخافونها، ويُخوِّفونَ بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها، وأمروا بإخلاص العبادة لله. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها؛ فمن صرفه لغير الله؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة، يجب إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى "فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " آل عمران: 175. وقال تعالى "فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ " المائدة: 3. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس؛ فهذا محرم، وهو شرك أصغر، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" آل عمران: 173. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك؛ فهذا ليس بمذموم؛ كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام "فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ " القصص: 21. هنا من عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني: من عبده بمجرد الخوف، لا يبالي بالحب ولا بالرجاء؛ ووصل عنده الأمر إلى اليأس من رحمة الله، وهذا منهج غلاة العباد الذين منهم الحرورية، والحروري نسبة إلى حروراء التي لجأ إليها الخوارج بعدما فاصلوا علي بن أبي طالب وجماعة المسلمين، ومما تميز به الخوارج: التشديد على النفس بالعبادة؛ لأنهم غلبوا جانب اليأس وجانب الوعيد ولم يبالوا بالوعد؛ ولذلك غلب عليهم التنطع والغلو، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال"تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم"1، وذلك لأنهم يبالغون في الصلاة والصيام إلى أن زادوا عن الحد المشروع، فمن هنا انغرست في قلوبهم نزعة اليأس، ولم يعولوا على الوعد؛ فمن هنا وصف من يعمل ذلك بأنه حروري، وإلا فالذين يسلكون هذا المسلك أوسع من مجرد الحرورية، وهم طوائف عدة من الفلاسفة ومن العباد الأوائل الجهلة، ومن النساك، ومن بعض شيوخ الطرق وأتباعها، فهم ينضوون تحت إطار أكثر فرق المسلمين أحياناً، ويوجد من جهلة المسلمين حتى ممن ينتسب للسنة من قد يغلو ويشتدّ على نفسه وعلى الآخرين فيغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. 1 -" يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر في النصل فلا يرى ً، وينظر في القدح فلا يرى شيئًا ، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا ، ويتمارى في الفوق" الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5058-خلاصة حكم المحدث: صحيح.الدرر السنية قال البخاري في صحيحه : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ" صحيح البخاري / كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ حديث رقم : 6532. هنا |
|
#5
|
||||
|
||||
|
3- من أصول العبادة الرجاء
فالرجاء منزلة عظيمة من منازل العبودية وهي عبادة قلبية تتضمن ذلاً وخضوعًا ، أصلها المعرفة بجود الله وكرمه وعفوه وحلمه ، ولازمها الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاته ، فهو حسن ظن مع عمل وتوبة وندم . الرجاء نقيض اليأس، وهو طمع القلب في حصول منفعة. الرجاء غالباً ما يرد مقروناً بالخوف أو بأحد معانيه "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ".السجدة16 كما ورد في السنة الشريفة: - دخلَ على شابٍّ وَهوَ في الموتِ ، فقالَ : كيفَ تَجدُكَ ؟ قالَ : أرجو اللَّهَ يا رسولَ اللَّهِ وأَخافُ ذنوبي ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يجتَمعانِ في قَلبِ عَبدٍ في مثلِ هذا الموطنِ ، إلَّا أعطاهُ اللَّهُ ما يَرجو ، وآمنَهُ مِمَّا يخافُ" الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3455-خلاصة حكم المحدث:حسنالدرر السنية اسم الرجاء قد يطلق في بعض الأحيان ويُراد به الخوف كما ورد في قوله تعالى : نوح ، 13. "مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا "نوح13 أي :مالكم -أيها القوم- لا تخافون عظمة الله وسلطانه.التفسير الميسر *وجوب رجاء رحمة الله عز وجل فقد وردت في القرآن والسُّنة وأحاديث الصحابة والصالحين ، قال تعالى "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "الزمر53 ، الزمر ، 53 . وقد ذم الله عز وجل اليأس والقنوط من رحمته فقال تعالى "يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ "يوسف 87. بيان معنى القنوط س: ما معنى القنوط من رحمة الله وذلك من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله خيرًا .1 . ج: القنوط من رحمة الله هو اليأس، كونه لا يرجو الله يقنط أن الله يرحمه، هذا من الكبائر من كبائر الذنوب، ربنا جل وعلا نهانا عن هذا، قال جل وعلا"قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" 2 ، وقال تعالى"إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ"3. هذا لا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله، يعني ييأس لكفره، أو لمعاصيه، بل عليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وله البشرى بأن الله يقبل توبته، ويعظم أجره، ويجازى على ما فعل من الخير، أما اليأس والقنوط لأجل سوء العمل فهذا من تزيين الشيطان، ولا يجوز، بل يجب على العبد الحذر من ذلك، وألا يقنط وألا ييأس، بل يرجو رحمة ربه، وأن الله يتوب عليه، يرجو أن الله يقبل عمله ولا ييأس. __________ (1) السؤال الأول من الشريط رقم 379. (2) سورة الزمر الآية 53 (3) سورة يوسف الآية 87 والرجاء على قسمين: القسم الأول: رجاء العبادة. القسم الثاني: رجاء نفع الأسباب. - فرجاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله ، ومن صرفه لغير الله تعالى فهو مشرك لأنه يحمل معاني العبادة من التذلل والخضوع والمحبة والانقياد واعتقاد النفع والضر وتفويض الأمر وتعلق القلب والتقرب إلى المعبود، وهذه كلها عبادات عظيمة تقتضيها عبادة الرجاء فمن صرفها لغير الله  فهو مشرك كافر. فهو مشرك كافر. وهذا كرجاء المشركين في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أنها تشفع لهم عند الله أو أنها تقربهم إلى الله زلفى، وكرجاء بعض عباد الأولياء والقبور بأنهم ينجونهم من الكربات ويدفعون عنهم البلاء ويجلبون لهم النفع ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. - القسم الثاني: رجاء نفع الأسباب مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله  . . وهذا على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: رجاء جائز، وهو رجاء نفع الأسباب المشروعة مع عدم تعلق القلب بها، فهذا جائز، وليس بشرك، وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي قال: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بخيرِكم مِنْ شرِّكم ؟ خيرُكم مَنْ يُرْجَى خيرُهُ ، ويُؤْمَنُ شرُّهُ ، وشرُّكم مَنْ لَا يُرجَى خيرُه ، ولَا يؤمَنُ شرُّهُ الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2603- خلاصة حكم المحدث: صحيحالدرر السنية فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة، وإنما هو رجاء نفع السبب مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله . الدرجة الثانية: رجاء محرم، وهو الرجاء في الأسباب المحرمة ليستعين بها على معصية الله . الدرجة الثالث: شرك أصغر، وهو تعلق القلب بالأسباب؛ كتعلق بعض المرضى بالرقاة والأطباء تعلقاً قلبياً يغفلون معه عن أن الشفاء بيد الله ؛ فهذا من شرك الأسباب وهذه العبادات قاعدتها واحدة من فقهها سهل عليه معرفة هذه التقسيمات وتيسر له ضبط مسائلها إن شاء الله تعالى. هنا * ثمراتُ الرَّجاءِ: 1- يُورثُ طريقَ المجاهدةِ بالأعمالِ.2- يُورثُ المواظبةَ على الطاعاتِ كيفما تقلَّبت الأحوالُ. 3- يُشعرُ العبدَ بالتَّلذُّذِ والمداومةِ على الإقبالِ على اللهِ والتَّنعّمُ بمناجاتهِ والتَّلطفُ في سؤالهِ والإلحاح عليهِ. 4- أنْ تظهرَ العبوديةُ من قبلِ العبدِ، والفاقةِ والحاجةِ للرَّبِّ، وأنه لا يَستغني عن فضلهِ وإحسانهِ طرفةَ عينٍ. 5- التَّخلُّصُ منْ غضبِ الرَّبِّ؛ ذلكَ بأَنَّ اللهَ يحبُّ منْ عبادهِ أنْ يسألوه ويرجوه ويُلحُّوا عليه؛ لأَنَّهُ جَوادٌ كريمٌ، أجودُ من سُئِل؛ ومنْ لا يسألِ اللهَ يغضبُ عليه، والسائلُ عادةً يكونُ راجيًا مطالبَ أن يُعطى؛ فمنْ لم يرج اللهَ يغضب عليه .هنا فمن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، بمعنى: من قال: الله عز وجل غفور رحيم، وسيغفر لنا جميع الذنوب، يترك الفرائض ويعمل المحرمات، ويقول: الله غفور رحيم، هذا مرجئ، المعنى أنه مال إلى مذهب غلاة المرجئة؛هنا ( مجمل أصول أهل السنة - توحيد العبادة ) للشيخ * ناصر بن عبدالكريم العقل * |
|
#6
|
||||
|
||||
|
الجمع بين الخوف والرجاء "إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ" سورة يوسف الآية: 87.ينبغي ألاّ تأمن الله، وألا تيأس منه، إن أمنته تطرفت، وإن يئست من رحمته تطرفت، يجب أن تقع في موقع متوسط بينهما، لا تأمن مكره، ولا تيأس من رحمته، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حافظ منه إلا به، الجمع دقيق فالمؤمن الموفق يجمع في عبادته بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى" أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ "الزمر: 9. قال ابن كثير: قوله" يَحْذرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ". أي: في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا،.......اهـ. وكثيرا ما يقترن بالخوف والرجاء أمر ثالث وهو التذكير بعظمة الله تعالى ونعمه المتكاثرة على عباده، مما يثمر محبة الله تعالى، وبهذا تتحقق عبودية الله، كما في قوله تعالى"غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ "غافر:3. واعلم أنه لا تعارض بين خوف العبد من عدم القبول وبين رجائه في رحمة الله وحسن ظنه به سبحانه، فإن هذا هو حال المؤمنين، يوصفون من جهة بقوله تعالى"وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ"المؤمنون: 60. ومن جهة أخرى بقوله" إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَلِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ "فاطر:29، 30. قال ابن كثير: يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. أي: يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. اهـ. وذلك أن الخوف من عدم القبول لا يعني القطع بذلك، وإنما يعني عدم الركون إلى العمل وعدم القطع بالقبول، وأن يتمحض الاتكال على رحمة الله وفضله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - لن يُنجِّيَ أحدًا منكم عملُه . قالوا : ولا أنت يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ولا أنا ، إلَّا أن يتغمَّدَني اللهُ برحمةٍ ، سدِّدوا وقارِبوا ، واغدوا وروحوا ، وشيءٌ من الدُّلجةِ ، والقصدَ القصدَ تبلُغوا الراوي: أبو هريرة- المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6463- خلاصة حكم المحدث:[صحيح] الدرر السنية وفي حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: - " لَن يُدخِلَ أحدًا منكُم عملُهُ الجنَّةَ قالوا : ولا أنتَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ ! قالَ : ولا أنا . إلَّا أن يتغمَّدَنيَ اللَّهُ منهُ بفضلٍ ورحمةٍ " الراوي:أبو هريرة- المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2816 - خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية هنا أيهما نغلب الخوف أم الرجاء؟ هذا الباب قد اختلف فيه العلماء هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف ؟ .
فمنهم من قال : يغلب جانب الرجاء مطلقاً ، ومنهم من قال : يغلب جانب الخوف مطلقاً . _ومنهم من قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء ، لا يغلب هذا على هذا ، ولا هذا على هذا ؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء ؛ أمن مكر الله ، وإن غلب جانب الخوف ؛ يئس من رحمة الله . وقال بعضهم : في حال الصحة يجعل رجاءَه وخوفه واحداً كما اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب ، وفي حال المرض يغلب الرجاء أو يمحضه . وقال بعض العلماء أيضًا : إذا كان في طاعة ؛ فليغلب الرجاء ، وأن الله يقبل منه ، وإذا كان فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لئلا يقدم على المعصية . والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه ، إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله ، وأنه مقيم على معصية الله ، ومتمنٍ على الله .الأماني ، فليعدل عن هذه الطريق ، وليسلك طريق الخوف . وإذا رأى أن فيه وسوسة ، وأنه يخاف بلا موجب ؛ فليعدل عن هذا الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه . وتأمل قوله تعالى " اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ "المائدة: 98 ، 99 ؛ حيث إنه في مقام التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " . وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال" نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ "الحجر: 49 ، 50 ؛ فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب ؛ لأنه يتحدث عن نفسه عز وجل ، وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه . ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على الإنسان أن يجمع بين الخوف الرجاء ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : - "لو يعلم المؤمنُ ما عند اللهِ من العقوبةِ ، ما طمع بجنتِه أحدٌ . ولو يعلمُ الكافرُ ما عند اللهِ من الرحمةِ ، ما قنط من جنتِه أحدٌ" والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر ؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال ، لكن حقيقة هذا لا تدرك الآن ، لا يدركها إلا من رقع في ذلك ـ أعاذنا الله وإياكم من عذابه . الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2755- خلاصة حكم المحدث:صحيح هنا "ولو يعلمُ الكافرُ ما عند اللهِ من الرحمةِ ، ما قنط من جنتِه أحدٌ" ، والمراد حقيقة ذلك ، وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم ، ويعلم معنى المغفرة ، ويعلم معنى الرحمة . وذكرت أحاديث في معنى ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك" الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6488- خلاصة حكم المحدث: صحيح. الدرر السنية. شراك النعل يضرب به المثل في القرب ؛ لأن الإنسان لابس نعله ، فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله ؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة واحدة ، والنار مثل ذلك ، ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل ، مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره ، فلما تعب قال : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله تعالى :- أنَّ رجلًا قال : واللهِ ! لا يغفِرُ اللهُ لفلانٍ . وإنَّ اللهَ تعالَى قال : "من ذا الَّذي يتألَّى عليَّ أن أغفرَ لفلانٍ . فإنِّي قد غفرتُ لفلانٍ? وأحبطتُ عملَك" . أو كما قال . الراوي: جندب بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2621- خلاصة حكم المحدث: صحيح الدرر السنية قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب كونه الخوف أو الرجاء ، إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى انتهاك المحرمات استناداً إلى مغفرة الله ورحمته ؛ فليعدل عن هذا الطريق ، وإن رأى أن عنده وسواسًا ، وأن الله لا يقبل منه ؛ فإنه يعدل عنه هذا الطريق . هن *أيما أفضل الخوف أو الرجاء؟ اعلم أن قول القائل: أيما أفضل الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه: أن يقال الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب، فإن استويا، فهما متساويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله، فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط، فالرجاء أفضل، ويجوز أن يقال مطلقًا: الخوف أفضل، كما يقال: الخبز أفضل من السكنجبين لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء، ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يُسقى من بحر الرحمة, والخوف يُسقى من بحر الغضب. وأما المتقي، فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاً واحدًا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلاً واحدًا، لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصًا بالمؤمن المتقي. فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن، وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، فمثله من بذر بذراً ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، والبذر الإيمان، وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب، وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخبايا الأخلاق غامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن؟ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه، ويستتر عيبه عنه، فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل، ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا، وأما عند نزول الموت، فالأصلح للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل، وليس ثمة عمل، فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه، والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه، ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محباً لله تعالى، محبًا للقائه، حسن الظن به، وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص، لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. انتهى هنا |
|
#7
|
||||
|
||||
|
المجلس العاشر تحقيق عبارة كله خير هل كل عمل ظاهره الخير يقبله الله ويرفعه؟ قال تعالى "مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ " فاطر : 10. ما هو العمل الصالح الذي يقبله ويرفعه سبحانه سبق ونوهنا على شروط العمل الصالح أن يكون "خالصًا وصوابًا" الشرط الأول: الإخلاص: وهو : أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون سواه . قال تعالى : " وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ " سورة البينة / آية : 5 الشرط الثاني: موافقة شرع الله .-صوابًا-. وهذا جاء في قوله تعالى "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ " سورة البقرة : 111 ، 112 قوله " مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ " هذا هو الإخلاص، الإخلاص في العمل بحيث لا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر. وقوله " وَهُوَ مُحْسِنٌ" هذا هو الشرط الثاني، فالإحسان هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم *لكن ما الضوابط العملية والقواعد، التي تعيننا على تطبيق وتحقيق شروط العمل الصالح نعيش مع حديث ماتع لإبراز مقصدنا ثم نثني بقاعدة جليلة ـ فعن عمر بن سلمة الهَمْدَاني ـ رحمه الله ـ قال : " كنا نجلس على باب " عبد الله بن مسعود " قبل صلاة الغداةِ ، فإذا خرج مَشَيْنا معه إلى المسجد . فجاءنا " أبو موسى الأشعري " ، فقال : أَخَرَجَ إليكم " أبو عبد الرحمن " بعد ؟ . قلنا : لا . فجلس معنا حتى خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعًا . فقال له أبو موسى : يا " أبا عبد الرحمن " إني رأيتُ في المسجد آنفًا أمْرًا أنكرته ! ولم أرَ والحمد لله إلا خيرًا . قال : فما هو ؟ فقال " أي أ بي موسى ": إن عشت فستراه . قال أبو موسى : رأيت في المسجد قوْمًا حِلَقًا ، جلوسًا ، ينتظرون الصلاة ، في كل حلْقة رجل ، وفي أيديهم حصى فيقول : سبَّحوا مائة ، فيسبحون مائةً . قال ـ أي : عبد الله بن مسعود " أبو عبد الرحمن " ـ : فماذا قلتَ لهم ؟ قال - أي : أبى موسى الأشعري - : ما قلتُ لهم شيئًا انتظارَ رأيك . قال - ابن مسعود - : أفلا أمرتَهم أن يَعدوا سيئاتهم وضَمِنتَ لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟ ! ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حَلْقةً من تلك الحِلَق ، فوقف عليهم فقال : ما هذا الذى أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، حصى نَعُدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فَعُدوا سيئاتكم ، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ، ويْحَكُم يا أمة محمد ! ما أ َسْرعَ هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ متوافرون وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أو مفتتحوا باب ضلالة ؟ ! ! ! قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ، ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ، إن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ حدثنا : " إن قومًا يقرؤون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرقُ السهم من الرمية " . " وايم الله " (1) ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم! ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة : فرأينا عامة أولئك الحِلَق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج . أخرجه الدارمي . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة / مجلد رقم :5 /حديث رقم : 5002 . قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ : وإنا عُنيتُ بتخريجه من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات ، فإن فيها عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خلاف السنة ، فإن هؤلاء إذا أنكرعليهم منكر ما هم فيه ، اتهموه بإنكار الذكر من أصله ! وهذا كفر لا يقع فيه مسلم ، وإنما المنكَر ما أُلصِق به من الهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، وإلا فما الذي أنكره ابنُ مسعود ـ رضي الله عنه ـ على أصحاب تلك الحلقات ؟ ! ليس هو إلا التجمع في يوم معين ، والذكر بعدد لم يرد ، وإنما يحصره الشيخ صاحب الحَلْقة ، ويأمرهم به من عند نفسه ، وكأنه مُشرِّع عن الله تعالى . قال تعالى" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ ... ".سورة الشورى / آية : 21 . ـ زد على ذلك أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلاً وقولاً إنما هي التسبيح بالأنامل . * ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث ، أن العبرة ليست بكثرة العبادة ، وإنما بكونها على السنة ، بعيدة عن البدعة وقد أشار إلى هذا - ابن مسعود - بقوله : " اقتصاد في سنة ، خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة " . * ومن الفوائد أن البدعة الصغيرة بريدٌ إلى البدعة الكبيرة ، ألا ترى أن أصحاب الحلقات صاروا بعدُ مِنَ الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد " علي بن أبى طالب " ؟ فهل من مُعْتَبِر ؟ نظم الفرائد / ج : 1 / ص : 211 . * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " . قالوا : يا رسول الله ومن يأبى . قال : " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " . صحيح البخاري / ( 96 ) ـ كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة /باب ( 2 ) / حديث رقم : 7280 /ص : 845 . * عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجـل . فنزعه فطرحه وقال "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده "فقيل للرجل ، بعد ما ذهب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خذ خاتمك انتفع به،قال : لا .والله ! لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . صحيح مسلم / ( 37 ) ـ كتاب : اللباس والزينة / باب : ( 11 ) /حديث رقم : 2090 / ص : 547 . *** حرص السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم على حديث رسول الله الله صلى الله عليه و سلم و اجتهادهم في ألا يفوتهم شيء منه ** فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار ، في بني أمية بن زيد ، وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينزل يومًا وأنزل يومًا ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك ،فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ، فضرب بابي ضربًا شديدًا ، فقال : أثم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه ، فقال : قد حدث أمر عظيم . قال : فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي ، فقلت : طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت :لا أدري ،ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ قال : "لا ". فقلت :الله أكبر ". صحيح البخاري / 3- كتاب العلم / 27- باب التناوب في العلم /حديث رقم : 89 / ص: 22 ./ طبعة دار ابن الهيثم . ***ولم يكن اهتمام النساء وحرصهن على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم بأقلَّ من اهتمام الرجال،فقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه و سلم "غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهنَّ فيه، فوعظهن وأمرهن" صحيح البخاري / 3- كتاب العلم / 35- باب هل يجعل للنساء يوم على حِدة في العلم /حديث رقم : 101 / ص: 23./ طبعة دار ابن الهيثم . متون فقط _ولم يقتصر هذا الاهتمام والحرص ،على زمن الرسول فحسب، بل استمرالحال بعد انتقاله صلى الله عليه و سلم إلى الرفيق الأعلى و هذا الحرص نابع من تربية إيمانية صحيحة مبنية على إخلاص العمل وصوابه أي إخلاصه لله ؛على نهج رسول الله لذا لم يقتصر هذا الاهتمام والحرص على زمن الرسول فحسب،بل استمر الحال إلى الأزمنة والأجيال التالية فقد أخرج الحاكم في مستدركه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: ( لما قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت لرجل هلمَّ فلنتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كثير،فقال :العجب والله لك يابن عباس ، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فركبت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوسد ردائي على باب داره، تسفي الرياح عليَّ وجهي حتى يخرج إليَّ فإذا رآني قال:يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لك ؟ قلت :حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك . فيقول : هلاَّ أرسلت إليّ فآتِيَك؟ فأقول : أنا كنت أحق أن آتيك، وكان ذلك الرجل يراني فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احتاج الناس إليَّ . فيقول : أنت أعلم مني مجمع الزوائد للهيثمي حديث رقم 9/280 خلاصة الدرجة : رجاله رجال الصحيح (الدرر السنية) * قال ابن عبد البر وغيره:"الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح" أ.هـ كتاب: القول المبين في أخطاء المصلين . وهكذا كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم في حفظ السنة ونقلها، جيلاً بعد جيل رواية وحفظاً وعملاً فتأدبوا حتى وإن اختلفت مذاهبهم وأفهامهم للسنة ا.هـ *نقل الحافظ الذهبي في سِيَر أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي، عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري،أحد أصحاب الإمام الشافعي، أنه قال : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرتُه يومًا في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال أيا أبا موسى :ألا يستقيم أن نكون إخوانًا، وإن لم نتفق في مسألة . قال الذهبي : هذا يدلُّ على فقه الإمام وفقه نفسه، فمازال النظراء يختلفون. * وفي سِيَر أعلام النبلاء أيضًا في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : قال أحمد بن حفص السعدي : سمعت أحمد بن حنبل الإمام يقول :لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. *وروى الحافظ المؤرخ الإمام أبو عمر بن عبد البر في"جامع بيان العلم وفضله" في باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة : - عن محمد بن عتاب بن المربع قال :سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري، أخبرني قال : كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبًا على دابة قال : فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء. وكان أحمد يرى الشهادة، وعلي يأبى ويدفع،فلما أراد عليُّ الانصراف، قام أحمد فأخذ بركابه. فتأدبوا حتى وإن اختلفت مذاهبهم وأفهامهم للسنة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم * * "* * ** إن التشبه بالكرام فلاح عن عبدِ اللهِ قالَ " لعنَ اللهُ الواشمَاتِ والمُتَوشِّماتِ ، والمُتَنَمِّصَات والمُتَفَلِّجَاتِ للحسْنِ ، المُغِّيراتِ خلقَ اللهِ" . فبلغَ ذلكَ امرأةً من بني أسدٍ يُقالُ لها أمُّ يعقوبَ ، فجاءَت فقالتْ : إنَّهُ بلغَني أنكَ لعَنْتَ كيْتَ وكيْتَ ، فقالَ : وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومَنْ هوَ في كتابِ اللهِ ، فقالت : لقدْ قرأتُ ما بينَ اللوحينِ ، فمَا وجدْتُ فيهِ ما تقولُ ، قالَ : لئن كنتِ قرَأتِيهِ لقد وجَدْتِيهِ ، أما قرأتِ " مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " . قالتْ : بلى ، قالَ : فإنَّهُ قدْ نهَى عنهُ ، قالت : فإنِّي أرَى أهْلَكَ يفعَلونَهُ ، قالَ : فاذْهَبي فانْظُرِي ، فَذَهَبتْ فَنَظَرتْ ، فلمْ تَرَ من حاجَتِها شيئًا ، فقالَ : لو كانَتْ كذَلِك مَا جَامَعَتْنا . الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4886-خلاصة حكم المحدث: [صحيح] هنا ما رواه البخاري وغيره عن ابن شهاب سالم قال " كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحـج ، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس ، فصاح عند سرادق الحجاج ، فخرج وعليه ملحفة معصفرة ، فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت تريد السنة ، فقال : هـذه الساعة ؟ قال : نعم ، قال : فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج ، فنزل حتى خرج الحجاج ، فسار بيني وبين أبي ، فقلت -القائل هو سالم - فجعل ينظر إلى عبد الله ، فلما رأى ذلك عبد الله ، قال : صدق " رواه البخاري في صحيحه -كتاب الحج- باب التهجير بالرواح يوم عرفة 3 \ 511 برقم 1660 . *أنه تزوَّج ابنةً لأبي إهابِ بنِ عُزَيزٍ، فأتَتْه امرأةٌ فقالتْ : إني قد أرضَعتُ عُقبَةَ والتي تزوَّج، فقال لها عُقبَةُ : ما أعلَمُ أنكِ أرضَعتِني، ولا أخبَرتِني، فركِب إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ فسأَله، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : "كيف وقد قِيل" . ففارَقها عُقبَةُ، ونكَحَتْ زوجًا غيرَه . الراوي: عقبة بن الحارث المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 88-خلاصة حكم المحدث: صحيح. هنا |
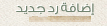 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 01:15 PM





 العرض المتطور
العرض المتطور
