|
|
|
#1
|
||||
|
||||

من آية 180 إلى آية 187 ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء مصير الذين يبخلون بنعم الله ، فلا يؤدون حقها . ولا يقومون بشكرها .وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"180. قوله : بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ:إشعار بسوء صنيعهم ، وخبث نفوسهم ، حيث بخلوا بشىء ليس وليد عملهم واجتهادهم ، وإنما هذا الشىء منحه الله - تعالى - لهم بفضله وجوده ، فكان الأولى لهم أن يشكروه على ما أعطى ، وأن يبذلوا مما أعطاهم في سبيله . أَيْ: لا تظنَّنَّ- يا مُحمَّدُ- ولا يظنَّنَّ هؤلاء الذين يشِحُّون بأموالهم التي رزَقهم الله تعالى؛ كرَمًا منه عن أداء حقِّه فيها، أَنَّ بُخلَهم هذا خيْرٌ لهم من العطاء الذي يُنقص المال كما يبدو في الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم" ما نقصت صدقة من مال ومازاد الله رجلا بعفو إلا عِزًا ، أو ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله"صحيح سنن الترمذي. بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ: أَيْ: ليس الأمرُ كما يَظنُّون؛ فامتناعُهم عن أداءِ حَقِّ الله تعالى فيما رزَقَهم من أموالٍ بُخْلًا منهم، هو في حقيقةِ الأمْرِ شرٌّ من هذا النقْصِ الذي يَبدو لهم، ومضرَّةٌ عليهم في دِينهم ودُنياهم. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْ: سيَجعل اللهُ تعالى المالَ الذي بَخِل به مَن منَعَ حقَّ اللهِ تعالى فيه، سيجعلُه طَوْقًا يُحيطُ بعُنُقِ صاحبه، ويُعذَّب به يوم القيامة. عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال"مَن آتاه الله مالًا فَلم يُؤدِّ زَكاتَه، مُثِّلَ له مالُه شُجاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ- يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ "ثمَّ تلا هذه الآية: وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...إلى آخِرِ الآية" رواه البخاريُّ :4565. وقال الله عزَّ وجلَّ"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ "التوبة: 34-35. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ:والمعنى : أن لله - تعالى - وحده لا لأحد غيره ما في السموات والأرض فما بال هؤلاء القوم يبخلون عليه بما يملكه ، ولا ينفقونه فى سبيله ؛ فهو المالكُ ذو المَلَكوت، والحيُّ الباقي الَّذي لا يموتُ؛ فأنفِقوا في حياتِكم مِمَّا جعلَكم اللهُ عزَّ وجلَّ مُستَخلَفين فيه، وقدِّموا فيها من أموالِكم ما يَنفعُكُم يومَ تأتون إلى الله سُبحانَه، وليس معكم شيءٌ مِمَّا كنتُم تملكون. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: أَيْ: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ مُطَّلِعٌ على خفايا أعمال الخلْق ومُطَّلِعٌ على نيَّاتهم وضمائرهم، وسيجازيهم على أعمالهم ونيَّاتهم بحسْبها، ومن ذلك: هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى من فَضْلِه؛ فإنَّ الله سبحانَه مُطَّلِعٌ على ما يُخفونَ ويَكنِزون، ويعلمُ إنْ كانوا قد أدَّوا حقَّ الله تعالى فيه أمْ لا، وإِنْ خَفِيَ ذلك على غيرِه. "لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" 181. الآية تثبت صفة السمع لله تعالى ، واسم الله السميع ثابت لقوله تعال" َليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" الشورى: 11. معنى الاسم في حق الله تعالى: قال الخطابي رحمه الله "السميع: هو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت، والنطق والسكوت"، والسماع قد يكون بمعنى القبول والإجابة.. فمن معاني السميع: المُستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعومن دعاء لا يُسمع.." صحيح الجامع:1297. أي: من دعاء لا يُستجاب رابط المادةg3p قالَ أبو بَكْرٍ لفِنْحاصَ -وكانَ مِن عُلَماءِ اليَهودِ وأحْبارِهم: اتَّقِ اللهِ وأَسلِمْ، فوَاللهِ إنَّك لتَعلَمُ أنَّ مُحمَّدًا رَسولٌ مِن عِنْدِ اللهِ، قد جاءَكم بالحَقِّ مِن عِنْدِه تَجِدونَه مَكْتوبًا عِنْدَكم في التَّوْراةِ والإنْجيلِ، قالَ فِنْحاصُ: واللهِ يا أبا بَكْرٍ ما سَأَلْنا اللهَ مِن فَقْرٍ وإنَّه لإلَيْنا فَقيرٌ، وما نَتَضَرَّعُ إليه كما يَتَضَرَّعُ إلينا، وإنَّا لأَغْنياءُ، ولو كانَ عنَّا غَنِيًّا ما اسْتَقْرَضْنا أمْوالَنا كما يَزعُمُ صاحِبُكم! يَنْهانا عن الرِّبا ويُعْطيناه، ولو كانَ غَنِيًّا عنَّا ما أَعْطانا الرِّبا ، فغَضِبَ أبو بَكْرٍ فضَرَبَ وَجْهَ فِنْحاصَ، فأَخبَرَ فِنْحاصُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأبي بَكْرٍ: ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ بفِنْحاصَ؟ فأَخبَرَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما قالَ، فقامَ فجَحَدَ فِنْحاصُ، وقالَ: ما قُلْتُ لك، فأَنزَلَ اللهُ"لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" إلى قَوْلِه"عَذَابَ الْحَرِيقِ"، نَزَلَتْ في أبي بَكْرٍ وما فَعَلَه في ذلك مِن غَضَبِه". الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الضياء المقدسي - المصدر : الأحاديث المختارة-الصفحة أو الرقم : 12 / 256 - خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال :هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم. حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ،وقال أحمد شاكر أن إسناده جيد أوصحيح. والمعنى : لقد سمع الله - تعالى - قول أولئك اليهود الذين نطقوا بالزور والفحش فزعموا أن الله - تعالى - فقير وهم أغنياء، وهو تطاول على ذات الله ، وكذب عليه ، ووصف له بما لا يليق به - سبحانه . وهذا السمع لازمه العلم والإحاطة بما يقولون من قبائح ، ثم محاسبتهم على ما تفوهوا به من أقوال ، وما ارتكبوه من أعمال ، ومعاقبتهم على جرائمهم بالعقاب المهين الذين يستحقونه . هذا قولهم في الله ، وهذه معاملتهم لرسل الله ، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. وقوله"سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأنبياء بِغَيْرِ حَقٍّ"أي سنسجل عليهم فى صحائف أعمالهم قولهم هذا، أي نأمر الحفظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها ; حتى يكون أوكد للحجة عليهم ، كما سنسجل عليهم قتلهم أنبياء الله بغير حق. .وقتل الأنبياء دوما بغير حق ولكن سيقت هذه العبارة كقيدٍ كاشفٍ وليس قيدًا احترازيًا. وقد قرن - سبحانه - قولهم المنكر هذا ، بفعل شنيع من أفعال أسلافهم ، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق؛ وذلك لإثبات أصالتهم فى الشر ، وإستهانتهم بالحقوق الدينية ، وللتنبيه على أن قولهم هذا ليس أول جريمة ارتكبوها ، ومعصية استباحوها ، فقد سبق لأسلافهم أن قتلوا الأنبياء بغير حق ، وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد ، وهو التجرؤ على الله - تعالى ،وبهذا كله يكونون قد عتوا عتوًا كبيرًا ، وضلوا ضلالا بعيدا . وأضاف - سبحانه - القتل إلى المعاصرين للعهد النبوي من اليهود ، مع أنه حدث من اسلافهم؛ لأن هؤلاء المعاصرين كانوا راضين بفعل أسلافهم ولم ينكروه وإن لم يكونوا قد باشروه ، ومن رضى بجريمة قد فعلها غيره فكأنما قد فعلها هو . وفى الحديث الشريف " إذا عُمِلت الخطيئةُ في الأرضِ كان من شهِدها فكرِهها – وقال مرَّةً : أنكرها – كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضِيها، كان كمن شهِدها"الراوي : العرس بن عميرة الكندي -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم:4345 - خلاصة حكم المحدث : حسن.كانَ مَن شَهِدَها"، أي: كانَ الذي حضَرَها وفُعِلَت أمامَه، أو عَلِمَ بها "فكَرِهَهاوقالَ مرَّةً: أنكرَها"، أي: أنكرَها بيدِه ولِسانِه، أو أنَّه كرِهَها بقَلبِه ولم يرضَ بها، "كمَنْ غابَ عَنها"، أي: كانَ مِن جَزائهِ أنَّه يكونُ في حُكمِ مَن لم يحضُرْها فلَم يقعْ علَيهِ إثمٌ. "ومَن غابَ عَنها فرَضِيَها"، أي: ومَن لم يَقعْ أمامَه مُنكَرٌ أو مَعصيةٌ، ولكنَّه سمِعَ بها ثم أَعجَبتْه ولم يُنكِرْها بقَلبِه. "كانَ كمَنْ شَهِدَها"، أي: كانَ مِن جَزائِه أن يقعَ عليهِ إثمُ مَن شَهِدَ المنكرَ ورَضِيَه ولم يُغيِّرْه معَ قُدرتِه على ذلكَ لأن سكوته عن النكر بمثابة إقرا لهذا القول القبيح . ووصف - سبحانه - قتلهم الأنبياء بأنه"بِغَيْرِ حَقٍّ"مع أن هذا الإجرام لا يكون بحق أبدًا ، للإشارة إلى شناعة أفعالهم ، وضخامة شرورهم ، وأنهم لخبث نفوسهم ، وقسوة قلوبهم لا يبالون أكان فعلهم في موضعه أم في غير موضعه . وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ :أي : سنجازيهم بما فعلوا ، ونلقي بهم في جهنم ، مخاطبين إياهم بقولنا : ذوقوا عذاب تلك النار المحرقة التي كنتم بها تكذبون . والذوق حقيقته إدراك المطعومات ، والأصل فيه أن يكون فى أمر مرغوب في ذوقه وطلبه ، والتعبير به هنا عن ذوق العذاب هو لون من التهكم عليهم ، والاستهزاء بهم كما فى قوله - تعالى– "فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"الانشقاق: 24."إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا""النساء: 56. ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ.نسأل الله العافية . ثم صرح - سبحانه - بأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بوقوعهم فى العذاب المحرق فقال : "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ" 182.ذَلِكَ: إشارة إلى عذاب الحريق. والحق سبحانه لم يظلمهم، لكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. "بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ" والمراد بالأيدي الأنفس، والتعبير بالأيدي عن الأنفس من قبيل التعبير بالجزء عن الكل. وخصت الأيدي بالذكر، للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته، ولأن أكثر الأفعال يكون عن طريق البطش بالأيدي، ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الالتصاق به والاتصال بذاته. فاليد هي الجارحة التي نفعل بها أكثر أمورنا، وعلى ذلك يكون قول الحق"بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ"مقصود به: بما قدمتم بأي جارحة من الجوارح. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ: فالله لا يظلم كافرًا، ولا يظلم مؤمنًا، بل يجازي كل إنسان بعمله . نفى سبحانه عن نفسه صفة الظلم مع ملاحظة أن الصفات المنفيةعن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد، فإذا نفى أن يكون ظلامًا للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ولا نوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد فصفات النفي تتضمن كمال الضد، وهذه قاعدة " لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال"والدليل قوله تعالى" "وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " النحل: 60.والنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى أي:الوصف الأعلى والأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفًا أعلى. "الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"183. بِقُرْبَانٍ:والقربان هو ما يتقرب به إلى الله من نعم أو غير ذلك من القربات. يقول تعالى تكذيبًا أيضًا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أنه يتصدق بصدقة فيتقبلها الله منه وعلامة قبولها نزول نار من السماء تأكل هذه الصدقة. وأن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه تنزل نار من السماء تأكلها . قاله ابن عباس والحسن وغيرهما . وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أُحلت الغنائمُ لأمةِ محمد صلى الله عليه وسلم. فجمعوا بين الكذب على الله، وحصر آيات الرسل بما قالوه، من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم -في ذلك- مطيعون لربهم بزعمهم الباطل ، ملتزمون عهده، وقد عُلِمَ أنَّ كلَّ رسولٍ يرسلُه اللهُ، يؤيده من الآيات والبراهين ، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه، وباطلا لم يعملوا به، والمعنى: أن عذابنا الأليم سيصيب أولئك اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا إن الله أمرنا في التوراة وأوصانا بأن لا نصدق ونعترف لرسول يدَّعي الرسالة إلينا من قِبَلِ الله-تبارك وتعالى- حتى يأتينا بقربان يتقرب به إلى الله، فتنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم ردًا على زعمهم الباطل "قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ: أي جاءكم الرسل من قبلي بالدالات وبالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ:أي جاؤوا أيضًا بالذي ذكرتم من القُربان الذي تحرقه نار من السماء، فلِمَ كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون!؟. يعني زكريا ويحيى ... ، وسائر من قُتلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم .أراد بذلك أسلافهم، وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء المتقدمين فلما أظهروا لهم هذا المعجزة سعوا في قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة. ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم. لذا الله تعالى سمى اليهود قتلة لرضاهم بفعل أسلافهم ، وإن كان بينهم نحو من سبعمائة سنة . "فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ "184. أَيْ: إنْ كَذَّبَك- يا مُحمَّدُ- سواء قريش أوأهل الكتاب أوكل من كذب الرسل ، فلا يُوهِنك ولا يَحزُنك ذلك ولا تبتئس ، ولك أُسْوَة بمَن قبلَك؛ فأنتَ لستَ بأوَّلِ مَن يُكذَّب، بل كُذِّب عددٌ من الرُّسُل عليهم السَّلام مع أنَّهم أتَوا أقوامَهمبِالْبَيِّنَاتِ :والبينات هي: الحُجَج القاطِعة والمعجِزات الباهِرة السَّاطعة.وَالزُّبُرِ: جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر.وَالْكِتَابِ: بمعنى المكتوب. الْمُنِيرِ: بمعنى المنير للظلمات. المضيئةِ لطريق الحقِّ بذكْرِ الأحكامِ العادِلة والأخبارِ الصَّادِقة. وهذا العطف الذي في قوله" وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ"هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى؛ لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير. فالتغاير تغاير صفة وليس تغاير ذات. الكتب السابقة ككتابنا كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبق من الكتب، فكل الكتب التي سبقت منسوخة به. فالمعنى الإجمالي: لا تحزن فقد كُذِّب رسل من قبلك جاؤوا بمثل ما جئت به من باهر المعجزات و هَزُّوا القلوب بالزواجر و العظات و أناروا بالكتاب سبيل النجاة فلم يُغْنِ ذلك عنهم شيئا فصبروا على ما نالهم من أذى و ما نالهم من سخرية و استهزاء. و في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لأن طباع البشر في كل الأزمنة سواء فمنهم من يتقبل الحق و يُقْبِل عليه بصدر رحب و نفس مطمئنة و منهم من يقاوم الحق و الداعي إليه و يسفه أحلام معتنقيه. من فوائد الآية الكريمة:تسليةُ الرسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام، ويتفرَّع عليها أنْ يَتسلَّى الإنسان ويهون عليه في كلِّ ما أصاب غيرَه. "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ "185. بعد أن سلَّى نبيه فيما سلف عن تكذيب قومه له بأن كثيرََا من الرسل قبلك قد كُذِّبوا كما كُذِّبت و لاقَوْا من أقوامهم من الشدائد مثل ما لاقيت بل أشد مما لاقيت فقد قَتلوا كثيرا منهم كيحيى و زكرياء عليهما السلام- زاده هنا تسلية و تعزية أخرى فأبان أن كل ما تراه من عنادهم فهو مُنته إلى غاية و كل آت قريب فلا تضجر و لا تحزن على ما ترى منهم فإنَّ مصيرَهم ومصيرَ غيرِهم إليه سبحانه ، وعُبر عن حدوث الموت لكل نفس بذوقه ، للإشارة إلى أنه عند ذوق المذاق إما مُرًّا لما يستتبعه من عذاب ، وإما حلوًا هنيئا بسبب ما يكون بعده من أجر وثواب . أن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قالَ"إنَّ المَيِّتَ تَحضُرُه المَلائِكةُ، فإذا كانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قالوا: اخْرُجي أيَّتُها النَّفْسُ الطَّيِّبةُ كانَتْ في الجَسَدِ الطَّيِّبِ، واخْرُجي حَميدةً، وأَبْشِري برَوْحٍ ورَيْحانٍ، ورَبٍّ غَيْرِ غَضْبانَ، فلا يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تَخرُجَ، ثُمَّ يُعرَجُ بِها إلى السَّماءِ، فيُسْتَفتَحُ له، فيُقالُ: مَن هذا؟ فيُقالُ: فُلانٌ، فيُقالُ: مَرْحبًا بالنَّفْسِ الطَّيِّبةِ كانَت في الجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلي حَميدةً، وأَبشِري، ويُقالُ: برَوْحٍ ورَيْحانٍ، ورَبٍّ غَيْرِ غَضْبانَ، فلا يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى يُنْتَهى بها إلى السَّماءِ الَّتي فيها اللهُ عَزَّ وجَلَّ، فإذا كانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قالوا: اخْرُجي أيَّتُها النَّفْسُ الخَبيثةُ كانَت في الجَسَدِ الخَبيثِ ، اخْرُجي مِنه ذَميمةً، وأَبشِري بحَميمٍ وغَسَّاقٍ ، وآخَرَ مِن شَكْلِه أزْواجٍ، فما يَزالُ يُقالُ لها ذلك حتَّى تَخرُجَ، ثُمَّ يُعرَجُ بها إلى السَّماءِ، فيُسْتَفتَحُ لها، فيُقالُ: مَن هذا؟ فيُقالُ: فُلانٌ، فيُقالُ: لا مَرْحبًا بالنَّفْسِ الخَبيثةِ كانَت في الجَسَدِ الخَبيثِ ، ارْجِعي ذَميمةً؛ فإنَّه لا يُفتَحُ لكِ أبْوابُ السَّماءِ، فتُرسَلُ مِن السَّماءِ، ثُمَّ تَصيرُ إلى القَبْرِ، فيَجلِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فيُقالُ له ويَرُدُّ "الراوي : أبو هريرة- المحدث : الوادعي- المصدر : الصحيح المسند-الصفحة أو الرقم- 2/342خلاصة حكم المحدث : صحيح. فالموت حتم على جميعِهم و أنهم سيجازون على أعمالهم في دار الجزاء كما تجازى و حسبُك ما تصيب من حسن الجزاء و حسبهم ما أصيبوا به و ما يصابون به من سوء الجزاء في الدنيا و سيوفون الجزاء كاملا يوم القيامة. فهذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها، وتخدع بغرورها، وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة، ومنتقل عنها إلى دار القرار، التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار، من خير وشر. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يعني:توفون أجور أعمالكم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشر، والتوفية تقتضي أن هناك شيئًا سابقا يزاد، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله، ولاسيما الإحسان إلى الخلق، وقضاء حوائجهم؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ. "الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم- المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم : 2699 . فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ: وجمع - سبحانه - بين زُحْزِحَ عَنِ النار وَأُدْخِلَ الجنة مع أن في الثاني غُنية عن الأول ، للإشعار بأن دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين وهما : النجاة من النار "زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ" ، والتلذذ بنعيم الجنة " وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ" . قال صلى الله عليه وسلم "إنَّ موضعَ سوطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شئتُم"فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغُرُور"الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الترغيب- الصفحة أو الرقم - 3767خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح. إنَّ موضعَ سوطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها :ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دانية، من الدنو وهو الانحطاط.تفسير العثيمين. أي: إنَّ مَن رأى هولَ القِيامةِ والحِسابِ والصِّراطِ والموقفِ بين يَديِ اللهِ وغيرِ ذلك من أهوالِ الموقِفِ، ثمَّ يُنَجِّيه اللهُ من ذلك كلِّه، ومن عَذابِ النَّارِ، ويُدْخِلُه الجنَّةَ؛ ويُفوزُ فِيها وَلْو بِموضِعِ قَدمٍ، أو مَوْضِعِ سَوطٍ، يعلَمُ عندَ ذلك أنَّ نَعيمَ الدُّنيا وزِينتَها كان غُرورًا، ولا قِيمةَ له، ولأنَّ زِينةَ الحياةِ الدُّنيا إنْ فَتَنتْ أحدًا ورَكَنَ إليها، ورأى أنَّه لا شَيءَ غيرُها، أو تعجَّلَها؛ فقدِ اغتَرَّ بترْكِ الأعْلى إلى الأدنى، واستبدَلَ الباقِيَ بالفاني.الدرر السنية. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ : يعني منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة ثم تزول ولا تبقى .تصغيرا لشأن الدنيا ، وتحقيرًا لأمرِها ، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة . فالغرور إذن أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها ،الحياة الدنيا متاع غرور ممن غر بالتافه القليل عن العظيم الجليل..فالدنيا ليست إلا متاعًا من شأنه أن يغرّ الإنسانَ ويشغله عن تكميل نفسه بالمعارف والأخلاق التي ترقى بروحه إلى سعادة الآخرة. فينبغي له أن يحذر من الإسراف في الاشتغال بمتاعها عن نفسه وإنفاق الوقت فيما لا يفيد، إذ ليس للذاتها غاية تنتهَى إليها فلا يبلغ حاجة منها إلا طلب أخرى. " لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" 186. لَتُبْلَوُنَّ :والابتلاء: الاختبار، والله سبحانه أحيانًا يختبر بخير وأحيانًا يختبر بشر كما قال تعالى " وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً"الأنبياء:35. وكما قال تعالى عن سليمان "قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ" النمل: ٤٠. وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يُسَر به ويفرح به، فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوؤه ويحزنه فهذا وظيفته الصبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له."الراوي : صهيب بن سنان الرومي - صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم : 2999 . والمعنى : لتبلون - أيها المؤمنون - ولتختبرن في أَمْوَالِكُمْ بما يصيبها من الآفات ، وبما تطالبون به من إنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله ، ولتختبرن أيضًا فيأَنْفُسِكُمْ بسبب ما يصيبكم من جراح وآلام من قبل أعدائكم ، وبسبب ما تتعرضون له من حروب ومتاعب وشدائد ، وفضلا عن ذلك فإنكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وهم اليهود والنصارى وَمِنَ الذين أشركوا وهم كفار العرب ، لتسمعن من هؤلاء جميعًا أَذًى كَثِيرًا كالطعن فى دينكم ، والاستهزاء بعقيدتكم ، والسخرية من شريعتكم والاستخفاف بالتعاليم التي أتاكم بها نبيكم ، والتفنن فيما يضركم . وقد رتب - سبحانه - ما يصيب المؤمنين ترتيبًا تدريجيًا ، فابتدأ بأدنى ألوان البلاء وهو الإصابة في المال ، فإنها مع شدتها وقسوتها على الإنسان إلا أنها أهون من الإصابة في النفس لأنها أغلى من المال ، ثم ختم ألوان الابتلاء ببيان الدرجة العليا منه وهي التي تختص بالإصابة في الدين ، وقد عبر عنها بقوله: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أشركوا أَذًى كَثِيرًا. وإنما كانت الإصابة في الدين أعلى أنواع البلاء ، لأن المؤمن الصادق يهون عليه ماله ، وتهون عليه نفسه ، ولكنه لا يهون عليه دينه ، ويسهل عليه أن يتحمل الأذى في ماله ونفسه ولكن ليس من السهل عليه أن يؤذى في دينه ...ولقد كان أبو بكر الصديق مشهورًا بلينه ورفقه . ولكنه مع ذلك - لقوة إيمانه - لم يحتمل من " فنحاص " اليهودي أن يصف الخالق - عز وجل - بأنه فقير ، فما كان من الصديق إلا أن شجَّ وجه فنحاص عندما قال ذلك القول الباطل" ، فغَضِبَ أبو بَكْرٍ فضَرَبَ وَجْهَ فِنْحاصَ"حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ،وقال أحمد شاكر أن إسناده جيد أوصحيح. وقد جمع - سبحانه - بين أهل الكتاب وبين المشركين فى عداوتهم وإيذائهم للمؤمنين ، للإشعار بأن الكفر ملة واحدة ، وأن العالم بالكتاب والجاهل به يستويان فى معاداتهم للحق ، لأن العناد إذا استولى على القلوب زاد الجاهلين جهلًا وحمقًا ، وزاد العالمين حقدًا وحسدًا ثم أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى العلاج الذي يعين على التغلب على هذا البلاء فقال: وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمور : أي : وإن تصبروا على تلك الشدائد ، وتقابلوها بضبط النفس ، وقوة الاحتمال. والصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم: والصبر على ثلاثة أقسام:١ - صبر على طاعة الله، وهو أعلى الأقسام.٢ - صبر عن معصية الله، وهو دونه.٣ - وصبر على أقدار الله المؤلمة،وهو دون الإثنين الأوليين؛ لأن الإثنين الأوليين: صبر على شرع الله، والثالث صبر على قدر الله، والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر، ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن، ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور؛ لأن الصبر عن المحظور كف فقط، والصبر على المأمور فعل؛ فهو إيجاد وعمل، ففيه نوع من الكلفة بخلاف الصبر عن فعل المحظور، فإنه ليس إلا مجرد كف، على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة للنفس أشد من الصبر على فعل المأمور، فيسهل على بعض الناس مثلا أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا.صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، من الثالث، وصبره عما حرم عليه بالصوم من الثاني، ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر؛ لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل للصائم، ففيه -أي في الصيام- صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار.ومن الأمثلة: صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه في البئر من الثالث، وصبره عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبر عن المعصية، وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول.وَتَتَّقُواْ: أي وتتقوا الله في كل ما أمركم به ونهاكم عنه ، تنالوا رضاه - سبحانه - وتنجوا من كيد أعدائكم . والإشارة في قوله فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمورِ: أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة لأنها شاقة على النفس، والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكُمَّل من الخلق، قال تعالى " فَاصبِر كَما صَبَرَ أُولُو العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ " الأحقاف: 35. فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الأمورِ:تعود إلى المذكور ضمنًا من الصبر والتقوى ، أي فإن صبركم ابتغاء وجه الله وتقواكم هذا من عزم الأمور أي مِن الأمورِ التي تَحتاج إلى هِمَّة عالية، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية. من الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحد لما فيه من كمال المزية و الشرف. فالآية الكريمة استئناف مسوق لإيقاظ المؤمنين ، وتنبيههم إلى سنة من سنن الحياة ، وهي أن أهل الحق لا بد من أن يتعرضوا للابتلاء والامتحان ، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم على تحمل كل ذلك ، لأن ضعفاء العزيمة ليسوا أهلا للفوز . "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ"187. الميثاق : هو العهد الموثق المؤكد . ثم حكى - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل الكتاب ، فقد أخذ - سبحانه - العهد على الذين أوتو الكتاب بأمرين :أولهما : بيان ما في الكتاب من أحكام وأخبار . وثانيهما : عدم كتمان كل شىء مما فى هذا الكتاب . والمعنى : واذكر أيها المخاطب وقت أن أخذ اللهُ العهدَ المؤكدَ على أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن يبينوا جميع ما فى الكتاب من أحكام وأخبار وبشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وألا يكتموا شيئًا من ذلك ، لأن كتمانهم للحق سيؤدي إلى سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة . والضمير فى قوله "لَتُبَيِّنُنَّهُ " يعود إلى الكتاب المشتمل على الأخبار والشرائع والأحكام والبشارات الخاصة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل الضمير يعود إلى الميثاق ، ويكون المراد من العهد الذي وثقه الله عليهم هو تعاليمه وشرعه ونوره . وقوله وَلاَ تَكْتُمُونَهُعطف على " لَتُبَيِّنُنَّهُ" وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفيًا . وجمع - سبحانه - بين أمرهم المؤكد بالبيان وبين نهيهم عن الكتمان مبالغة فى إيجاب ما أمروا به حتى لا يقصروا في إظهار ما في الكتاب من حقائق وحتى لا يلجأوا إلى كتمان هذه الحقائق أو تحريفها . ولكن أهل الكتاب - ولا سيما العلماء منهم - نقضوا عهودهم مع الله - تعالى - ، وقد حكى - سبحانه - ذلك فى قوله: فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ . النبذ : الطرح والترك والإهمال . أي أن أهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهود الموثقة بأن يبينوا ما في الكتاب ولا يكتموا شيئا منه ، لم يكونوا أوفياء بعهودهم ، بل إنهم نبذوا ما عاهدهم الله عليه ، وطرحوه وراء ظهورهم باستهانة وعدم اعتداد . وأخذوا في مقابل هذا النبذ والطرح والإهمال شيئا حقيرًا من متاع الدنيا وحطامها ، فبئس الفعل فعلهم . والتعبير عنهم بقوله فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كناية عن استهانتهم بالمنبوذ ، وإعراضهم الشديد عنه بالكلية ، وإهمالهم له إهمالًا تامًا ، لأن من شأن الشىء المنبوذ أن يهمل ويترك ، كما أن من شأن الشىء الذي هو محل اهتمام أن يحرس ويجعل نصب العين . والضمير فى قولهفَنَبَذُوهُيعود على الميثاق باعتبار أنه موضع الحديث ابتداء .ويصح أن يعود إلى الكتاب ، لأن الميثاق هو الشرائع والأحكام ، والكتاب وعاؤها ، فنبذ الكتاب نبذ للعهد . واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً:والمراد " بالثمن القليل " أي: استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا، وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم؛ لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدًا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا: نكذب محمدًا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم، إذن ما هو المبيع، وما هو الثمن؟المبيع: العهد. والثمن: الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قليل . تفسير الشيح محمد صالح العثيمين. والثمن قليل مهما كثر زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، بل لابد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا بجانب ومقابل رضا الله – تعالى. قوله فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ:بئس كلمة ذم . أى بئس شراؤهم هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الأليم . وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، وجوب إظهار الحق ، وتحريم كتمانه .قال الشيخ العثيمين رحمه الله:يؤخذ منها - وجوب بيان العلم على أهل العلم فيبينوا العلم الذي آتاهم الله، ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال، قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال؛ لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين.ا.هـ. وعن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال "مَن سُئلَ عَن علمٍ علمَهُ، ثمَّ كتمَهُ، أُلجِمَ يومَ القِيامةِ بلِجامٍ مِن نارٍ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم : 2649 - خلاصة حكم المحدث : صحيح .
__________________
|
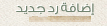 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 04:43 AM





 العرض المتطور
العرض المتطور
