|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
القاعدة الثانية من قواعد الصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء المتن ومن أمثلة ذلك:أن من صفات الله تعالى المجيء، والإتيان، والأخذ والإمساك، والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى: "وَجَاءَ رَبُّك"سورة الفجر، الآية: 22. وقال"هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ"سورة البقرة، الآية: 210. وقال"فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ"سورة آل عمران، الآية: 11. وقال "وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"سورة الحج، الآية: 65.. وقال"إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ"سورة البروج، الآية: 12وقال:"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"سورة البقرة، الآية: 185.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا". فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها،فلا نقول إن من أسمائه الجائي، والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، والنازل،ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. الشرح فنحنُ نصف الله تعالى بأنه ؛يأخذ؛ ويبطش؛ ويُريد ؛ويتكلم؛ ويُحي ؛ويأتي ؛ويمشي ، وماأشبه ذلك ، ولكننا لا نُسميه بهذا .لأننا كلما سميناهُ باسم؛ فإن ذلك يتضمن وصفه بما دل عليه الاسم من الصفة كما سبق ، فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اسمًا لله؛ وبما تضمنه من صفة ؛ وبما تضمنه من أثر وحُكم ؛إن كان مُتعدِيًا. ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
|
#2
|
||||
|
||||
|
المتن القاعدة الثالثة من قواعد صفات الله تعالى الشرح قال بعض الناس إن الأوْلى أن نُعبر بـ "ثبوتية ومنفية " لأن التي وصف اللهُ بها نفسه إما مثبتَة وإما منفية . ولكن الصواب أنه لافرق،لأن السلب والنفي معناهما واحدٌ، فإذا قُلت:فلانٌ لم يقم . فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام ، أي منفي عنه ،ولا إشكال في ذلك. المتن فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع: فمنه قوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا"سورة النساء، الآية: 136. فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم ؛رسوله ؛يتضمن:الإيمان بكل ما أخبر به عن مُرْسِلِه، وهو الله - عز وجل. وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثًا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتي حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل، أو الكذب، أو العِي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله - عز وجل - فوجب قبول خبره على ما أخبر به. الشرح أما دلالة العقل على ذلك : أن الله أخبر بهذه الصفات عن نفسه - لأننا لانثبت من الصفات إلا ما أخبر به اللهُ عن نفسه - وهو أعلمُ بنفسه من غيره ،ولهذا أيُّ إنسان يُحاول إنكار صفة من صفات الله نقول له:هل أخبرَ اللهُ بها عن نفسه؟ فإن قال:لا ، فقد كذَّب ، وإن قال:نعم . قلنا له :أأنتَ أعلم أم الله؟!إن قال:أنا أعلم ؛ فقد كفر وإن قال:اللهُ أعلمُ . قلنا: إذن يجب عليك أن تُؤمن بها، لأن اللهَ تعالى أعلمُ بنفسه وأصدقُ قيلا. فما أخبر اللهُ به عن نفسه فهو صدقٌ ؛ لأن كلامَ اللهِ أصدقُ الكلام وأحسنُ حديثًا من غيره.وحُسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة.فكلام الله-عزوجل- أحسنُ الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. فقد اجتمع في حق الله تعالى كمالُ الكمال من كل وجه ،من حيث العلم والصدق والبيان ، ولهذا يقول المؤلف:" فإن التردد في الخبر إنما يتأتي حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيّ"(ا.هـ) فالجهل ضده العلم، والكذب وضده الصدق ، والعيّ ضده البيان والفصاحة. فلوجاء رجلٌ نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه ، ويلمس صدره ، وجبهته ورأسه و ضغط عليها ؛ ثم قال : هذا المريض فيه الداء الفلاني . فإننا لانُصدقه؛ لأنه جاهل بهذه الصناعة، لكنه لوقال: هذا الخشب لايصلح أن نجعله أبوابًا ؛ لقبلنا قوله إذا كان صدوقًا. قد يكون كذوبًا قد يقول مايصلح أبوابا علشان يشتريه هوَّ ،على كل حال هذا الرجل الذي جاء يُشخص مرض هذا المريض وهو نجار لانقبله مهما كان في الصدق لأنه جاهل. ولو جاءنا رجلٌ طبيب جيد ماهر، وجعل وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء ، ثم قال: هذا يحتاج إلى علاج طويل يتكلف عليكم خمسين ألفًا، فلو كان هذا الطبيب - الرجل جيد في الصناعة وماهر في الطب لكنه -غير موثوق فيه من جهة الخبر ؛لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم ؛ لاإبراء المريض ولوجاءنا رجلٌ ثالث ، عالِم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه؛ لأننا عرب ، وشَخَّصَ المرض وأخبر به، لما فهمنا منه شيئًا ؛ وإذًا لن نثق بما قال ، لأن كلامه يفتقر إلى الفصاحة والبيان . وإذا تأملنا بعد ذلك - كلام الله-عزوجل-عن نفسه وعن غيره، لوجدناه كلامًا صادرًا عن علم لاشك ،وعن صدق ولاشك ، وفي أحسن مايكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولاشك أيضًا. فهل يبقى بعد هذا تردد في اعتقاد مايدل عليه كلام الله؟! والله لا يبقى تردد إطلاقًا في أن نعتقد مادل عليه هذاالكتاب العزيز . ولهذا نقول:إنما يتأتي التردد حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيّ، بحيث لا يُفصح بما يُريد.وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله فوجب قبول خبره على ما أخبر به.هذا دليل عقلي. المتن وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمُ الناسِ بربه وأصدقهم خبرًا وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانًا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. الشرح المتن الشرح وكذلك أيضًا قوله تعالى:"وما مسَّنا من لغوب" ق 35 – أى:من تعب وإعياء،فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقط ، بل يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته. وإلا لقلنا مثلاً أن العمود هذا عليه سقف يحمل السقف هذا كله هل يتعب؟ ماهو يتعب أبدًا ولاسمعنا يومًا من الأيام أنه صاح علينا يقول ياناس أتعبتموني. فإذن يجب أن نعتقد ياإخواني أن مانفاه الله عن نفسه لايكفي أن نعتقد مجرد انتفاء هذا المنفي ؛بل لابد أن نُضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. المتن الشرح المتن وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصًا، كما في قول الشاعر: قُبيِّلة لا يغدرون بذمة*ولا يظلمون الناس حبة خردل1 وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حَسَبٍ ليسوا من الشر في شيء وإنْ هانا الشرح يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانًا أي : إذا ظلمهم أحد قالوا :غفر الله لنا ولك ، وذلك حتى لايسيء إليهم إساءة أكبر ، وهؤلاء مذمومون ، ولهذا قال بعده : فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شَنُّوا الإغارة فرسانًا وركبانًا تمنى الشاعر أن يأتي الله بغير هؤلاء الذين يشنون الإغارة والخلاصة:أن الله تعالى لايُوصف بالنفي المحض لما يلي : أولاً: لأن النفي المحض عدمٌ محضٌ ،والعدم ليس بشيءٍ فضلا عن أن يكون كمالاً. ثانيًا: لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليتة له لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه، مثل قولنا: الجدار لايظلمُ. ثالثًا: أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفيُّ حينئذٍ نقصًا.فإذا قلتُ:هذا الرجل لايغدر بالعهد ،مدح ولاذم؟يحتمِل ؛ يحتمل لايغدر لكمال وفائه ؛وحينئذٍ يكون هذا مدحًا فيه . ويحتمل لا يغدر بالعهد لأنه مايقدر ،يخاف لو يغدر بالعهد هذه المرة كروا عليه مراتٍ ومراتٍ حتى أتلفوه لعجزه ،وهنا يكونُ هذا ذمًا فيه .والحاصل: أنه يجب علينا نحو صفاتِ اللهِ التي نفاها الله عن نفسهِ ؛أن نؤمن بانتفائها لا لمجرد الانتفاء؛ ولكن لإثبات كمال ضدها.وإذا كانت هذه الصفات منفية لثبوت كمال ضدها صارت صفة كمال. المتن فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. * مثال آخر: قوله تعالى"وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا "سورة الكهف، الآية: 49.نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. * مثال ثالث: قوله تعالى "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ"سورة فاطر، الآية: 44.. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: "إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا". لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. الشرح أكثر من كمال، العلم والقدرة. تمت القاعدة الثالثة
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
القاعدة الرابعة ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم. الشرح لأن هذا حاصلٌ، فكمالُ اللهِ تعالى حاصلٌ سواء علمناه أولم نعلمه، لكن كلما تعددت ظهرلنا من صفات كماله مالم يكن ظاهرًا من قبلُ. أما إذا قال:لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالتها ؛حصل الموصوف هناك مالم يحصل من قبل؛ صار هذا بالنسبة لصفات الله غير سديد . والصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية ،لأنها تدل على المدح.ولذلك لو أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت: أنتَ الكريمُ بلاشُحٍ، أنت الشُجاعُ بلاجُبنٍ ،أنتَ الجوادُ بلا قلة ،أنت القويُّ بلا ضعفٍ ، وماأشبه ذلك ؛ لكان هذا بالنسبةِ له محبوباً إليه ، أما لو قلت له :أنت لست بزبالٍ ،ولا كساح ، ولاكناسٍ ، ولاغسال ثياب ،ولا خدام ،ولا طباخ ، وماأشبه ذلك ،لكان هذا بالنسبةله مكروهًا ، يقول الملك ؟ يقول اضربوه. لأن صفات النفي هذه لاينبغي أن تُقال أبدًا مع العلم بأن أهل التعطيل يُركزون على صفات النفي،ولايقولون شيئًا عن صفات الإثبات ،لأنهم والعياذ بالله يعتقدون أن صفات الإثبات تقتضي التمثيل ؛وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل المتن الأولى: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" سورة الشورى، الآية: 11، "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ".سورة الإخلاص، الآية: 4. الشرح المتن الشرح المتن الشرح وإلى هذا جنح علماء الجيولوجيا ؛ حيث قالوا:بأن تكوين الأرض وتضاريسها والأفلاك؛ يحتاج إلى مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن ، وقدَّروا هذه المدة بستة آلاف سنة.وبعضهم أطال المدة فقال: ملايين الملايين من السنين . وقال آخرون: المراد بستة أيام ؛ستة ساعات أو أزمنة ، وهي كست لحظات؛ لأن الله يقول للشيء :"كُن فَيَكُونُ". وقال آخرون بل المراد ستة أيام كأيامنا هذه ، وقد خلقها الله-عزوجل-في هذه المدة ؛ ليُعلم عبادَهُ كيف يصنعون الأشياء بإتقان دون السرعة والصحيح أنها ستة أيام كأيامنا، وأما كونه عز وجل قدرها بهذا ،فهذا من الأمورالتي لا نستطيع إدراكها واللهُ أعلم. فليس لقائلٍ - مثلاً - أن يقول: جعل اللهُ أُذنَ الجملِ صغيرة ، وأذن الحماركبيرة ، مع أن الأنسب العكس، لكون الجمل أكبر حجمًا. ليس له أن يقول ذلك لأن مثل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يُعللها.فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله-عزوجل-سواء في الأمور الشرعيةأوالأمورالكونية. تمت القاعدة الرابعة القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة، ومنها الصفات الخبرية، كالوجه، واليدين، والعينين. * الشرح * قد يقول قائلٌ: هذا التقسيم لأهل العلم إنه لم يَرد به نصٌ ، فما بالنا نُقسم هذا التقسيم؟! وهذا إيرادٌ قوي جداً،ويجاب عنه بأن يُقال : لما وقع الخلاف من أهل الكلام بين مايثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه ؛ احتاج أهل السُنة المُتبعون للسلف أن يُقسِّموا هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط ومايرد فيه الخلاف وما لايرد.ثم هم يقولون:إذا كانت الصفة لازمة لاتنفك عن الله-عزوجل- فهي صفةٌ ذاتية.كالحياة,والعلم, والقدرة,والسمع,والبصر,والعِزة ، والحِكمة ؛وماأشبه ذلك ،فهذه كلها صفات ذاتية ، وسُميت بذلك للزومها للذات ، ثم قسموها إلى:معنوية وخبرية:فماكان نظيرُ مُسماه أبعاضًا لنا سموه: خبرية ، وماكان دالاً على معنىً سَمَّوْهُ :معنوية، فالسمع مثلاً صفة ذاتية معنوية ، واليد صفة ذاتية خبرية، لايقولون:" معنوية" لأنهم لو قالوا "معنوية" عادوا إلى تأويل الأشاعرة وشبيههم . والذي جعلهم لايقولون "بعضية" كما نقول : يدنا بعضٌ منا أو جزءٌ منا .قالوا:لأننا لايجوز لنا أن نُطلق كلمة "بعض" أو "جزء" على الله-عزوجل- فتحاشَوا هذا بقولهم : صفات ذاتية خبرية. لماذا قالوا خبرية؟ قالوا" خبرية" لأنها مُتلقاة ٌمن الخبر، فإن عقولنا لاتدلنا على أن لله تعالى يدًا بها يأخذ ويقبض ويبسُطُ، ما تدلُّنا على ذلك، لكن علمناها بمجرد الخبر ، لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة؛ قد دل عليها العقل ، لكن اليد والوجه والعين لم يدل عليها العقل. فالصفات الذاتية الخبرية جاءت عن طريق الخبر؛ وليس للعقل دخل في إثباتها أبدًا ، ولهذا لايمكن أن نقول إذا جاز إثبات الساق لله ؛ فلتجز الركبة مثلاً ،ليش. لأن العقل ليس له تدخل في هذا ولا يمكن أن نقول به. فيجب أن نقتصرفي هذه المسائل على ماجاء به الخبر ونُسميها خبرية؛ ولا نسميها "جزئية" أو"بعضية" لوجوب تحاشي هذا التعبيرفي جانب الله- عزوجل- . *المتن* والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا.وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى"إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"سورة يس، الآية: 82وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجزعن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق للحكمة ، كما يشير إليه قوله تعالى :"وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"سورة الإنسان، الآية: 30. * الشرح * القسم الثاني:"الكلام" عند أهل السُنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده ، وصفة ذاتية باعتبار أصله.فباعتبار أن الله لم يزل ولايزال مُتكلمًا، كما أنه لم يزل ولايزالُ خالِقاً ،فعَّالاً لما يُريدُ، بهذا الاعتباريكون صفةً ذاتية. وباعتبار آحاده ؛يكون صفة فعلية.فمثلاً إذا أراد الله أن يخلق شيئاً قال:"كُن فَيَكُون".فهنا إرادتان: إرادة سابقة وإرادة مقارنة. والقول إنما يكون بعد الإرادة المقارنة للفعل.فإذا أراد أن يكون الشيء قال له:"كُن"فبمجرد أن يقول كن ؛ فيكون على وفق ما أراد ؛ولهذا جاءت الفاء"فيكون".أما الإرادة السابقة بأنه سيفعل فهذه سابقة مايقع بعدها قول.لكن الإرادة المقارنة هي التي يقع بعدها القول.فالقول إذن بعد الإرادة.القول: "كن" بعد الإرادة وهذا يدل على حدوث هذه الكلمة ولا لأ؟ نعم يدل على حدوثها؛ وأنها صارت عند إرادة الفعل. كذلك القرآن الكريم فيه آيات واضحة تدل على أن اللهَ تكلم بها بعد وقوع الفعل بعد وقوع المتحدَّث عنه . "وإذ غدوتَ من أهلك تُبوئ المؤمنين مقاعد للقتال"إذ غدوت الغدو سابق على هذا القول ولا لاحق؟ سابق"وإذ غدوت تُبوئ". "قد سَمِعَ اللهُ قولَ التى تُجادلك في زوجها" فالمسموع سابق ولا لأ؟ سابق.إذن فهذاالقول صار بعده وعلى هذا فقِس. فكلام الله-عزوجل-باعتبارآحاده صفة فعلية؛ وباعتبار أصله وأنه صفة الله-عزوجل-لم يزل ولايزال مُتصفًا به :صفةٌ ذاتية: هذا هو تقسيم أهل السُنة والجماعة في تقسيم كلام الله. أما الأشاعرة والماتُريدية ومن على شاكلتهم ، والكُلاَّبية ونحوهم، قالوا:إن الكلام صفة ذاتية فقط ،لأنهم يجعلون الكلام هوالمعنى القائم بالنفس ، وأن هذا المسموع شيءٌ مخلوق.خلقه الله تعالى ليُعبرعما في نفسه؛ فكان على مذهبهم الكلام صفة ذاتية. ولكن ما ذكره السلف هو الحق المُطابق للمعنى اللَُّغوي والعقلي، وأن الله-عزوجل- يتكلم-سبحانه وتعالى- متى شاء وبما شاء وكيف شاء، فلهذا نقول:إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فإذا قالوا:كون الكلام صفة ذاتية وفعلية فهذا جمع بين الضدين؟ قلنا:مادامت الجهة مُنفكة فلا تناقض، فالسجود مثلا قد يكون شركا وقد يكون طاعة ،وذلك باعتبارين، فإن كان لله كان طاعة وإن كان لغير الله كان شركاً. انتهت القاعدة الخامسة ::::::::::::::::::::::::::::::::: تابع قواعد في صفات الله عز وجل القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف. فأماالتمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثلٌ لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع: فمنه قوله تعالى "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" سورة الشورى، الآية: 11. وقوله "أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ".سورة النحل، الآية: 17. وقوله "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا"سورة مريم، الآية: 65.. وقوله "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" سورة الإخلاص، الآية: 4. الشرح السمع المقصود به الكتاب والسنة ؛فقوله تعالى"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" سورة الشورى، الآية11– كلمة" شيء" هنا نكرة في سياق النفي ؛ فتعم كل شيء ،أيُّ ليس هناك شيءٍ أبدًا مُمَاثِلاً للهِ. وقد وقع في "الكاف" جدلٌ كبيرٌ بين العلماء ، لأن وجودها مع"مثل"مشكلة؛ إذ كلٌ منهما يدلُ على التشبيه أو التمثيل؛ فلو قلتَ"ليس مثل مِثلِهِ شيئًا"؛ معناه: أنك أثبتَ المثلَ ونفيتَ المُماثلة عن هذا المِثل، وهذا تناقض؛ لأنك إذا نفيت المماثلة عن المِثل لم تُثبت وجود المثل ، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. ولهذا اختلف العلماء في هذه الكاف . فمنهم مَنْ قال:إن الكاف زائدة ؛وتقدير الكلام:"ليس مثلهُ شيء" . .ومنهم مَنْ قال:إن "مِثل" هي الزائدة ، فتقدير الكلام هو:"ليس كهو شيءٌ"؛ فالزائد إحدى هاتين الكلمتين ،ولاشك أن القول بزيادة "الكاف" ؛أولى من القول بزيادة "المِثل"؛ لأن زيادة الحروف في اللغة العربية كثيرة، لكن زيادة الأسماء قليل جدًا؛ فضلاً عن كونه موجودًا أصلاً . ومنهم مَنْ قال:إن"مِثل"هنا بمعنى "ذات"؛ فتقدير الكلام ؛ ليس كذاته شيء . وهذا أيضًا ليس بصواب ؛ لأن المِثل لايُمكن أن يُقال أنه يُرادُ به الذات، فذاتُ الشيءِ ليست هو مثل الشيء. ومنهم مَنْ قال:إن المِثل بمعنى الصفة، وذلك كقوله تعالى"إنما مثلُ الحياةِ الدنيا كماءٍ أنزلناهُ" يونس24. أي صفتها وحالها ، وكما في قوله:"وله المثلُ الأعلى" الروم27- أي الوصف الأكمل. وقالوا:إن "المِثـْلَ" و"المَثـَلَ" يرجعان إلى معنى واحدٍ ، كـ"الشِّبْهِ" و"الشَّبَهِ"؛ فيكون المراد بـ"المِثْلِ" هنا على رأي هؤلاء؛الصفة ؛أي ليست كصفته شيءٌ، .فمِثْلُ بمعنى :مَثَل ، والمَثُلُ بمعنى الصفة. ومنهم مَنْ يقول:إن المِثل هنا على بابها ، فمعناها كما يتبادر إلى الذهن، و"الكاف" هنا زائدة للتوكيد، فهو نفس المعنى الأول ،.فإن العرب قد تُطلقمثل هذه العبارة وتريد ذاتَ الشيءِ، كما يقولون: "مِثلكَ لايُهزمُ" ؛ المراد : أنتَ لا تُهزم، لكن أضافوا ذلك إلى المِثل لأنه إذا كان مثلُك لايُهزم فأنتَ من باب أولى.فإذا كان مِثلُ اللهِ ليس له مِثل فالله تعالى من باب أولى. والذي يظهر لي : أن هذا من باب التوكيد، كأنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المماثلة.أما قوله تعالى"أفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ" النحل17. فالأمرُ فيها واضحٌ، فإنه يوبخهم ولذلك قال:"أفَلَا تَذَكَّرُونَ" يوبخهم. وذلك مثل قوله تعالى "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمًِّيا" مريم 65 . والسَّمي معناه الكُفء والنظير؛ والاستفهام للنفي. ومثاله أيضًا قوله تعالى"وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" سورة الإخلاص، الآية: 4.أيضًا ظاهر في نفي المكافأة. ::::::::::::::::::::::::::::::::: انتهى الشريط الثاني
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
الشريط الثالث
بداية الشريط الثالث ⬇ المتن وأما العقل فمن وجوه: الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبيانًا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابهًا فيصفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلاتنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. الشرح تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، بل إن المُقارنة بينهما تُوجب النقص كما قيل: ألم تر أن السيف ينقصُ قَدرُهُ.. إذا قيل إن السيفَ أمضى من العصا. أي لو قلت :" عندي سيف عظيم جدًا من أحسن السيوف ، وهو أمضى من العصا"، فلن يعد الناس قولك هذا شيئًا ، لأنه لامقارنة بينهما من الأصل. هذا ليس بشيءٍ لأن العصا ما يمضى إلا إذا ضربت به شيئًا لينًا يتفرط ، لكن لو ضربت به شيئًا لايتفرط ولو كان لينًا مامضى به لوتضرب كورة لينة هل يُمزقها؟ لايمزقها لكن السيف لو تضرب به خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. المتن الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات،لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن:"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ"الشورى11 الشرح الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين: أحدهما: أن هذا تعبير القرآن. الثاني: أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غيرُسديدٍ ، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيثُ الجملة ، فالوجود للخالق وللمخلوق اشتركا في أصل الوجود وإناختلفا في حقيقتة، فوجود الخالق واجبٌ لازمٌ,أزليٌّ,أبدِيٌّ ووجود المخلوق جائزٌ,ممكنٌ,قابلٌ للعدم كماهو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى؛ لكن هذا يختلف عن هذا،هذا من جهة ومن جهة ثانية: أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهًا. فإذا قلنا:"من غير تشبيهٍ " أوْهَمَ مَنْ لايدري أننا نُريد" من غير إثباتٍ" ؛ لأن بعض الناس يجعل كُلَّ مُثبَتٍ مُشَبِّهاً.فإذا قلنا:"من غيرتشبيهٍ" ظن الظان الذي لايدري عن معنى ما نُريد أن المراد:" من غير إثباتٍ الصفة " ؛لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثباتَ الصفاتِ تشبيهٌ، ولهذا يُسمَّوْن المُثبِتة :المشبِهة. فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفيالتشبيهلهذين الوجهين: الأول: موافقة القرآن.الثاني :أن نفي التشبيه على الإطلاق لايصلح إذ مامن شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراكٌ في أصل الشيء وهذا الاشتراك نوعٌ من التشابه لكنه ليس مماثلة.المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه؛ والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. المتن وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع: فمنه قوله تعالى: "وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا"طه 110 الشرح وإذا كنا لانُحيطُ به علمًا ؛ فكيف يُمكن أن نُكيِّف صفاته؟؛ لا يمكن أن نُكيِّف صفاته إلا إذا أحطنا به علمًا؛ وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. المتن وقوله: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً"الإسراء36. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكونُ تكييفُنا قفوًا لما ليس لنا به علم، وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له،أو بالخبر الصادق عنه،وكل هذه الطرقِ منتفية في كيفية صفات الله - عز وجل - فوجب بطلان تكييفها. الشرح هذه القاعدة مهمة جدًا ،وهي : أن الشيء لاتُعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: أولاً: العلم بكيفية ذاته. ثانيًا: العلم بنظيره المساوي له. ثالثًا:بإخبارالصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. فمثلا : إذا قلنا بأن لله سمعا ، فإننا لا نستطيع أن تُكيف هذا السمع؛ لأنك لاتستطيع أن تعرف كيفية ذات الله فكذلك كيفية سمعه. وليس لله تعالى نظير حتى تعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره،ولم يخبرنا الرسول- صلى الله عليه وسلم- بذلك بكيفية سماعه ، فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند مجرد إثباتها. مثال آخر : "ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" الفرقان 59 ؛ لايمكن أن نعرف كيفية الاستواء، لأننا لم نعرف كيفية ذات الله ، وليس هناك نظير استوى على شيء مثل العرش حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل ، ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية استوائه على العرش ، ولهذا قال بعض العلماء : إذا قال لك الجهمي كيف استوى الله على العرش ؟فقل له:إنَّ اللهَ أخبرنا أنه استوى على العرش ؛ ولم يخبرنا كيف استوى. وقال بعضهم :إذا قال لك كيف استوى؟ فقل له:كيف هوَ بذاته؟ فسيقول:لاأعرف كيفية ذاته.فقل له:إذن لانعرف كيفية صفاته؛ لأن الكلامَ في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات. المتن وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك، فالله أعظم وأجلُّ من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك. الشرح صحيح هذا إيرادٌ مُفحمٌ.نقول
أولاً: أيُّ كيفية تُقدرها لصفاتِ الله، فالله أعظمُ وأجلُّ مما قدرت . فمثلا أي كيفية تُقدرها لاستواء الله على العرش، فاستواء الله في حقيقته أعظم وأجل مما قدرت، فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواءً كاملاً استواءً كاملاً على أكمل مايكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيًا: أيُّ كيفية تُحددها في صفات الله فأنتَ كاذبٌ فيها قطعًا ؛ لأنه ليس عندك علمٌ بهذا إطلاقاً ، لأن الله تعالى ماأخبرنا عن كيفية تلك الصفات ، فأيُّ كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين. فمثلاً:"صفة ُالكلام"؛ فإنا نعلم أن الله-سبحانه وتعالى- يتكلم ونعلم المُتَكلَّمَ به ، ولكن كيف يتكلم الله؟ اللهُ أعلمُ.كيف صوته بالكلام؟اللهُ أعلمُ. مانعرف.الآن مثلا الطيورتنطق والإنسانُ ينطق؛هل النُطق سواءٌ؟ ماهو سواءٌ "عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ" النمل 16 .ماكل أحدٍ يعرف منطق الطير ،بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أدائه للحروف؟ أبدًا. وأعني بالعجم هنا مَنْ ليس بعربي وأما العجم معروفون فعجم فارس الآن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
المتن وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان، أو تقديرًا باللسان، أو تحريرًا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى:"الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى"طه 5كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرُّحَضَاء (العرق) ثم قال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". وروى عن شيخه ربيعة أيضًا: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول". وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاهُ الشيطانُ في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذُك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك، قال الله تعالى"وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"فصلت 36 الشرح هذا الكلام من مالكٍ-رحمه الله و شيخه ربيعة؛ ميزانٌ لجميع الصفات، فإذا قال قائلٌ مثلاً:إن اللهَ-سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فنقول: النزولُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُمعقول، والإيمانُ به واجبٌ ،والسؤالُ عنهُ بدعة. وإذا تأملنا قولَه:"الكيفُ غيرُ معقولٍ"فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم:إنه يدل على أنه نفيُ الكيفية كلها ،لأن نفي الكيفية كلها نفيٌ للوجود ، إذ ما مِن موجود إلا وله كيفية، وعلى هذا فيكون معنى كلام مالكٍ رحمه الله وغيرهِ من السلف في نفي الكيفية ؛ المراد به نفي التكييف لا أصل الكيفية. انتهت القاعدة السادسة من قواعد الصفات *القاعدة السابعة*من قواعد الصفات المتن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث""انظر القاعدة الخامسة في الأسماء". الشرح لما أحالنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؛لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية.المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية ، لأن الصفات كالأسماء توقيفية.وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك ، فلايجوز أن نُثبت لله إلا ماأثبته لنفسه منها. المتن ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول:التصريح بالصفة كالعزة، والقوة، والرحمة، والبطش، والوجه، واليدين ونحوِها. الشرح فالعزة كقوله تعالى :"فإنَّ العِزة َللهِ جميعًا". والقوة كقوله تعالى :"إنَّ اللهَ هو الرزاقُ ذو القوة". والرحمة كقوله تعالى :"وربُكُ الغفورُ ذو الرحمةِ". والبطش: كقوله تعالى :"إنَّ بطشَ ربِكَ لشديدٌ". والوجه: كقوله تعالى :"ويبقى وجهُ ربِكَ ذو الجلالِ والإكرام" واليدين: كقوله تعالى :"بل يداهُ مَبْسُوطتان".ونحو ذلك. المتن الثاني: تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك -انظر القاعدة الثالثة في الأسماء-. الشرح فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء : " إذا دلت على وصفٍ متعدٍّ تضمنت ثلاثة أمور". فقد أحالنا على ذلك ليُعْرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات. المتن الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها - على الترتيب - قوله تعالى: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى"سورة طه، الآية: 5.وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا". الحديث. وقول الله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".سورة الفجر، الآية: 22.وقوله: "إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ"سورة السجدة، الآية: 22. الشرح فمن صفات الله تعالى الاستواء على العرش ، إيش الدليل؛ الدليل الفعل "ويؤخذ هذا من قوله تعالى :"الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" سورة طه، الآية: 5 فنأخذ من "استوى" الاستواء. لو قال قائلٌ أنتَ قلتَ:إنَّ من صفات الله "النزولَ إلى السماء الدنيا"؛ فأتِ بنصٍ بهذا اللفظ"النزول إلى السماء الدنيا" إيش تقول؟ أقول:مافيه بهذا اللفظ لكن فيه فعل يدل على هذاالمعنى وهو"ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" "يتنزَّل ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماءِالدُّنيا، حين يبقى ثُلُثُ الليلِ الآخرِ ، فيقول : مَن يدعوني فأَستجيبَ له ، من يسألُني فأُعطِيَه ، من يستغفرُني فأغفرُ له" الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7494-خلاصة حكم المحدث:صحيح-الدرر السنية وكذلك "المجئ" من صفات الله تعالى ، ولكن ليس هناك نص فيه لفظ المجيء، بل النص موجود فيه الفعل الدال عليه ، وهو في قوله تعالى"وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً" سورة الفجر، الآية:22. الفعل بهذا اللفظ "وجاء ربُكَ" دالٌ على المجئ. أما قوله تعالى : "إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ"سورة السجدة، الآية:22.،لو قلنا إن من صفات الله تعالى الانتقام من المجرمين ؛ فليس هناك نص فيه كلمة "الانتقام"؛ ولكن نقول إن قوله:"مُنْتَقِمُونَ" وصفٌ دالٌ على الصفة التي تضمنها. إذًا فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة: الأول: التصريح بالصفة، وهذا واضح ؛ كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة مثل قوله تعالى :"وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ".الرعد1 الثاني:أنَّ ماتضمنه الاسم من الصفات كالغفور- مثلاً- متضمنٌ للمغفرة ،والسميعُ متضمنٌ للسمع، والبصيرُ متضمنٌ للبصر. وهكذا. الثالث: التصريح بفعل أو وصفٍ دالٍ عليها؛ مثل الاستواء. فلو قيل : أين الدليل الذي فيه كلمة "الاستواء"؟ قلنا : قوله تعالى :"ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" الرعد 2 ؛ فهذا فعل ، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء ، وكذلك نقول في النزول وفي المجيء. انتهى الفصل الثاني |
|
#6
|
||||
|
||||
|
الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات * القاعدة الأولى* الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. *الشرح* هذه القاعدة مهمة، وهي أن أسماءُ اللهِ وصفاتهِ لا تؤخذ إلا من الكتاب والسُنة.ولا تؤخذ من إجماع السلف؟ لأن إجماعٌ من السلف لايمكن أن يكون مبنيًا على غير الكتاب والسُنة أبدًا. وحينئذٍ فالمرجع هو الكتاب والسُنة ، لأن العلم بالأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، وليست هي أحكامًا يدخل فيها القياس حتى نقول ؛ربما يكون إجماعٌ عن قياس، ولكنها أمورٌ تُدرك بالخبر، وحينئذٍ لا يمكن أن يوجد إجماع؛ إلا مستندًِا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالمرجع إذًا في إثبات الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة .لكن أحيانًا لانطلع على دليل الكتاب والسنة ؛ لكن نطلع على الإجماع .فنقول إن الإجماع هنا لابد أن يكون مستندًا إلى الكتاب والسنة. *المتن* وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. *الشرح* القاعدة مفهومة. مادمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتابوالسُنة؛ فما وردإثباته وجب إثباته وماورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.فالظلم وردَ نفيه؛ فيُنفى عن الله الظلم مع إثبات كمال ضده وهو- كمال العدل. والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته. وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون لأنها مما أحدِث من علم الكلام. تنازع المُتأخرون فيها فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها ، والصواب أن نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لانثبته ولاننفيه؛ والمعنى نستفصل عنه ؛ هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالاً على نقصٍ؛ فيجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتَمِلاً فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. *المتن* فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، أو تضمن، أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها "وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"إبراهيم : 27. ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها. ومنه :الكلام، والمشيئة، والإرادة بقسميها: الكوني، والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. ومنه :الرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت، والنوم، والسِنَة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ "الجهة" فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتًا ولا نفيًا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علوعلو لا تحيط به. فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة، والعقل والفطرة، والإجماع. والثاني باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. *الشرح* فمما ورد فيه النزاع"الجهة". فهل اللهُ في جهة؟ الجواب: الجهات إما عُلوأو سُفل. والعُلو إما أن يُحيط بالله أولايُحيط به.فإن أردت بالجهة جهة السُفل –كما يقول من يقول:إن الله تعالى في كل مكان بذاته- ؛فهذا باطلٌ بلاشكٍ، لأنه مُخالفٌ لما ثبتَ من عُلوهِ الدال على كماله. وإن أردتَ أنه في جهةٍ تُحيط ُبه ؛جهةٍ عُليا لكن تُحيط ُبه؛-حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك - فهذا باطلٌ لأن اللهَ تعالى لا يُحيط ُبه شيءٌ من مخلوقاته. وإن أردت جهة عُلوٍ لا تُحيط ُبه بل هي عدمٌ ،مافوقه شيءٌ ولاعن يمينه ولاعن شماله شيءٌ.فكل ما هو فوق فهو عدم.يعني مافي شيءٌ من المخلوقات ،فهذه جهة عُلو لاتُحيط ُبه ، فهذا حقٌ ، لأن الله-سبحانه وتعالى-فوق كل شيء.لايحاذيه شيء من مخلوقاته أبدًا ؛فكل شيء هو تحته سبحانه .إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة يعني بدون أن يُحيط َبه شيءٌ من المخلوقات وهذا حقٌ . والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسُنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. *المتن* ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى"وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"الأنعام 155، وقوله: "فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" الأعراف 158، وقوله"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" الحشر 7، وقوله"مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا" النساء 80، وقوله: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" النساء 59، وقوله: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ" المائدة 49. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن ؛فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والردَّ إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسهِ في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى"وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ" النحل 89. ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. *الشرح* هذا كله يدل على أن ماجاء في السُنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواءً بسواءٍ.
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
*المتن* وأما العقل: فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. *الشرح* الآن لوقال قائلٌ:إنَّ اللهَ في جهة وقال آخرٌ:إن اللهَ ليس في جهةٍ إيش نقول؟ نقول:أما بالنسبة للفظ لانثبت ولاننفي لكن بالنسبة للمعنى نستفصل لماذا؟ لأن الذين نفَوا الجهة ادعَو أن أهل السُنة يُثبتون أن الله في جهةٍ تُحيط ُبه فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العُلو ولهذا نحتاج أن نستفصل.طيب لو قال قائلٌ:إن اللهَ ليس بجسم وقال آخر بل للهِ جسمٌ لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبضُ الصدقاتِ ويُربيها بكفه وما أشبه ذلك.فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم ؛نستفصل لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم وقالوا أجسامًا مُتماثلة فقالوا:إن الله لم يستو على العرش لأنك لو قلتَ استوى على العرش معناه صار جسمًا..لاينزل لأنك لو قلتَ ينزل صار جسمًا . ولايأتي للفصل بين العباد لأنه لو كان كذلك لكان جسماً وليس له يدٌ حقيقية وإلا لكان جسمًا إلى آخره، فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم:أين في الكتاب أوالسُنةِ نفي الجسم؟ لو أن أحدًا أثبته وقال:نعم أنا أقول له جسم . هات لي دليلاً يدل على أن الله ليس بجسم؟ هل يستطيع يأتي بدليل؟ مايستطيع لكن إذا قال لي هات دليل على أن اللهَ جسمٌ أنا ماعندي دليل.إذن لاتثبت أنَّ اللهَ جسمٌ ولاتنفي أن اللهَ جسمٌ ،ولكن نستفصل عن المعنى واثبت المعنى الحق وأنفِ المعنى الباطل أما اللفظ فدعه لاتقل الله ليس بجسم ولاتقول الله جسم.اترك هذا اللفظ هذا ماتكلم به الكتاب ولا السُنة ولا الصحابة.
فنقول:ماتُريد بمعنى الجسم؟ إن قال:أريدُ بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وماأشبه ذلك.فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيحٌ وإن أراد بنفي الجسم قال:أنا أنفي وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المُتصف بالصفات اللائقة به .قلنا:هذا ليس بصحيح يعني، نفيك إياه ليس بصحيح بل هو بهذا المعنى جسم يعني أنه ذاتٌ قائمٌ بنفسه مُتصفٌ بالصفات التي تليقُ به يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وماأشبه ذلك. إذًا لفظ الجسم إثباتًا على سبيل الإطلاق خطأ ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ والواجب التفصيل هذا في المعنى، أما في اللفظ فأنا لاأقول:إن اللهّ جسمٌ ؛ولاأقول : إن اللهَ ليس بجسم.ولهذا السفاريني-رحمه الله-صار عليه انتقادٌ في قوله: وليس ربنا بجوهر ولاجسم ولاعرضٍ تعالى ذوالعُلى هذا خطأ ؛ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي في قوله: ليسَ الإلهُ مُشْبِِهًا عبيدَه في الوصفِ معْ أسمائِه العديدة ؛وهذا بالحقيقةِ صحيحٌ لكن وليس ربنا بجوهر إيش يدريك؟ ولاجسم إيش يدريك؟ ولاعرض إيش يدريك؟ لاتنف اسكُت كما سكتَ اللهُ ورسوله.مافي القرآن جسم ولاليس بجسم ولاعند الصحابة.لكن هذه المسائل ولَّدها المتكلمون المُحْدَثون ليتوصلوا بها إلى معنىً باطلٍ ؛لكن يوهمون العامة ومن ليس عندهم علمٌ راسخٌ بأن هذا الذي قالوه هو الحق وأن هذا هوغاية ُالتنزيه لله-عزوجل-فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. الخلاصة:هذه القاعدة مهمة.أيُّ إنسان يُجادلك في نفي شيءٍ أوإثبات عن الله تقول له:هات الدليل؛ وإلا فاسكت لا تثبت ولاتنف والمعاني الحق ثابتة لله تعالى والمعاني الباطلة منفية عن الله . |
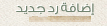 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 07:19 PM





 العرض المتطور
العرض المتطور
